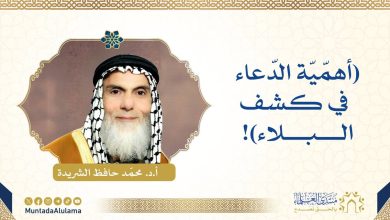ياسر الزعاترة يكتب: لا دمقرطة ولا حريات في خطاب الغرب حيالنا.. لماذا؟
كثيرة هي التصريحات والمواقف التي تخدم فكرة هذه السطور، ولكننا نتوقف مع واحد جديد، فقط كمدخل للحديث.
يوم الأحد الماضي، غرّد الرئيس الأميركي ترمب تعليقاً على افتتاح كاتدرائية في مصر، قيل إنها الأكبر في الشرق الأوسط، فكتب يقول: «متحمس لرؤية أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، الرئيس السيسي ينقل بلاده إلى مستقبل أكثر شمولية»، ولنلاحظ هنا أن بناء كاتدرائية هو ما استوقف ترمب في المشهد المصري برمته، بينما تجاهل عسكرة المجتمع، وما يزيد عن 60 ألف معتقل في السجون، بجانب عسكرة وسائل الإعلام، وهذا المثال ينطبق على كل سياسات ترمب، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في العالم أجمع، ألم يعبّر عن إعجابه بزعيم كوريا الشمالية الذي يعتقل شعباً بأكمله؟!
تقليدياً، ومنذ عقود طويلة، كانت قضية الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من التداول الغربي على ألسنة الزعماء والسياسيين في الغرب، فيما يتعلق بمنطقتنا.
صحيح أن الشق الأكبر من ذلك التداول كان ينطوي على نفاق ومجاملة للرأي العام الداخلي، مع قدر وافر من استخدامه في سياق الضغوط والابتزاز للمستهدفين بالنقد، إلا أن استمرار الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، كان يفضي إلى شيء من التحوّل -ولو في سياق الديكور- أعني صناعة ديمقراطيات تأخذ من الديمقراطية أشكالها الخارجية، دون مضمون حقيقي.
اليوم، يبدو لافتاً خروج هذه القضية من التداول الغربي، ربما باستثناء بعض البيانات والإحصاءات التي تصدر عن مؤسسات مستقلة أو شبه رسمية، فيما تذهب دعوات الكتّاب والصحافيين والناشطين في الغرب ضد السكوت على القمع هنا وهناك هباء منثوراً، وقصة جمال خاشقجي -رحمه الله- خير مثال.
اللافت بالطبع، أن يأتي ذلك بعد موجة الربيع العربي التي فاجأت الغرب، ويبدو أن الدرس الذي أخذوه من هذه الموجة يتمثل في الكفّ عن طرحها، حتى لا تستيقظ الشعوب من جديد على بؤس أحوالها.
لا شك أن الأوضاع التي كانت قائمة في العالم العربي، والتي تعود الآن على نحو أسوأ، هي الأنسب للدول الكبرى -وبالضرورة للحبيبة «إسرائيل»- التي تواطأت جميعاً على هذا البعد، ذلك أن استعادة الشارع الشعبي لقراره السياسي، سيؤثر بالضرورة على مصالح تلك الدول، فيما هي تستفيد جميعاً من الصراع الراهن في المنطقة، رغم ما بينها من تناقض، فروسيا والصين تستفيدان، تماماً كما تستفيد أميركا والغرب، وكلما زادت الصراعات البينية اشتعالاً ذهب المتصارعون إلى الخارج يطلبون الإسناد، ومعه الشرعية أيضاً.
والمعادلة التي يعرفها الجميع هي أنه كلما كان النظام -أي نظام- في حالة اشتباك مع الشارع، كان عليه أن يذهب إلى الخارج بحثاً عن الإسناد والشرعية، ويقدم التنازلات من مصالح شعبه، ومن مصالح أمته وقضاياها الكبرى أيضاً، ومن يراقب الوضع العربي الراهن عن كثب سيلمس هذه الحقيقة بكل وضوح.
خلاصة هذه المعادلة هي تواطؤ القوى الكبرى على مصالح الشعوب المستضعفة، وبحثها عن مصالحها عند الأنظمة الديكتاتورية، والعمل الدؤوب على الحيلولة دون أن تحصل تلك الشعوب على حريتها، لأن ذلك يعني البحث عن الاستقلالية، بعيداً عن الهيمنة الخارجية.
هل يعني ذلك أن حلم الربيع العربي قد انتهى إلى غير رجعة؟ كلا بكل تأكيد، فهو أصلاً لم يندلع بدعم غربي «الانقلاب عليه حظي بالدعم»، وإنما تبعاً لحاجة داخلية ماسّة، بل إن تبعية الأنظمة للخارج كانت جزءاً لا يتجزأ من الموقف الشعبي منها، ومن ضمن ذلك التهاون في نصرة قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
بوسع الثورة المضادة العربية أن تحتفل بانتصارها على ربيع الشعوب، ومعها القوى الكبرى بكل تأكيد، لكن الاعتقاد بأنه انتصار نهائي لا يعدو أن يكون نوعاً من الوهم، فالشعوب لن تكفّ عن مطاردة حريتها، وستكون هناك جولات أخرى، لا سيما أن الأوضاع تذهب في اتجاهات أسوأ مما كانت عليه قبل الربيع على كل صعيد، وليس على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان وحسب.
(المصدر: صحيفة الأمة الالكترونية)