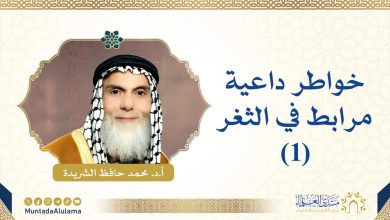ولي الأمر وصلاحياته ومشايخ السلطة
بقلم معتز الخطيب
شكل تأييد بعض المشايخ لحادثة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل مناسبة مهمة لنقد وتفكيك الحجج الفقهية التي استُند إليها لتسويق عملية التطبيع، ولبيان بعض أشكال توظيف الفقه لخدمة أجندات سياسية معينة. وقد قررت في مقالاتي الثلاثة الأخيرة على التوالي: (1) أن قرار الصلح والحرب والعلاقات الدولية هو قرار مصلحيّ في الفقه الإسلامي؛ لكن تطبيقات فكرة المصلحة الشرعية في سياق الدولة الحالية مسألة معقدة، ويكتنفها مشكلات عديدة، (2) وأن المصلحة باتت مدخلا للاستثمار السياسي من قبل مشايخ الأنظمة (وكذلك من قبل مشايخ الإسلام السياسي ولتفصيل هذا مكان آخر)، (3) وأن مشروع “تحقيق المناط” هدفه التأصيل للاستبداد لتقويض ثورات الربيع العربي، وهو الأداة الدينية للثورة المضادة.
أما هذا المقال الرابع فسأخصصه للحديث عن ولي الأمر وصلاحياته، وهي فكرة مركزية لدى الأنظمة الاستبدادية ومشايخ السلطة، وقد استخدمها الشيخ عبد الله بن بيه وغيره لتسويغ قرار التطبيع مع إسرائيل، كما استخدمها المفتون الرسميون وغيرهم مرات عديدة؛ لمجابهة الثورات العربية في دولها الخمس أو لتسويغ التحولات السياسية داخل البلد (كما حصل في السعودية مثلا).
ويمكن أن نميز هنا بين مسلكين في التنظير للاستبداد: المسلك الأول يلجأ إلى إسقاط التصورات الفقهية القديمة، التي تبلورت في ظل الخلافة على الدولة القطرية الحالية، فالرئيس هو نفسه الإمام الواجب السمع والطاعة، الذي يختص بالشأن السياسي كما يقرره الفقه القديم، وهنا يُقتبس من كتب الفقه ما يدعم هذه الفكرة لتطويع الناس وتعبيدهم للنظام الحاكم من جهة، واستدعاء أفكار وجوب طاعة الإمام وحرمة الخروج عليه، والفتنة، والصبر على ظلم الأمراء من جهة أخرى. وقد مارس هذا مشايخ عديدون كما أوضحت في دراستي: “الفقيه والدولة”.
أما المسلك الثاني فقد ابتكره بن بيه، ويحاول فيه أن ينظّر للاستبداد برطانة حديثة يزاوج فيها بين اقتباسات من الفقه القديم وشذرات من الأفكار الحديثة المُجتزأة منسوبة إلى أصحابها من المفكرين الغربيين، وهو مسلك ذو مضمون تقليدي وشكل حديث فقط.
الإمامة -كما عرفها الماوردي- “موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا”، وهذه الوظيفة الجامعة بين الديني والسياسي تكاد تكون محل اتفاق بينهم
إحدى المسائل المركزية التي يقوم عليها الفقه الإسلامي هي التفريق بين الحكم ومناطه كما أوضحت سابقا، وهو تفريق قد يأخذ صورة الفرق بين الحكم والفتوى، فالحكم عام مجرد عن حالة معينة ومعزول عن السياق الزماني والمكاني؛ لكنه حين يتنزل على حالات معينة أو في سياق زماني ومكاني محددين يتحول من التجريد إلى التشخيص، ومن ثم يتطلب اجتهادا نسميه (تحقيق المناط). وبناء على هذا سنقوم بتحرير مفهوم ولي الأمر، وهو الحكم الفقهي المجرد الذي نطلق عليه صفة “المعياري”، ثم سنوضح كيف نزّل الفقهاء السابقون صلاحيات ولي الأمر على واقعهم، لنأتي بعد ذلك إلى تحقيق المناط في الواقع الحالي.
على المستوى المعياري (أو الحكم العام) نجد أن الإمامة -كما عرفها الماوردي- “موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا”، وهذه الوظيفة الجامعة بين الديني والسياسي تكاد تكون محل اتفاق بينهم، فابن تيمية يؤكد أن المقصود الواجب في الولايات عامة (صغرى وكبرى) هو “إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم”، وأبو عبد الله بن الأزرق (892 للهجرة) يُرجِع الوجوب الشرعي في نصب الإمام إلى كونها “نيابة عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنيا به، وسمي باعتبار هذه النيابة خلافة وإمامة، وذلك لأن الدين هو المقصود في إيجاد الخلق لا الدنيا فقط”.
وقد فرض هذا التصور لوظيفة الإمامة أو ولاية الأمر على الفقهاء أن يضعوا (من الناحية المعيارية) شروطا محددة لمن يلي أمر المسلمين، وهي شروط صعبة؛ منها: العدالة الجامعة، والعلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام، والرأي المفضي إلى سياسة الخلق وتدبير المصالح، والشجاعة والنجدة المؤدية إلى حفظ الجماعة وجهاد العدو، وغيرها، وهي شروط تجمع بين الكفاءة والتأهيل من جهة، والفضائل الأخلاقية من جهة أخرى، ومن هنا أمكن للإمام القرافي أن يميز -من الناحية المعيارية- بين وظائف 3 هي: المفتي والقاضي والإمام (ولي الأمر)، وذلك بأن الإمام وظيفته أعم وأشمل؛ فالإمامة جزؤها القضاء والفتيا، فـ”للإمام أن يقضي وأن يفتي… وله أن يفعل ما ليس بفتيا ولا قضاء كجمع الجيوش وإنشاء الحروب… وهي أمور كثيرة يختص بها لا يشاركه فيها القاضي ولا المفتي”. وهذا التمييز والتقرير لا يتأتى إلا على أساس التصور الكلي السابق: مفهوما ووظيفة وشروطا؛ لأن الكلام كله إنما هو في التصور المعياري المجرد (أو الحكم الكلي)؛ ذلك أنهم عظّموا منصب الإمامة العظمى وجعلوه خلافة للنبوة، ومن ثم فقد جعلوه وظيفة مركبة: دينية ودنيوية، وشددوا في شروطها. قال القرافي “وهو دأب صاحب الشرع، متى عظَّم أمرا كثَّر شروطه”.
ولكن هذا التصور المعياري لم يكن هو الواقع تاريخيا على طول الخط؛ فقد واجه الفقهاء مسألة حكام الضرورة ومشكلة تحقيق المناط، وتوضح لنا كتب الفقه الفروعية تطبيقات الحكم المعياري، والاختلاف الواقع بين وصف الإمامة كمنصب وبين واقع الإمامة ممثلا بحكام الزمان المعين، وسأضرب هنا 5 أمثلة مختلفة تمثل المذاهب الأربعة.
المسألة الأولى: أن المالكية حين ناقشوا دفع الزكاة إلى ولي الأمر بينوا -بوضوح- أنه إذا كان جائرا في صرف الزكاة وبذل الأموال، فلا يُجزِئ المزكي دفعها إليه؛ لأنه يكون حينها من باب التعاون على الإثم والعدوان، وأن الواجب على المزكي حينئذ جحد الزكاة والهروب من دفعها إلى الإمام ما أمكن، وهذا الحكم لا يتأتى إلا بالنظر والاجتهاد من قبل المزكي نفسه في حاكم زمانه، وهل يدفعها إليه أم يهرب منه؛ وهي مسائل ديانية مرتبطة بالإجزاء عند الله أو عدمه؛ لأن دافع الزكاة يتحرى في دفعها القبول من الله وإبراء ذمته بأداء الواجب.
المسألة الثانية: الرِّكاز وهو المال المدفون في الأرض، فمذهب جمهور الشافعية أنه لُقَطَة يعرّفه الواجد سنة، وقال بعض الشافعية يُرد إلى الإمام يحفظه في بيت المال العام؛ لكن تقي الدين الحصني الشافعي (829 للهجرة) علق على ذلك فقال “أما في زماننا فإمام الناس هو وأتباعه ظلمة غشمة، وكذا قضاة الرشا الذين يأخذون أموال الأصناف التي جعلها الله تعالى لهم بنص القرآن يدفعونها إلى الظلمة؛ ليعينوهم على الفساد فيحرم دفع ذلك وأشباهه إليهم. ومن دفع شيئا من ذلك إليهم عصى؛ لإعانته لهم على تضييع مال من جعله الله له. وهذا لا نزاع فيه، ولا يتوقف في ذلك إلا غبي أو معاند عافانا الله من ذلك”.
المسألة الثالثة: أنه في المواريث قد يَفضُل مال بعد توزيع الفرائض على مستحقيها (يُسمى الرد)، والأصل في هذا المال أن يُرد في بيت مال المسلمين؛ لكن متأخري الحنفية ذهبوا إلى أنه “يفتى بالرد على الزوجين في زماننا؛ لفساد بيت المال”، وقال المحقق أحمد بن يحيى بن سعد التفتازاني “أفتى كثير من المشايخ بالرد عليهما (أي الزوجين) إذا لم يكن من الأقارب سواهما؛ لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه الأيام”. وأوضح ابن عابدين أن “هذه المسألة مما أفتى به المتأخرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورة”؛ أي ظلم الحكام، ثم قال “وحيث ذكر الشراح الإفتاء في مسألتنا فليُعمل به، ولا سيما في مثل زماننا؛ فإنه إنما يأخذه من يُسمى وكيل بيت المال، ويصرفه على نفسه وخدمه، ولا يصل منه إلى بيت المال شيء… فمن أمكنه الإفتاء بذلك في زماننا فليُفت به ولا حول ولا قوة إلا بالله”؛ أي إنهم خالفوا أصل المذهب، بسبب طغيان الحكام والولاة.
المسألة الرابعة: أن الحنابلة نصوا في كتبهم على أن المراد بالحاكم مَن توفرت فيه الأهلية، فقد أوضح بعض متأخري الحنابلة أن كلام أئمة المذهب عن الحكام إنما يتوجه إلى “حاكم أهلٍ إنْ وجد، وهو أندر من الكبريت الأحمر”، قال الرحيباني (1243 للهجرة) “وهذا ينفعك في كل موضعٍ اعتُبر فيه الحاكم فاعتمده واحفظه؛ فإنه مهم جدا”. وذلك أن الإمام أحمد بن حنبل حين سئل عن ائتمان الحاكم على المال قال “أما حكامنا اليوم هؤلاء؛ فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيئا”.
وإذا كانت المسائل الأربعة السابقة تتصل بالأموال على نحو ما، فإنه معلوم أن الدماء آكد؛ فحفظ الدماء مقدم على حفظ الأموال، بل إن المسألة تتعدى ذلك إلى المسائل الدينية والشعائر، من ذلك -وهي المسألة الخامسة- أن الحنفية الذي يرون أن خطبة الجمعة من مسائل الإمامة (تكون في المصر الجامع، وبإذن ولي الأمر)، قد فصلوا فيها تفصيلا يهمنا هنا في الحديث عن ولي الأمر وتحقيق المناط. فقد حكى بعض الحنفية عن إبراهيم النخعي وإبراهيم بن مهاجر من التابعين أنهما كانا يتكلمان وقت الخطبة.، فقيل لإبراهيم النخعي في ذلك، فقال إني صليت الظهر في داري ثم رحت إلى الجمعة تقية. وبيان ذلك أن الواجب على المصلي الإنصات إلى الخطيب، وأن من تكلم أثناء الخطبة فقد لغا، ولكن ابن نجيم الحنفي أوضح أن لتلك الواقعة تأويلين: أحدهما أن الناس كانوا في ذلك الزمان فريقين فريق منهم لا يصلي الجمعة؛ لأنه كان لا يرى الجائر سلطانا، وسلطانهم يومئذ كان جائرا؛ فإنهم كانوا لا يصلون الجمعة من أجل ذلك. وكان فريق منهم يترك الجمعة؛ لأن السلطان كان يؤخر الجمعة عن وقتها في ذلك الزمان، فكانوا يأتون الظهر في دارهم، ثم يصلون مع الإمام ويجعلونها سبحة أي نافلة”، ومن هنا قال بعض الحنفية إن الدعاء للسلطان في خطبة الجمعة غير مستحب؛ ورأيي أن مرد ذلك إلى أمرين أولهما: أنه خروج عن موضوع الخطبة وهو التذكير، وثانيهما: تخلصا من الدعاء لحكام الجور، لذلك اختلفوا في فضل الدنو من الإمام/الخطيب؛ لأن الدنو يحيل إلى فضيلة التبكير إلى الجمعة، ولكن بعض الحنفية فضّل ابتعاد المصلي عن الإمام حتى لا يسمع مدح الحكام الظلمة في الخطبة؛ بل إنه جرى التمييز في مسألة الإنصات إلى الخطيب بين الإنصات لحمده ومواعظه، وبين عدم الإنصات إلى مدح الخطيب للحكام الظلمة والثناء عليهم، ومن ثم أباحوا الانشغال بالكلام ونحوه عن دعاء الخطيب للحكام الظلمة أثناء خطبة الجمعة.
وبعد أن أوضحنا التصور المعياري لولي الأمر، وتحقيق المناط فيه من قبل المذاهب الفقهية المختلفة قبل نشوء الدولة، لا بد أن نوضح هنا أن تصرفات ولي الأمر ليست خارجة عن سلطان أحكام الشريعة في نظر الفقيه، ومن ثم وجدنا أحكام الإمامة جزءا من صميم الفقه العام، وكان الإمام الماوردي أول من أفردها عن الفقه العام تسهيلا على الحكام ليعرفوا الأحكام التي تختص بهم مما يقرره الفقيه، ولهذا نجدهم يقررون الولايات والشروط والاختصاصات، كما يقررون ما يجب على الحكام وما يجوز لهم، والقيود والضوابط في تصرفاتهم بالمصلحة العامة، ما يعني أن تنصل مشايخ السلطة من بيان أحكام الشريعة بحجة اختصاص الحكام بهذه التصرفات هو مراوغة؛ لأننا رأينا كيف ترتبط تفاصيل كثيرة دينية ومالية بتصرفات الحكام في نهاية المطاف، وهذا سيكون له أثره على تطبيقات الأحكام الشرعية المختلفة.
وهنا يجب أن نقرر أن كون ولي الأمر جهة اختصاص لا يعني إعفاءه من المساءلة في الفقه، وهذا فارق مهم بين الواقعي والمعياري، وهي المسألة الجوهرية التي يهرب مشايخ السلطة من مواجهتها، وذلك أن تصرفات الإمامة منوطة بالمصلحة العامة تحديدا، فكما أن القضاء يعتمد الحِجاج (نظام الحجج والبينات)، والفتيا تعتمد الأدلة الشرعية، فإن تصرف الإمامة يعتمد “المصلحة الراجحة أو الخالصة في حق الأمة” بتعبير الإمام القرافي؛ لكن هذا المبدأ العام يحتاج إلى تفصيل وضبط هنا لإزالة الالتباس والتلبيس عنه:
أولا: لا بد أن نميز بين كون ولي الأمر جهة اختصاص في التصرفات والصلاحيات، وبين كونه مرجعية يحدد -وحده- ما هو معياري (صح أو خطأ، مصلحة أو مفسدة)؛ فمفهوم المصالح العامة مفهوم واسع ومرن، وتصرفات الإمامة تتصل بمسائل كثيرة تمس حيوات الناس أنفسهم في الفقه الإسلامي، وتصرفات الحكام تخضع للجور والظلم والخطأ أيضا، ومن هنا لما تعلقت تصرفاتهم بالعوارض البشرية (الهوى والظلم والخطأ وغيرها) من جهة، وبمنظومة الحقوق الشرعية (حقوق الله وحقوق العباد) من جهة أخرى، كان لا بد من ضبط تصرفات الإمام بموازين الشريعة، التي يشترك الفقيه في تقريرها أيضا إلى جانب الناس الآخرين، الذين لهم حق في المصالح العامة أو قد تطولهم تعديات الحكام، فتثبت لهم حقوق.
لا يقتصر الأمر على أن تصرفات الإمامة ليس لها صفة معيارية فقط؛ بل هي أيضا لا تغير من حقيقة الحكم المعياري، فالحكام ليسوا شارعين؛ بل مطبقين لأحكام الشريعة كما سبق وتقرر في وظيفة الإمامة في الفقه، وحين منع عمر بن الخطاب بعض الصحابة من الزواج بالكتابيات مثلا، أوضح لهم أنه إنما يفعل ذلك سياسة لا أنه يحرمه؛ لأن ليس له سلطة التحريم والتحليل.
من أمثلة ذلك مثلا أن الفقه يمنح ولي الأمر حق الإجبار؛ دفعا لظلم أو تحقيقا لمصلحة عامة، ولكن هذه السلطة القهرية المخولة له إذا خلت عن مرجعية معيارية مفصولة عنه تحولت إلى باب فساد عظيم، ولا شك أن الفقهاء لم يقصدوا ذلك كما يُخيل لمشايخ السلطة، وإلا فلماذا قرروا أن ولي الأمر والقاضي ومن يقوم بالأعمال العامة، إذا أخطؤوا في عملهم الذي كُلفوا به فتلف بذلك نفس أو عضو أو مال؛ فإنهم يضمنون، ولكنهم اختلفوا في تفاصيل ذلك، وهل يجب الضمان من بيت المال أم من المال الخاص للحاكم أو عاقلته (قبيلته)؟.
ثانيا: لا يقتصر الأمر على أن تصرفات الإمامة ليس لها صفة معيارية فقط؛ بل هي أيضا لا تغير من حقيقة الحكم المعياري، فالحكام ليسوا شارعين؛ بل مطبقين لأحكام الشريعة كما سبق وتقرر في وظيفة الإمامة في الفقه، وحين منع عمر بن الخطاب بعض الصحابة من الزواج بالكتابيات مثلا، أوضح لهم أنه إنما يفعل ذلك سياسة لا أنه يحرمه؛ لأن ليس له سلطة التحريم والتحليل.
ثالثا: حينما نتحدث عن جهة اختصاص، لا يعني ذلك أنها خارج المساءلة والتقويم، ولذلك تحدث القرافي وغيره عن ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة وما لا ينفذ منها؛ لأن ثمة سلطة مرجعية معيارية يُحتكم إليها، وهنا يمكن أن نوضح أمرين بالاستناد إلى القرافي: الأول: أن الولاية وظيفتها جلب المصلحة أو درء المفسدة، فالولاة يجب أن يكونوا معزولين عن 4 أمور: المفسدة الراجحة، والمصلحة المرجوحة، والمصلحة المساوية، وما لا مفسدة فيه؛ لأن ولايتهم تفرض عليهم اختيار الأحسن. والثاني: أن تصرفات الولاية قد تكون صادرة عن جهة اختصاص، ولكنها باطلة من جهة المضمون؛ لأن ولي الأمر قد حكم فيها بمستند باطل “فهذا يُنقض لفساد المدرك لا لعدم الولاية فيه”، وذلك ما إذا خالف أحد 4 أمور: إذا حكم ولي الأمر على خلاف الإجماع، أو على خلاف النص السالم عن المعارض، أو على خلاف القياس الجلي السالم عن المعارض، أو على خلاف قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض. وكل هذا يوضح أن الاختصاص فقط لا يكفي؛ بل لا بد من تقويم المضمون، وهو خلاف ما يوهم مشايخ السلطة، ويُلبسون به على الناس، فما بالك لو انضم إلى أحكام ولي الأمر التهمة، و”التهمة تقدح في التصرفات إجماعا من حيث الجملة”.
توضح بعض الوقائع التاريخية عن عمر بن الخطاب وغيره هذا المنحى في المساءلة لولاة الأمر بمعايير زمنها، ويمكن بناء على ما سبق أن نقرر الفرق بين هذا التصور وبعض التصورات الحديثة المرتبطة بمفهوم السيادة، فالسيادة في الفقه الإسلامي -إن جاز لنا استعمال المصطلح- هي للشريعة لا للحكام، في حين أن بن بيه وصحبه يريدون أن يُسقطوا مفهوم السيادة على الحاكم، فهو -وحده- القادر على اتخاذ القرار، وهو -وحده- من يحدد صواب الفعل، وفعله يصبح -بمجرد صدوره عنه بصفته- فعلا صالحا من جهة الشريعة، وتثبت له صفة معيارية، وهذا نقض لتصورات الفقه الإسلامي وتشريع للاستبداد باسم الفقه.
رابعا: ما سبق هو بيان للأحكام المجردة بعيدا عن تحقيق المناط؛ أي إن ذلك كله مفروض في منصب ولاية الأمر، وفيمن تحققت فيه الشروط، حتى تصدر التصرفات ممن هو أهل لها في محل الاختصاص، وهذا معنى أن تصرفات الإمامة منوطة بالمصلحة، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومع ذلك شددنا في الشروط، فكيف لو صدرت التصرفات من حكام اليوم؟. فالفقهاء عندما اشترطوا في الحاكم أن يكون قيّما بمسائل الشأن العام عارفا بالمصالح، إنما أرادوا بهذا الناحية المعيارية لا الوصفية؛ أي إن المسألة هنا مبنية على الكفاءة والعلم لا أنها وصف لواقع الحال، أو أنها مجرد مدلول لغوي يُطلق على كل من يلي أمرا ما، ولذلك رأيناهم يدققون في الفتوى في المسائل الخمس التي ذكرتها وهي مجرد أمثلة.
شكلت المسافة الفاصلة بين الحكم ومناطه مساحة خصبة للاستثمار السياسي والاجتهاد الشخصي أيضا، وهذا إن كان مقبولا في الأفعال الفردية، فإنه في مسائل السياسة والشأن العام محل إشكال كبير من جهتين: الأولى تأثيره على الجميع؛ لأن مسائل الشأن العام تلتقي فيها مصالح الأفراد والجماعات، وهي التي يُفترض أن تشكل فضاء للنقاش وتشكيل الرأي العام في ظل الدولة الحديثة
ولكن السؤال الأهم هنا هو كيف نحقق مناط ولي الأمر في دول اليوم؟ تلخص مشروع بن بيه في “تحقيق المناط” في فكرة مركزية واحدة، وهي الدفاع عن صلاحيات ولي الأمر وإسناد الأمر إليه وحده، ومن ثم أناط بولي الأمر كل مسائل الشأن العام دون أن يكلف نفسه عناء تطبيق ما يدعونا إليه، وهو تحقيق المناط الذي يفرض الإجابة على الأسئلة الآتية: من السلطان في دول اليوم؟ وهل تثبت له الصلاحيات التي تحدث عنها الفقهاء؟ وهل ولي الأمر اليوم هو الحاكم الفرد أم مؤسسات الدولة بتخصصاتها المختلفة؟ وكيف نرسم العلاقة بين سلطات الحاكم من جهة، ومؤسسات الدولة من جهة ثانية، وإرادة الشعب من جهة ثالثة؟ وما دور القانون والدستور إذا ما أخل ولي الأمر بواجباته أو أساء استخدام صلاحياته؟ وما الواجب على العلماء والفقهاء من الناحية الدينية إذا ما أساء الحاكم استخدام سلطته التي خولها له الفقه؟. كل هذه أسئلة تتصل بتحقيق مناط الحكم في عالم اليوم، والإجابة عليها واجبة، وإلا فأي استدعاء لفقه ولي الأمر واختصاصاته الذي حُدد قبل الدولة في ظل الدولة هو تزييف مزدوج: فمن جهة هو تحريف للفقه نفسه كما أوضحت؛ إذ إن الفقه يميز بين الحكم المجرد وبين تنزيله على حكام الأزمنة المختلفة، ومن جهة أخرى هو تجاهل لتطورات أنظمة الحكم وكلي الواقع الذي حدثنا عنه بن بيه نفسه، وذلك أنه اُنتقل من الدولة السلطانية إلى الدولة الحديثة التي تعبر عن إرادة الشعوب من خلال الهيئات المنتخبة، والتي تحفظ الحقوق وتصون الحريات، والتي يسود فيها حكم القانون، ويخضع حكامها للمساءلة، وأن الحكم فيها مؤسسي لا فردي.
شكلت المسافة الفاصلة بين الحكم ومناطه مساحة خصبة للاستثمار السياسي والاجتهاد الشخصي أيضا، وهذا إن كان مقبولا في الأفعال الفردية، فإنه في مسائل السياسة والشأن العام محل إشكال كبير من جهتين: الأولى تأثيره على الجميع؛ لأن مسائل الشأن العام تلتقي فيها مصالح الأفراد والجماعات، وهي التي يُفترض أن تشكل فضاء للنقاش وتشكيل الرأي العام في ظل الدولة الحديثة، بمعنى أن كل فرد له إسهام وحق فيما تقرر أنه مصلحة عامة وإلا لم يعد “عاما”، أو تحول إلى وصاية وهي مسألة لم تعد تصلح في سياق الدولة الحديثة، التي نتحدث فيها عن مواطنين، ولاسيما أن بن بيه حريص جدا على حقوق الأقليات بحكم المواطنة، فيجب ألا يناقض نفسه فيرجع إلى مفهوم “الرعايا”. والجهة الثانية: أن مسائل الشأن العام عُرضة للتلاعب، وهي موضوع الصراعات السياسية الحالية في منقطتنا منذ رحيل الاستعمار، وتتنوع فيها الآراء والمواقف، ويتداخل فيها الداخلي والخارجي، كما تتداخل فيها مصلحة النظام ممثلا برئيسه وحاشيته، مع مصلحة الدولة ممثلة بمؤسساتها التمثيلية المعبرة عن الشعب ومصالحه.
حدثنا بن بيه في كتابه “تنبيه المراجع” عن الاشتباه الماثل في الأذهان بين نتائج القيم الغربية الديمقراطية التي تقوم على المغالبة والصراع، وبين مقتضيات قيم الشريعة التي تقوم على المصالحة وحفظ المصالح؛ لكنه اصطف إلى جانب من يقود الصراع والمغالبة في المنطقة لوأد ثورات الحرية والحقوق في المنطقة؛ أي إنه اختار المغالبة باسم المصالحة، كما أنه شخص لنا المشكلة في عالم اليوم في ثلاثية هي: قصور في إدراك الواقع، وقصور في فهم تأثير كلي الواقع في الأحكام، وقصور في التعامل مع منهجية استنباط الأحكام بناء على العلاقة بين النصوص والمقاصد وبين الواقع. ولكن هذا القصور الثلاثي نراه متحققا في تصرفاته وفي مشروعه الذي سماه تحقيق المناط، كما أوضحت ذلك هنا وفي المقالات السابقة. بقي أن نفرد مقالا للثنائية الخادمة للاستبداد التي ابتكرها بن بيه؛ وهي التعارض بين السلم والعدل.
(المصدر: الجزيرة)