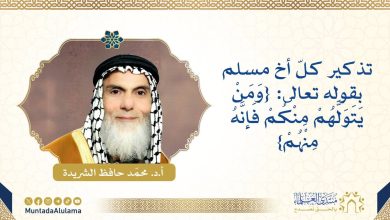هل يتعدد الحق في المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها؟
بقلم وائل البتيري
لا يستلزم القول بأن “الحق واحد لا يتعدد” الحكم على مخالفك بالبدعة والضلال، فإن العلماء المرجِّحين لهذا القول لم يجعلوا ذلك لازما له، وإنما غاية ما في الأمر أن المخالف المجتهد الذي بذل وسعه في مسألة ما، وأخطأ في إصابة “الحق” مأجور على اجتهاده، وقوله دائر بين كونه اجتهاداً مستساغاً – كعامة أقوال الفقهاء – أو قولاً شاذاً مهدوراً.
ولكنّ إطلاق وصفي “الحق” و”الباطل” على المسائل الاجتهادية التي يحتملها النص والواقع؛ فيه تجوز واضح، فالحق هو الثابت الذي لا شك فيه، وهذا الشك لازم لأكثر المسائل الاجتهادية – سواء العلمية أو العملية – وقد يتفاوت قوةً وضعفاً عند فقيه دون آخر.
وعليه؛ فإن الاستشهاد بقوله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال} على إهدار قول المخالف ضربٌ من المجازفة، ووضع للآية الكريمة في غير محلها، إذ إن سياق الآية يتحدث عن توحيد الله تعالى، واصفاً الخالق سبحانه بأنه “الحق” وناعتاً عدم خضوع البشرية لعبودية الله بـ”الضلال”، قال سبحانه: {قل مَن يرزقكم من السماء والأرض؟ أمّن يملك السمع والأبصار؟ ومَن يُخرج الحيَّ من الميت ويُخرج الميت من الحي؟ ومن يدبّر الأمر؟ فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تُصرَفون. كذلك حقّت كلمتُ ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون} (يونس: 31-33).
إن الاستشهاد بقوله تعالى: “فماذا بعد الحق إلا الضلال” على إهدار قول المخالف ضربٌ من المجازفة، ووضع للآية الكريمة في غير محلها، إذ إن سياق الآية يتحدث عن توحيد الله تعالى، واصفاً الخالق سبحانه بأنه “الحق” وناعتاً عدم خضوع البشرية لعبودية الله بـ”الضلال”
صحيحٌ أن “الضلال” يأتي في القرآن على معاني ودرجات متعددة، إلا أنه في هذه الآية حين قابل “الحق” الثابت الذي لا شك فيه؛ نال أعلى درجات الزلل والجور، وهي درجة الضلال الصريح الذي لا شك فيه، مما جعل الحق والضلال هنا قسمين لا ثالث لهما، قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: “قال علماؤنا: حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالى، وكذلك هو الأمر في نظائرها، وهي مسائل الأصول التي الحق فيها في طرف واحد”.
فكيف يصح بعد ذلك أن يستشهد بعض أهل العلم بهذه الآية على إهدار قول سائغ في مسألة خلافية، سواء كانت علمية أو عملية، وإلزام المخالف بأن قوله من “الضلال” الذي يجب العدول عنه؛ بحجة أن قول المُلزِم هو “الحق” وما دونه “الضلال”؟
ولو قيل إن كل الأقوال التي يحتملها النص “حق” لكان ذلك أقرب إلى الصواب؛ من الجزم بأن بعضها “حق” وبعضها الآخر “باطل”، وأقصد بذلك أن مجموع هذه الأقوال حق ثابت لا يجوز الخروج عنه لقول لا يحتمله النص؛ يُحدثه بعض مدعي الفقه في زماننا من نجوم الفضائيات.
ولعل من المحبَّذ أن نسوق هنا قول الإمام الشوكاني في مسألة “هل الحق يتعدد؟” لما فيه من إيضاحٍ لهذه المسألة، قال رحمه الله في “إرشاد الفحول” حول “المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها”:
“وقد اختلفوا في ذلك اختلافا طويلاً، واختلف النقل عنهم في ذلك اختلافا كثيرا، فذهب جمعٌ جمٌّ إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها (أي المسائل الظنية) حق، وأن كل واحد منهم مصيب، وحكاه الماوردي، والروياني، عن الأكثرين.
قال الماوردي: وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة.
وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحد الأقوال، ولم يتعين لنا، وهو عند الله متعيّن; لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالاً وحراماً، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخطّئ بعضهم بعضا، ويعترض بعضهم على بعض، ولو كان اجتهاد كل مجتهد حقاً; لم يكن للتخطئة وجه.
ثم اختلف هؤلاء بعد اتفاقهم على أن الحق واحد؛ هل كل مجتهد مصيب أم لا؟… إلخ”.
ثم قال الشوكاني مجلياً رأيه في المسألة:
“وها هنا دليل يرفع النزاع، ويوضح الحق إيضاحا لا يبقى بعده ريب لمرتاب، وهو الحديث الثابت في الصحيح من طرق؛ أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر.
فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد، وأن بعض المجتهدين يوافقه، فيقال له: مصيب، ويستحق أجرين، وبعض المجتهدين يخالفه، ويقال له مخطئ، واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبا، وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر، فمن قال: كل مجتهد مصيب، وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين؛ فقد أخطأ خطأ بيناً، وخالف الصواب مخالفة ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل المجتهدين قسمين، قسما مصيبا، وقسما مخطئا، ولو كان كل منهم مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى.
وهكذا من قال: إن الحق واحد، ومخالفه آثم، فإن الحديث يردّ عليه رداً بيناً، ويدفعه دفعاً ظاهراً; لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى من لم يوافق الحق في اجتهاده مخطئا، ورتب على ذلك استحقاقه للأجر، فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة؛ أن الحق واحد، ومخالفه مأجور، إذا كان قد وفى الاجتهاد حقه، ولم يقصر في البحث، بعد إحرازه لما يكون به مجتهدا” انتهى كلام الشوكاني.
وقد يقول مستشكلٌ للاحتجاج بحديث “إذا حكم الحاكم…”: إن هذا خاص في القضاء بين خصمين في مسائل واقعية، وليس متعلقاً بفهم النص، وهو كما جاء في حديث أم سلمة الذي في الصحيحين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: “إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق؛ فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم؛ فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها”.. ففي هذه الحالة يُقال إن الحق واحد، وإن أحد الخصمين مُحق والآخر مُبطل، أما ما يتعلق بالنصوص الشرعية فلا يصح أن توصف الأفهام المستساغة منها بأنها “ضلال” لأن القرآن الكريم ودلالاته العربية كل ذلك “حق”، ولا يجوز أن نفصل بين النص وبين دلالته، فنقدّس النص ونصفه بأنه “حق”، وننتقص من دلالته التي تستسيغها اللغة العربية قائلين إنها “ضلال”.
ولكن يَردُ عليه أن الحديث وإنْ كان يتحدث عن الحاكم الذي يقضي بين الخصوم؛ إلا أنه يشمل غيره بجامع أمرين؛ بذل الجهد في الوصول إلى الحقيقة، وقصد الوصول إليها لا مخالفتها.
ويَرِدُ عليه أيضاً أننا نصف الفهم الخاطئ بأنه “ضلال” ولا نصف الدلالة الصحيحة للنص، وإنْ كنا لا نجزم بأن ما رجّحناه هو “الحق” الذي لا محيد عنه، وإنما نحكم على ذلك من باب غلبة الظن، وعليه فنخلص إلى أن نصوص القرآن “حق” ودلالاتها الظنية تتضمن “الحق” ولكن الله تعالى لم يجعلها قطعية لحكمة أرادها سبحانه.
ومع ذلك؛ فقد يصح أن يُقال إن الله تعالى أراد جميع هذه الدلالات التي استنبطها الفقهاء من النص الواحد، ليكون للأمة سعة في الأخذ بأحد هذه الدلالات أو الأقوال، وعليه فيكون مجموع هذه الأقوال – كما أشرت سالفاً – حق، والخروج عنها بقول لا يحتمله النص هو “الضلال”.
وعلى كل الأحوال؛ فإن المقام يستلزم التأكيد على أن وصف أحد الدلائل المحتملة للنص الواحد بـ”الحق” وبقيتها بـ”الضلال” فيه تجوّز غير محمود، وقد بُنيت عليه مواقف حادة تجاه المخالف، وكان الأولى بمن هو مقتنع بهذا التفصيل أن يقتصر على وصفها بـ”الصواب” و”الخطأ” كما جاء في الحديث الذي أشار إليه آنفاً: “إذا حكمَ الحاكمُ فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر”، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: “رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب”، ووصف هذه الأقوال بذلك حينئذ ليس من باب التجميل لها أو للخلاف فيها، وإنما من باب مطابقة الأوصاف للواقع.
وأعاود القول لأؤكد: صحيحٌ أن الضلال درجات، ولكنه حينما يقابل “الحق” فإنه يعني أعلى درجات الضلال، فالجلاء والثبات معنيان لازمان للحق، فإذا ما قابلهما الباطل في القسمة؛ لزمه نفس المعنيين.
وإن من المستساغ أن نصف المجتهد المخالف لنا بـ”المخطئ” لأن قوله موصوف بـ”الخطأ”، وليس من المقبول في حال أن نصفه بـ”الضال” تشنيعاً وتبكيتا؛ لأن قوله موصوف بـ”الضلال”.
من المستساغ أن نصف المجتهد المخالف لنا بـ”المخطئ” لأن قوله موصوف بـ”الخطأ”، وليس من المقبول في حال أن نصفه بـ”الضال” تشنيعاً وتبكيتا؛ لأن قوله موصوف بـ”الضلال”
خلاصة الأمر؛ إن الخلاف في مسألة “هل يتعدد الحق في المسائل غير القطعية؟” أقرب إلى الترف الفكري.. والذي يعنينا هو النتيجة الواقعية لهذا الخلاف، أقصد الموقف من المخالف، وهل يجوز أن نصف قوله بـ”الضلال” أو نصفه بـ”الضال” لكونه قال قولاً وصفنا خلافه بـ”الحق”، ثم نُعمل على هذا “الضال” سيف التسفيه والتبديع والإهدار والهجر؟ وكيف يكون منا شيء من ذلك مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفهمَي الصحابة المشهورَين لقوله “لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة”؟ وهو حديث يلخص المسألة ويضبطها.
وكيف لنا أن نسفّه المخالف ونبدّعه ونضلّله؛ وقد جعل الله تعالى النص في هذه المسائل ظنياً، وفي إقدامنا محادة لإرادة الله تعالى التي نكاد نجزم أنها إرادة شرعية، وأن المقصود منها التوسعة على الأمة.. مع التأكيد على أن الله تعالى لم يرد منا أن لا نختلف في الاجتهاد؛ ولو كان ذلك كذلك لجعل النصوص كلها قطعية، وإنما أراد منا أن لا نتنازع ونتخاصم لمجرد أن اختلفنا في آرائنا. والله تعالى أعلم.
(المصدر: موقع بصائر)