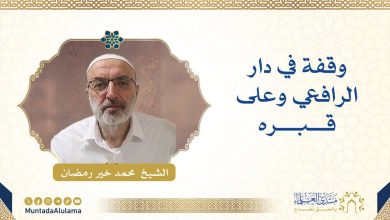بقلم عمار حسين الحاج
لا نبالغ حين نصف طريقة حكم الطغاة على اختلاف انتماءاتهم الظرفية أو الموروثة، لا نبالغ حين نصفها ونصنّفها بأنها دين مثل كل الأديان المُنزلة أو الوضعية، على اعتبار “الدين” بالتعريف هو “جملة المبادئ التي تدين بها مجموعة من البشر اعتقادًا أو عملاً، أو الاثنان معاً!” وأهم مبادئ دين الطغاة هو “السجن السياسي”.
أن تقضي على معارضين لأفكارك بزجهم بعيداً عن الحياة والموت معاً، في عُلَبٍ قهريةٍ، وتستنزفهم جسدياً ونفسيّاً، مُمعِناً في كسر إصرارهم على تنوير المجتمع فكرياً وإنسانياً حول مدى ظُلمكَ واستغلالكَ لهُ عبر استملاك مقدراته البشرية وأسباب حياته واستمراره وأدوات تطوره، وذلك عندما جئت إلى مركز مدير ثرواته وراثةً أو قدراً، أو عن طريق تبنيك لنهجٍ ثوريٍّ على ظلم السلطة التي انتقلت عبر مؤسساتها إلى عقدة الحلِّ في انهيارها، وقدرت بلفيفٍ من الأحرار أن تتسلم القيادة! ثم انقلبت على لفيفك وأدلجت ثورتك الجديدة التي تُناقض مفاهيم ثورة اللفيف بالهدف والأدوات، ومن ثم يُستبدل الطاغية بطاغية، والظلم بظلمٍ جديد مختلف الطعم والرائحة سياسياً وتاريخياً. وتسعى في بناء كوادر جديدة للسجن ذاته الذي ربما زرته في زمن الطاغية السابق، لتزج فيه عقولاً حاولت وتحاول إنارة محيطها المجتمعي، وتمنعها عن فعل الإفصاح والتغيير، نحو إزالة أسباب “دحر الإنسانية إلى هوة مجتمع القطيع”، والذي سَتُصَيِّرهُ بكل أدوات القمع الممنّهجة على أساس العامل النفسي والوجودي لتحويل المجتمع إلى قطيع مستهلك، وخائف، من مجسمات للوحش المفترس الذي صنعته بنفسك بمساعدة لفيفٍ آخر اخترته بعنايةٍ من كل طبقات المجتمع، من قمة نخبهِ المثقفة وحتى قاع المجتمع.
هذا الوصف للفعل الكلاسيكي الذي استخدمته فئات خرجت من رحم استعمار القرن الماضي لبلداننا وأنتجت ثوراتها وأنتجت عقيدتها الجديدة على آلام السجون وطلقات الغدر والتصفية للواعين والقارئين الجيدين للعبة أنظمة “وطنية ما بعد الاستعمار”، حتى صارت الديكتاتورية دين الأنظمة الجديد، ومنهجها المعياري والتكفيري هو السجن بكل ما يحويه من أدواتٍ لإعادة تأهيل الأدمغة المتمرّدة على الدين الحاكم، ليمر بنا على سبيل الذكر لا الحصر في شريط الذاكرة الجمعي من سجون “عبد الكريم قاسم” إلى زنزانات “صدام حسين” ومفرمته البشرية، وصولاً حتى سجون “جمال عبد الناصر والسادات ومبارك”، مروراً بسجون “بن علي، وبوتفليقة” لنقف طويلاً عند سجني “المزّة وتدمر” ، مرتبطين بصورة حافظ الأسد المرسومة بريشةِ رسَّامٍ مرتجفة، مثالٌ عن أساطير السجون العربية العصي علينا الخوض في تفاصيلها بشكلٍ دقيقٍ ومدروس لعدم قدرة الشعوب على مواجهة المكنة الأمنية للحاكم وتوثيق ألمها، لنجد بأنَّ شعوباً بأكملها سُجِنَتْ ذاكرتها داخل جدران زنزانة الدين الجديد.
وهذا الفكر الذي يعشّش ضمن كواليس السلطة، والذي يتجذّر في عقول من يصل إلى الخط الأول في قيادة البلاد سياسياً واقتصاديا وعسكرياً، بأدوات السلاح والسجون والإفقار الفكري والاقتصادي، ثم المنح لآفاق حرية مدروسة أو منح اقتصادي بما يتوافقان مع تهويل بعبع السلطة وتهويل نظرية المؤامرة أو العدو الخارجي، والأمن القومي، وتفريغ المجتمع عبر سنوات من مضمونه الإنساني ومضمونه التعريفي كحالةٍ من العيش المشترك والاندماج والتضامن ضمن معادلة المساواة، إلى تعريفٍ جديدٍ ــ تم بناؤه ــ على خلود السلطة والقائد، وتحيا لتبدع ما تدرأ به نفسك سوط الجلاد، وزجك في عتمة زنازينه.
هل ساهمتِ السجون في تحطيم النفسية العامة والارتداد عن صنع حرية الشعوب والقضاء على الدكتاتورية؟
يمكن أن تكون السجون بأدواتها المُمنهجة في التعذيب قد شوّهت علاقة الشعوب بقادتها.. وحصل تراكم كميّ وليس كيفياً للذاكرة عموماً على حامل أساسي يرتكز على دراسة الممنوع، والمسموح، وإعطاء القيادة الحكيمة بُعدها التاريخيِّ العميق والمتجذِّرِ في تكوين الشخصية وهويتها الاجتماعية، وتصويرها بأنها بيت الأمان من ما يُحاك للبلاد من مؤامراتٍ ومخاطر، فيكذب الجيل الذي يعاشر تكوين بعبع السلطة وسطوة سجونه، ويرث الكذبة الجيل الذي يليه، ويحتاج لأدلجة فكر القيادة جيلان على الأقل ليصبح ديناً جديداً، وينتج أخيراً جيلٌ يصدِّق الكذبة ويُصَيِّرها واقعاً مصيرياً، وغيرها كُفراً بالعقيدة الوطنية، وهو الجرم الأعظم.
وبالتالي “إن الأنظمة الشمولية تُعطي الذاكرة الجماعية مضموناً وشكلاً رسميين، وتضع للذاكرة الفردية أسيجةً عاليةً مدروسةً لِتُنتِجَ عند المواطن (قاعدة الصمت)”.
وتخلق وهي تُرَسِّخ مفهوم القطيع ،مواضعها المقدسة الخاصة بها، وتحافظ على حضورها الكُلِّي في المنظور العام لشخصياتها الأيقونية، وتفرضُ بذلك ديناً مدنيَّاً له عقائده وشعائره، وكل ذلك ضروري بشكلٍ متعاظم، لأن مشروعية هذه الأنظمة تظلُّ ناقصةً وتأصلها التاريخيِّ ضعيف.
وبالمقابل ساهمت السجون برغم كل الموت التي احتوته بين جدرانها، على احتكاك أفراد من المجتمع التقوا ليس بطريق المصادفة، وإنما بسبب عنجهية وسطوة القائد، وتهمته لهم بأنهم أعداء الدين دينه الجديد.
وهذا الاحتكاك، الأفقي، -لأدمغة تحمل في بعدها النفسي والاجتماعي قواسم مشتركة لنزعتها التحررية من الحالة “الأمنوية” لأجهزة السلطة القمعية، التي تحمي رأس الهرم، إلى الأجهزة الإدارية التي تغذي بيروقراطية مكاتب مؤسسات الدولة، والتي عن طريقها يستنزف قوت المواطن وثروات البلاد بالفساد وإقصاء الممانع من لعبة المناقصات وعقود مشاريع النهب العام؛ وهذا الاحتكاك مع سكان الزنزانات الجدد ،بوجهيه السلبي والإيجابي، كما استخدمه حافظ الأسد في ثمانينيات القرن الماضي في سجن تدمر، حين زجّ معتقلين من مشارب يسارية مع معتقلين بانتماءات دينية، ضمن زنزانات واحدة، محاولاً دفع الطرفين لإفناء بعضهم فكرياً واجتماعياً وحتى جسدياً، أو عند تقسيمهم إلى أجنحة بحسب الانتماءات والجرم المنسوب- نتج عنهُ عامودياً على أرضية المجتمع من ما تبقى من المعتقلين الناجين من الموت تحت التعذيب والتصفية الجسدية، جيل في العتمة حفظ تاريخ كذبة الدين السلطوي، ووثق لمرحلة قد تأتي ليفرد أوراقه على الملأ.
إذن؛ رغم التفاوت الكبير نسبياً بين حجم وأدوات صانع دين الديكتاتورية، وبين حامل وصانع أدوات التحرّر الإنساني، يبقى الدكتاتور خائفاً منزوياً داخل عبائته الأمنية، ومترصداً بعسكره وسجونه لأي حالة وعيٍّ جماهيريٍّ قد تحدث هنا أو هناك، وللإحاطة بمساحة بلاد صرفَ أكبر ثروتها على بناء السجون والأجهزة التي تديرها.. وهذا الخوف السلطوي، لم يُنتج إلا الإرهاب بمعناه الواسع، حيث إن “الإرهاب ما هو إلَّا وحشيةً غير مجدية، ارتكبها أشخاص أو كيانات هي نفسها مذعورة، وهو البديل الخيالي لطريق السياسة المسدودة، وذلك عندما لا يستطيع الحزب الحاكم الاستقطاب الجماهيري العفوي بمشاريع وطنية حقيقية، وظهور أحزابٍ هي أقرب بتكوينها وعمقها لهموم المواطن، فينتج إرهاب الحزب الحاكم بالإقصاء والتمييز، وبشكلٍ آخر يحدث لدى السلطة فزع اجتماعي شامل وليس نتاج واقع أشكال النضال، فتتّهم السلطة المناضلين الحقيقيين بالإرهاب، كونهم فضحوا زيف الدين الجديد -دين السلطة-.
وها هي الثورة السورية تصوِّر اللوحة كاملةً، من جهة تَجَذُّرِ دين نظامٍ استهلك عدة أجيالٍ وثروات البلاد لينتج نفسه خالداً، جاثماً فوق صدر شعبه، مع وضوح وقراءة ضخامة فاتورة التغيير مُسبقاً، فاتورةً مُحَمَّلةً بالدماءِ والاعتقالات والتغيِّيب القسريِّ والدمار ، فلا بدّ لحركة الطبيعة والتراكم الفكري لشعب خاض أغلب أفراده السجون وذاق ظلم سلطة مارست طقوس دين الطغاة وشعائره على مدى أربعة عقود بشكل أو بآخر، لابدّ لها بأن تنفجر وأن يتم إسقاط النظام في هاوية التاريخ المظلمة؛ فهذه السجون التي تحتضن القمع والموت بكلِّ أشكالهِ تُغافلُ الطغاة وتُنتجُ في عتمتها طُلَّاب حُريَّة الشعوب الحقيقيين، وسيكونون الأنبياء الذين سيكفرون بدين الطغاة، ويبنون مستقبلاً يحتفل بالإنسانية دين الشعوب الذي لا يسقط.
(المصدر: موقع حرية برس)