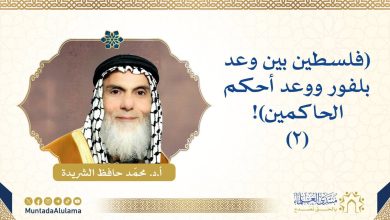هل الفقه الإسلامي فقه ذكوري؟
بقلم شريف محمد جابر
(1)
خلق الله العالم، وخلق آدم، وجعله خليفة في الأرض، وخلق منه زوجه، هكذا شاء سبحانه أنْ {خلقَ الزوجين الذكرَ والأنثى}. لم يسأل أحدًا من خلقه لمَ خلقت الذكر والأنثى؟ ولمَ جعلتهما بهذه الخصائص التي تميّز كلًّا منهما؟ كان قادرا سبحانه أن يخلق خليفة يتكاثر لا جنسيا، أو يخلد ولا يتكاثر، أو أو أو.. ألف مليون احتمال آخر.. ولكنه خلقنا على هذه الهيئة الزوجية، وجعلنا محتاجَين إلى بعضنا بعضا، وجعل لكل جنس منّا دورا أسريا واجتماعيا صلبًا مرتبطًا باختلافنا البيولوجي والنفسي يرسّخ هذا الاحتياج، ولم يجعل الاختلاف تفضيلا للذكورة على الأنوثة، ولم يقل لنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلّم إن الذكر أفضل لكونه ذكرًا، بل جعل الأفضلية والكرامة مرتبطة بالكيان الاختياري للإنسان لا الجبري.
(2)
الأنوثة صفة زائدة على مجرّد الآدمية، كان آدم رجلا فردًا، فخلق الله زوجه وزاد فيها ما جعلها مصنع الرجال، وغرس فيها الرحمة والرأفة والحنان، وميّزها بالرقة والجمال، ولكنه سلبها قوة الرجال وميّزها بالضعف الجسدي والعاطفي؛ لتظلّ محتاجة إلى الرجل كما هو محتاج إليها.
(3)
كان الرسل والأنبياء جميعهم رجال، لحكمة أرادها سبحانه، والمرأة الوحيدة التي قيل إنها نبيّة مختلَف حول نبوّتها، والراجح عدم ذلك، وهي مريم البتول عليها السلام، وفي قصّتها إشارة إلى عظمة دور المرأة، فهي رحم الرجال ومنشؤهم ومحضنهم الدافئ الذي منه وبه وفيه يصيرون. ولكن مهمة الرسل والأنبياء مهمة شاقّة، تحتاج إلى السفر والانتقال، وإلى الصلابة والصبر على أذى الناس، وهي مهمة أليق ببنية الرجال من بنية النساء، سواء لتفوّق قوّتهم الجسمانية التي أرادها الله، أو لصلابة مشاعرهم في الغالب الأعم، مما جعلهم بشكل فطري الجنس المختار للقيادة، والقيادة وظيفة وليست تشريفًا، ولم ينظر أحد من الأنبياء أو أئمة الصحابة إلى القيادة باعتبارها تشريفًا وتكريما، بل مسؤولية ثقيلة. النفس المغترّة بالشيطان وحدها هي التي ترى القيادة ميزة وتشريفًا.
(4)
“العلماء ورثة الأنبياء”، لهم مثل ما للأنبياء من مهمات الدعوة والكد ومخالطة الناس والصبر على أذاهم. وكان أول العلماء المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم رجالا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة، حملوا من صفات القوة والصلابة النفسية والصبر على الملمّات ما أهّلهم لحمل أمانة العلم أكثر من نظيراتهم من النساء، اللاتي كنّ مبتليات بالضعف والانشغال بالحمل ورعاية البيت والأطفال، ومع ذلك برز من بينهنّ عالمات فاضلات كعائشة أم المؤمنين ومن سار على دربها، ليكنّ الإجابة الناصعة الواضحة التي تفنّد مقولة التفوّق العلمي لدى الذكور لكونهم ذكورا، وليرتبط “الاختصاص” العلمي والقيادي بالوظيفة الاجتماعية المرتبطة هي الأخرى بالبنية البيولوجية والنفسية.
(5)
إن ارتباط العلم بالحركة والسياسة والاجتماع هو الذي جعل معظم العلماء رجالا، فالحركة نحو الخارج المليء بالأذى والمخاطر تحتاج إلى بنية جسدية ونفسية قوية توفرت لدى الرجل في أصل خلقته ولم تتوفر بنفس القدر لدى المرأة. ولكن هذا ليس كل شيء، فالتكاليف الشرعية التي كلّفت الرجل بالإنفاق، وأوجبت عليه حضور المساجد والجمعات، جعلته منتميا إلى الحيّز الخارجي الذي يؤهّله للعلم والاشتهار به ومخالطة الساسة من رعاة العلماء أكثر من المرأة.
(6)
ولكن هل الخارج أفضل من الداخل؟ إنّ النظرة المادية الاستهلاكية هي التي جعلت “الخارج” أفضل من “الداخل”، و”العلوم” أفضل من “التربية”، والكتابة والتأليف أفضل من الرعاية والتنشئة، وإلا فبمعيار القيمة التي يحددها الوحي يصبح الداخل مصنع الرجال وغذاء القلوب المرتبطة بالله، وتكون التربية أشرف من علوم تخترق الكون والذرة ولكنها تبعد بالإنسان عن معنى وجوده وقيمة حياته.
(7)
إنّ اللاتي يتساءلن اليوم: هل الفقه الإسلامي فقه ذكوري؟ يتجاهلنَ كل هذا السياق والصيرورة الطبيعية لهذا الوضع. ويتجاهلن أنّه حين أتيح للمرأة في فترات من التاريخ الإسلامي أن تكون عالمة في الدين، كما أتيح في العصر العباسي والمملوكي بوفرة، برزت من النساء عالمات جمعنَ بين حضورهن الداخلي في المنازل ودفء الأسر، وبين الحضور العلمي اللافت، بل تلقّى كبار العلماء عنهنّ العلم دون أن تصدر مقولة تعترض على ذلك أو تشعر بالحرج. فالحرج من غلبة الذكور على العلم أو الحرج من الدراسة على أنثى هو حرج معاصر، ملوّث بما غزانا من الغرب من أفكار لا تمتّ إلى سياقنا العربي والإسلامي بصلة.
(8)
إنّ النظر إلى جنس صاحب العلم ومن ثم افتراض تأثيره على علمه وتحيّزه ضدّ الجنس الآخر ليس مسلكًا علميّا شريفًا. ولكن يمكن القول إن الآفاق المادية والوسائل المتواضعة التي أتيحت للمرأة في العصور القديمة هي التي جعلتها تضمر في مضمار العلم والفكر، وربما هي التي ولّدت بعض الهفوات لدى بعض الفقهاء، ولكن هذه الهفوات ليست هي كل الفقه، ولم يزعم أحد أن الفقه كان خاليا من الخطأ والزلل، بل داخله التعصّب والهوى والجدل والمراء كما نصّ أئمة الفقه قديما، فاعتورته أخطاء وزلات كالتي تعتور كل اشتغال علمي مشتبك بالمجتمع وقضاياه. وجزء من هذه الأخطاء مرتبط بالتقاليد الشعبية المتوارثة غير المنقولة عن الوحي، وهي ليست مختصّة بالمرأة وإن كانت النظرة إلى المرأة جزءًا منها. ولهذا فلم تكن ذكورة الغالبية الساحقة من الفقهاء سببا في الانحياز للذكور ضدّ الإناث. بل إن لفظ “الانحياز” هذا لفظ موهم، فكثيرا ما يكون الأمر تقريرا لأحكام شرعية جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، ولكن لأنّها تعطي للذكر شيئا مختلفا عما تعطي للأنثى، صارت عند من يتّخذ “المساواة” المطلقة معيارًا للنظر “انحيازا”، ولكنها في حسّ من اتخذ عدل الله وحكمته معيارًا “اختصاص”، قرّره الحكيم العليم، الذي يحكم بما يشاء في خلقه الذين لو شاء لتركهم على العدم الأول ولم يجعل منهم ذكرا ولا أنثى!
(9)
افتراض “المساواة” هو اللوثة التي “لطشت” عقول بعض النساء والرجال في عصرنا هذا، فجعلتهم يرجون المساواة الاجتماعية بين الجنسين في كل شيء، وتنكّرت لكل اختلاف بيولوجي ونفسي بينهما أدى إلى الاختلاف في الدور الاجتماعي. ولم يلتفت هؤلاء إلى أن هذه اللوثة هي ذاتها التي جعلت القوم في الغرب يبتغون المساواة البيولوجية، فاعتدوا على فطرة الله التي فطرهم عليها، وزعموا أنهم هم – لا الله – من يقرّرون جنسهم البيولوجي، فالذكورة والأنوثة لم تعد “كيانا جبريا” بل هي عندهم “كيان اختياري”. وهو عدوان أتباع الشيطان على الله الخالق الحكيم، يتمرّدون فيه على خلْقه كما تمرّدوا على أمره، ومن تمرّدوا على أمره منطلقون من المنطلقات نفسها ولكن لا يفقهون!
(10)
عود على بدء: خلقَ الله العالم والإنسان، وجعل منه الذكر والأنثى، وجعل لكلّ منهما خصائص بيولوجية ونفسية تختلف عن الآخر مع جوهر مشترك، وامتازت وظائفهما الاجتماعية بتميّز هذه الخصائص، ولم يجعل لأي منهما شرفا زائدا عن الأخرى، بل جعلهما بخصائصهما البيولوجية والنفسية والاجتماعية متكاملين، محتاجًا كلّ منهما إلى الآخر، فهما من جملة هذا العالَم، والاحتياج صفة أساسية من صفة المخلوقين، والله هو الغنيّ. هكذا شاء العلي القدير بحكمته، فلا اعتراض عليها ولا رادّ لقضائه.
المصدر: رابطة العلماء السوريين