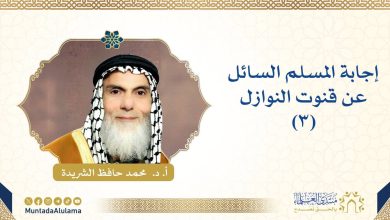مجتمع بلا إسلاميين.. الصراع على الأخلاق والهيمنة في مصر
إعداد شريف مراد
في ظرف سنين معدودة، هزّ التيار الإسلامي في الداخل المصري تحوّل واسع طال حتى قدرته على التعبير عن أفكاره، فضلا عن ممارسة العمل السياسي، فبعدما كان الإسلاميون، على امتداد أطيافهم، يهيمنون على مساحات واسعة داخل الاجتماع السياسي والأيديولوجي المصري، وينتصرون في الكثير من المعارك الانتخابية التي اشتركوا بها، تحوّل التيار في سنين معدودة إلى أقلية يمكن وصفها بالمنبوذة داخل المجتمع ذاته الذي هيمن عليه.
يمكنك مثلا، ودون الحاجة إلى كثير تدقيق، ملاحظة تحوّل “المحافظين” اجتماعيا إلى مواد للتنمر والسخرية داخل المجال الافتراضي تحديدا، والذي بات بحكم انتشاره وتأثيره -مواقع التواصل- جزءا لا ينفصل عن المجال العام، وهو المجال العام الوحيد لدى المصريين نظرا للظروف السياسية الحالية. وغدا ملحوظا بشدة لدى قطاع واسع من شباب الإسلاميين، الذين ما زالوا مخلصين لرؤيتهم الإسلامية للعالم، أنهم يشتكون من شدة تبدّل الواقع حولهم وشعورهم بالضغط والرفض الاجتماعي على إثر ممارسات كانوا منذ سنوات قليلة يمارسونها بمنتهى الأريحية، كالقوافل الدعوية وتوزيع المنشورات وإقامة الفعاليات الدينية، بل والعمل على إقناع من حولهم داخل المساحات الطلابية والثقافية الشبابية برؤيتهم وأفكارهم؛ ليندهش هؤلاء الشباب من أبناء التنظيمات الإسلامية الضخمة الغابرة ولسان حالهم: كيف آلت الأمور إلى ما آلت إليه؟ كيف أصبحنا غرباء إلى هذا الحد، فجأة؟
ليس الحديث هنا عن القمع والتضييق الأمني الذي وإن طال الجميع فإن الإسلاميين بالفعل لهم نصيب الأسد فيه، بل عن فقدان المحيط الاجتماعي الذي كان يُشعرهم بالأريحية والطمأنينة والإحساس بالقبول وسط المجتمع، خاصة وسط الأجيال الشبابية والشرائح والطبقات الاجتماعية التي اعتاد الإسلاميون الوجود والتأثير فيها. يقودنا هذا التبدل الاجتماعي، والتبدل في الذهنيات، الحاصل في مصر للعديد من الأسئلة، أهمها: كيف وصل الإسلاميون إلى هذا الانتشار المجتمعي الضخم، وكيف فقدوه في فترة قياسية، وما أسباب هذا التحول، وإلى أي مدى تكون الدعوة إلى الأخلاق والتدين هي محاولة للهيمنة الاجتماعية والأيديولوجية؟
في نهاية التسعينيات، كان المفكر والمؤرخ الاقتصادي جلال أمين قد انتهى لتوّه من كتابة كتاب “ماذا حدث للمصريين (1945-1995)”، والذي سيصبح أشهر المؤلفات في مسيرته الطويلة من الكتابة والتأليف. جاء الكتاب في شكل استعراض تاريخي وبانورامي لتحوّلات الثقافة والاجتماع في مصر خلال نصف قرن تقريبا، تكلّم فيه جلال عن الكثير من الأحداث التي جرت في مصر تقريبا، عن السينما والفن، وعن التحولات في الريف والمدينة، عن الحراك الاجتماعي والطبقي داخل المجتمع، والثقافة الشعبية، واختلاف أشكال التدين، وصولا للتحولات السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر في مختلف جوانب الحياة التي طالت المجتمع خلال خمسين عاما.
وخلال العقود التي تلت، ومنذ بداية السبعينيات تحديدا، رُسمت تلك الحدود الثقافية -والطبقية في الآن ذاته- بدقة، فما كان يجوز في الطبقات العليا للمجتمع، سواء في العلاقات والأفكار أو المواقف الذاتية من الدين، فإنه يُسمى انحلالا وانفلاتا أخلاقيا يجب التبرؤ منه في الطبقات الأدنى. وعلى النقيض، فإن ما يمكن وصفه باعتباره تصرفا مستقرا عليه، وعُرفا داخل الطبقات الوسطى والدنيا، فإنه ربما يعد من أشكال عدم اللياقة الاجتماعية أو بوصفه ثقافة رجعية متخلفة داخل الشرائح العليا.
هذان الحالان اللذان تم وصفهما آنفا إنما يُعبّران عن شكل من أشكال الاتفاق الضمني وتقاسم المساحات والنفوذ بين الإسلاميين من ناحية وبين النخبة المصرية الحاكمة التي نفضت يدها من المجتمع من ناحية أخرى، تزامنا مع تراجع القومية العربية وأيديولوجيا التحرر الوطني التي هيمنت على المجتمع لعقود، وبحلول التسعينيات كان الإخوان المسلمون تحديدا قد هيمنوا بالفعل على مساحة واسعة من المخيال الاجتماعي والأخلاقي للطبقة الوسطى المدينية وامتداداتها داخل الأقاليم الريفية بشكل ربما لم يتوفر لأي حركة أيديولوجية من خارج السلطة في العالم داخل أي مجتمع إلا نادرا(1)، سجّل جلال أمين تلك الملاحظات في أواخر التسعينيات، تحديدا في العام 1998.
وبالفعل؛ كان المشهد العام في مصر خلال حقبة التسعينيات هادئا بشكل يكاد يبعث على الملل، حالة مَوات ثقافي واجتماعي تكاد تكون شاملة، وطفا على السطح شكل من أشكال السعادة والوطنية الساذجة، وبدا الجميع في مصر مطمئنين لهذا النوع من التواطؤ الضمني -الأمني في جوهره- وتقاسم المساحات والهيمنة والنفوذ على المجال العام في مصر، ولم يعكر صفو هذا التواطؤ العام سوى مشاهد الدم والتفجيرات الآتية على استحياء في نشرة أخبار التاسعة تحت شعار الحرب على الإرهاب جراء المواجهة الدموية التي تخوضها الدولة ضد الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد في أقصى صعيد مصر.
لكن في عُمق المجتمع كان يجري حراك اجتماعي من نوع آخر، فمنذ منتصف الثمانينيات وحتى بداية الألفية الثانية -كما يوضح الدكتور عبد الخالق فاروق(2)– أخذت العديد من شرائح الطبقة الوسطى في مصر تستفيد من تحقيقها تراكما في الفوائض المالية الناتجة عن موجات الهجرة والعمل بالدول الخليجية والفرص الاقتصادية التي خلقها الانفتاح الاقتصادي وفرص العمل الجديدة مع دخول الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية داخل مصر، وربط الاقتصاد المصري بالسوق العالمي، الأمر الذي أدّى -مع استمرار هذا الحراك لفترة زمنية معتبرة- إلى ظهور شرائح جديدة هي الشرائح العليا للطبقة الوسطى خارج مساحات النفوذ والهيمنة في المجتمع القديم.
وطوال فترة الثمانينيات والتسعينيات وأوائل الألفية، راكمت تلك الشرائح فوائض مالية مكّنتها من تأمين وضعها الاجتماعي والطبقي، مما كان له أبلغ الأثر في الانتعاش الذي شهده السوق العقاري مطلع الألفية، وقيام مدن وأحياء جديدة كانت القبلة العمرانية الجديدة للشرائح العليا الصاعدة من الطبقة الوسطى. كان جيل الأبناء من هذه الشرائح الاجتماعية الصاعدة هم الوقود الأساسي للحراك الاجتماعي الذي ستشهده مصر في السنوات اللاحقة بعد نشر جلال أمين لكتابه؛ فئات شبابية تبحث عن خيال اجتماعي جديد وأنماط حياة أكثر حداثة وليبرالية دون ممارسة قطيعة أو عزلة طبقية وثقافية مع عموم المجتمع، بحكم تموضعها داخل الطبقة الوسطى، أي في قلب المجتمع بالأساس.
واستفادت تلك الفئات من الارتفاع النسبي للدخل الذي حققه الجيل السابق من آبائهم وذويهم، ومن الفوائض المالية التي تراكمت إثر العمل بالخارج وفي القطاع الخاص، في الحصول على تعليم جيد متميز عن التعليم الرسمي الحكومي التقليدي، تعليم منفتح على العالم، سواء في المدارس الأجنبية التي انتشرت بالتوازي مع الصعود الاجتماعي الذي حققته تلك الشرائح، أو في الأقسام الجامعية المتميزة والجامعات الأجنبية كالجامعة الأمريكية والألمانية والمنح التعليمية المختلفة، مما مكّنها من تحقيق السبق في الاستفادة من ثورة الاتصالات العالمية والتميز في استخدام أحدث التقنيات وخلق هامش واسع للتصرف بحرية والتعبير عن آرائها وأفكارها ورؤيتها لذاتها، بل وتنظيم نفسها بشكل جيد، فضلا عن الانفتاح على العالم والثقافة الغربية(3).
وقفت تلك الفئات الاجتماعية الشابة في المسافة بين الإعجاب بمهاراتهم العلمية والحركية ورغبتهم في أنماط حياة جديدة تناسب تلك المهارات من جهة، ومحاولة التواصل مع مجتمع مغلق على انسداد سياسي واجتماعي عميق وجذري، واستطاعت بفضل ديناميكيتها وفعاليتها السياسية والاجتماعية إشعال بوادر حراك سياسي وثقافي بشكل لافت منذ نهاية التسعينيات وبداية الألفية، تمثّل في قيامها بدور رائد في إنشاء صحف مستقلة عن الدولة ولها أقسام أجنبية تخاطب الرأي العام العالمي، ومنظمات مجتمع مدني لها علاقات بمؤسسات دولية وعالمية، وحركات شبابية احتجاجية لها علاقاتها عبر العالم، وخلقت نجومها ورموزها ومفكريها، وشكّلت خلال كل ذلك وسطا ثقافيا ليبراليا غاضبا، كان أشبه بمساحة تجنيد سياسي وأيديولوجي ضد نظام حسني مبارك في سنواته الأخيرة، وكتتويج لهذا الحراك أسست علاقات قوية بالمؤسسات الدولية الحقوقية والإعلامية، وشكّلت ضغطا سياسيا على النظام، وجدّدت شكل المعارضة السياسية والاحتجاج ورفعت سقفهم إلى مستويات لم تكن موجودة قبل ذلك.
في أحد المؤتمرات للحزب الوطني عام 2009، سُئل جمال مبارك، عضو لجنة سياسات الحزب الحاكم حينها ونجل الرئيس، عن مدى تواصله مع حركات المعارضة الجديدة مثل 6 أبريل وحركة كفاية وعموم الشباب من النشطاء والمدونين على الإنترنت في المنتديات ومواقع التواصل، لم يجب نجل الرئيس واكتفى بالضحك استخفافا بسؤال الصحفي الشاب، كان جمال مبارك كسائر رجال الحزب الوطني غافلين تماما عن الحراك الاجتماعي الحادث خارج المجتمع القديم الذي وصفه جلال أمين في كتابه والذي تشكّل من خلاله كل وعيهم بالاجتماع السياسي المصري، فهو لا يعرف سوى الجماعات الدينية المسلحة في الصعيد والإخوان المسلمين في مُدن وجه بحري ومدن الدلتا وشمال الوادي، ونُخب المال والسياسة في دوائر السلطة، حتى فوجئ الرئيس الموعود في الشهر الأول لعام 2011 بثورة شعبية انطلقت أساسا من الحركات الشبابية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ثورة هي ابنة الحراك الاجتماعي الذي قد بدأت ثماره في النضج بعد سنوات قليلة من إصدار جلال أمين لكتابه الشهير، ثورة المجتمع الجديد الذي كان في مرحلة التشكّل على المجتمع القديم، المُقسّم طبقيا وأيديولوجيا بشكل سُلطوي والغارق حتى الثمالة في مَواتٍ سياسي واجتماعي مُزمن.
“القديم ينهار والجديد لم يُولد بعد، وفي هذه الأثناء تكثر الوحوش الضارية”
(أنطونيو غرامشي)
قبل الثورة، كانت البوادر السياسية لهذا الحراك الاجتماعي وصعود شريحة اجتماعية جديدة لديها طاقة شبابية وسياسية كبيرة، وشهدت السنوات الأخيرة من حكم مبارك حراكا سياسيا كبيرا، وبدأت العديد من الأحزاب والتنظيمات والشخصيات السياسية في التنسيق فيما بينها للضغط على النظام، سواء لوقف انتهاكات وزارة الداخلية، أو دفاعا عن استقلال القضاء، أو لمنع عملية التوريث، وغير ذلك، ظهرت حركة كفاية وحركة 6 أبريل المعتمدة على شباب الطبقة الوسطى بشكل كامل، وصولا إلى حملة دعم البرادعي التي أسّسها شباب ليبرالي ملتف حول شخص البرادعي، بالتزامن مع كل ذلك شكّلت شريحة من شباب الإخوان المسلمين قنوات اتصال وتنسيق بين تلك الحركات والحملات الجديدة وبين تنظيم الإخوان نفسه، كان هؤلاء الشباب هم المجموعات التي ستنشق عن الإخوان المسلمين فيما بعد وتتفرّق في كيانات شبابية كحملة المرشح عبد المنعم أبو الفتوح وحزب مصر القوية وحزب التيار المصري ائتلاف شباب الثورة.
ما ميّز هذه المجموعات عن غيرها من عموم شباب الإخوان أنهم في غالبيتهم العظمى كانوا من الشرائح العليا داخل الطبقة الوسطى (لا عجب أن إحدى أكبر الشُّعب التي حدثت فيها الانشقاقات في الإخوان كانت في شُعب مدينة نصر والأحياء الجديدة في القاهرة والإسكندرية والمنصورة، المعقل الرئيسي للشرائح العليا من الطبقات الوسطى(4)، فهم من حيث الموقع الطبقي والمخيال الاجتماعي أقرب لغيرهم من شباب الحركات الاحتجاجية ذات السمت الليبرالي عن أقرانهم داخل تنظيم الإخوان المسلمين، وهو ما ظهر جليا في كل الكيانات السياسية التي شكّلوها بعد انشقاقهم من الإخوان. كان انشقاق هؤلاء الشباب تحديدا وتقاربهم مع غيرهم في جيلهم نفسه أكبر دليل على طبيعة المرحلة التي تلت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ مرحلة الوحوش الضارية.
في الفلسفة السياسية يبزغ اسم الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي كواحد من أكثر المساهمين في إثراء الفلسفة السياسية الحديثة، وأحد المفاهيم السياسية التي صكّها غرامشي هو مفهوم الهيمنة، الهيمنة -باختصار مخل- هي انتشار تصورات وأفكار ومعايير طرف سياسي ما خارج قواعده ودوائره الأساسية لتُهيمن على قطاعات واسعة من المجتمع، قد يكون هذا الطرف السياسي طبقة أو تحالفَ طبقات أو نخبة حاكمة أو تنظيما أيديولوجيا معينا أو حتى الدولة نفسها، المهم هنا أن هذا الطرف نجح في جعل انحيازاته الفكرية والسياسية بل والأخلاقية وتصوّراته ومصالحه هي المعيار الحاكم، وهو ما يحقق له الهيمنة؛ التي تتجدّد بقدر نجاح صاحبها في إعادة إنتاج هيمنته وتسييد تصوراته كمعيار حاكم في المجال العام، بالاستمرار مع غرامشي وطبقا لهذه النظرية يصبح المجتمع أو المجال العام هنا هو ميدان صراع لفرض الهيمنة(5).
فكرة غرامشي الأساسية هنا أن الهيمنة تختلف عن العنف، بل أحيانا ما تكون الهيمنة نقيضا للعنف، ويكون العنف في المقابل تعبيرا عن عجز في الهيمنة. من الممكن توضيح ذلك عبر قصة صعود الإسلاميين أنفسهم في فترة السبعينيات، بداية من صعود الإسلاميين حيث كان العنف ملموسا، وهو ما يرويه العديد من قادة الإسلاميين أنفسهم(6) والعديد ممن عاصر بدايات الصحوة الإسلامية(7)، و”كيف كان شباب الإسلاميين المتحمسون يتحركون جماعات غاضبة في مجتمع علماني، مجموعات في الجامعة أو في النوادي أو المقاهي، ليغيروا بأيديهم ما يرونه منكرا لا يجب السكوت عليه”، مع الوقت كما أسلفنا -اعتمادا على طرح جلال أمين- كانت الطبقة الوسطى تتشرب قيم الإسلام السياسي ورؤيته لما يجب أن يكون عليه المجتمع السليم ومعايير التفاعل داخل المجال العام، فتحققت الهيمنة للإسلاميين كما وضّحها غرامشي، ومع الوقت أيضا خفت “العنف الإسلامي” وصولا إلى تلاشيه التام في التسعينيات؛ وهو وقت الهيمنة التاريخية للإخوان المسلمين على المجتمع.
تشعر ليلى حبيبة خالد بالاختناق في المدينة، تريد أن تهرب إلى الخارج لتتخلص من ذلك الشعور الدائم بعدم التحقق والعجز عن التعبير عن نفسها في شوارع تكاد تتربص بها، أما حنان التي تُدير ورشة للتمثيل فإنها تهرب إلى “نوستالجيا” الحنين إلى الإسكندرية التي عرفتها في طفولتها، والتي ربما لم يعد لها وجود الآن. تظهر على امتداد لقطات الفيلم شخصيات شابة متحررة نوعا ما، لها سمات ثقافية واجتماعية متشابهة وتشترك جميعها في حدّة الشعور بالاغتراب عن المدينة التي كانت لهم ولم تعد كذلك، نرى خالدا خلال تجواله في وسط القاهرة بحثا عن سكن -وهي العقدة الدرامية الرئيسية في الفيلم- سواء كان سائرا في الشوارع أو في المواصلات يصطدم دائما بمظاهر تملؤه بالضيق، سواء في صورة تشكيلات الأمن المركزي والشرطة والشوارع المغلقة لأغراض أمنية والمخبرين الفضوليين الموجودين في كل مكان، وكذلك عبر الشوارع المغلقة لإقامة الصلوات والملصقات الإسلامية الموجودة في كل مكان تقريبا، في الشوارع، على أعمدة الإنارة، وواجهة المحلات، في المباني والمصاعد والمواصلات العامة؛ يشعر خالد وليلى وحنان، ونشعر معهم كمشاهدين، بحالة من الاختناق والحصار.
حيث تبدو القاهرة خلال الفيلم ضيقة جدا، في انتظار وقوع انفجار كبير يحطم هذا الضيق والحصار، ويزرع برعما لحياة أخرى جديدة، يلمس الفيلم تلك الثورة الكامنة في الصدور التي كانت قد تراكمت في المدينة، ويرصد كل مظاهر هذا الاغتراب بنظرة حزينة، ولكنه في الوقت نفسه، يرصد بدايات حركة الانعتاق التي تمثّلت في مظاهرات حركة كفاية والوقفات الاحتجاجية التي ملأت وسط البلد، والتي يشعر معها خالد وليلى أنها الشيء الوحيد الباقي في المدينة الذي يُمثّلهم وينتمي إليهم في آخر أيام المدينة.
قصة الفيلم تتمثّل في أن خالدا يُصوّر ويُخرج فيلما تسجيليا عن أشياء تبدو وكأنها لا ترتبط ببعضها بعضا، كتعبير عن فيلم تامر السعيد نفسه، الذي يبدو أيضا كما لو كان يعاني من مشكلات في السرد والبناء، لكنّ هذا البناء الذي يبدو ظاهريا مفككا وعشوائيا مقصود تماما، لا يستطيع خالد أن يكمل فيلمه، ولا يشعر بالرضا عما أنجزه، فدائما هناك شيء ناقص ما زال يبحث عنه، كأنه ينتظر إلهاما ما لا يأتي، فيُصرّ على المُضي قُدما في التصوير رغم غياب خطة واضحة لديه بخصوص ما يريده بالضبط من فيلمه، إنه يعمل ويبدو كأنه يريد تسجيل تلك اللحظات الفارقة في تاريخ المدينة التي يخنقها المجتمع القديم، قبل أن تشهد سقوطها النهائي، في نبوءة لما ستصير إليه المدينة بعد أعوام قليلة؛ وفي نهاية الفيلم، وبعد أن يئس خالد من إيجاد سكن مناسب له، يمضي في طريقه غاضبا من هذه المدينة التي لا تُوفّر له مكانا ينتمي إليه، ويقوم بإزالة كل الملصقات الإسلامية التي يجدها أمامه.
خالد البطل في الفيلم، وتامر السعيد المخرج هنا، هما نموذج للشباب المتمرد على المجتمع القديم، أبناء الحراك الاجتماعي الذي شهدته الطبقة الوسطى في الثمانينيات والتسعينيات، شباب تلقى تعليما جيدا، ويجيدون أكثر من لغة، يقدّرون الفن الحديث، ومُنفتحين على العالم، يحلمون بدولة غير بوليسية ومجال عام ليبرالي على النمط الأوروبي والأميركي، مجال عام لا يُعادي الدين بالضرورة، محايد تجاه الدين، ويفسح مكانا لغير المتدينين ليتصرف فيه الجميع بعفوية دون وصاية دينية أو أخلاقية، في الفيلم لم يجد خالد الإلهام ليكمل فيلمه ولا السكن الذي يبحث عنه، وفي الواقع لم يستطع أقران خالد وتامر السعيد تحديد ما القيم الصحيحة، أي لم ينجحوا في تشكيل هيمنة بديلة عن هيمنة الإسلاميين ولا النظام السياسي الذي يريدون بدل النظام الأمني لمبارك، كانت تلك الشرائح الشبابية الواسعة والفعّالة سياسيا واجتماعيا الوقود الأساسي وأصحاب المصلحة الحقيقية في قيام الثورة، والتعبير المثالي عن أزمتها بالقدر نفسه، ثورة تدرك جيدا كل ما لا تريده، وعاجزة تماما عن تحديد ما تريده، وعن مد هيمنتها ومعاييرها الأخلاقية على المجتمع.
حملت لحظة الخامس والعشرين من يناير بذور فنائها داخلها، حيث رفعت شعارات علمانية لا تُعادي الدين إطلاقا مثل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكان الإخوان المسلمون في صلب الحراك، إلا أن خطابهم كان مضبوطا بالحراك الديمقراطي أكثر من كونه ضابطا له، فالفاعلون الأساسيون في الثورة -تنظيم الإخوان والقوى الشبابية الجديدة- كانوا يهتفون في ميدان واحد وفي ذهن كلٍّ منهم عالم مختلف تماما عن العالم الذي يحلم به الآخر، حيث رأى الإخوان في عالم ما بعد الثورة أنه عالم تكتمل فيه هيمنتهم الأيديولوجية بهيمنة سياسية ومادية حقيقية يكونون فيها على رأس الدولة التي عانوا في سجونها ومعتقلاتها سنين طوالا، ورأت القوى الشبابية في عالم ما بعد الثورة عالما ليبراليا أوروبيا تنكسر فيه الثنائية التي وصفها جلال أمين في كتابه، ثنائية دولة النخب البوليسية والإخوان، لصالح دولة الحقوق والحريات بشكلها الليبرالي، دولة يكون فيها الإخوان والقوى الشبابية والنخبة تحت نظام سياسي ديمقراطي تعددي وقضائي عادل.
ومثل جمال مبارك ونظامه، لم يفهم الإخوان الحراك الاجتماعي الذي شاركوا في محطته الأخيرة، بل إن مشاركة الإخوان بشعارات الحراك وتحت خطاب القوى الشبابية الليبرالي كان اعترافا غير واعٍ بتراجع هيمنتهم لصالح اللاعب الجديد الذي بدأ في فرض نفسه بقوة، “لم يقدم الإخوان ولا الإسلاميون عموما أي منتجٍ أيديولوجي مرتبط بالثورة، الحدث الرئيس في مصر، لا خطاب ولا قيم معبرة عنها، لا كتب ولا أغانٍ ولا مقالات ولا رموز سياسية مؤثرة ولا مفاهيم جديدة مرتبطة بالواقع الجديد، فالثورة وميدان التحرير لم تكن يوتوبيا الإخوان والإسلاميين بشكل عام (خطاب غير إسلامي، اختلاط، وانفتاح في المعاملة بين الشباب والبنات) كل هذه مظاهر ليبرالية نجحت في انتزاع القبول الاجتماعي العام”(9)، صحيح لم ترقَ لتكون معيارا حاكما، لكنها تعبير واضح عن تراجع الهيمنة الأخلاقية والأيديولوجية للإسلاميين وبزوغ خيال اجتماعي جديد، نمط حياة مختلف، يمكن أن ينمو ويهيمن ويفرض نفسه إذا هُيّئت له الظروف.
كانت الثورة إذن تعبيرا عن رغبة شريحة اجتماعية واسعة نمت وتطورت كفاعل اجتماعي وسياسي خارج شبكات الهيمنة وتقاسم النفوذ القديمة، شرائح لديها طموحات سياسية واجتماعية وتطمح إلى كسر العزلة السياسية والطبقية التي فرضتها الدولة على نفسها، وتملك مخيالا اجتماعيا جديدا منفلتا من الهيمنة القديمة، وتحاول بلورته واكتشافه وبناءه في حراكها السياسي والاجتماعي، وهي ثورة الشرائح الشبابية الجديدة على المجتمع القديم بكل مكوناته، وكأي ثورة هي في جوهرها رغبة في هدم وترك القديم وتحمل في داخلها أفكارا أولية عن المجتمع الجديد، لكن كيف ينشأ هذا المجتمع الجديد؟
في كتابه الفذ “الجماعات المتخيلة”، يوضح بدنكت أندرسن كيف لجماعة من الناس يتشاركون في الزمان والمكان أن يتحولوا إلى جماعة متخيلة ثم إلى جماعة مادية لها منتجاتها المادية والأيديولوجية من مؤسسات تجسّدها كجماعة قائمة واعية بذاتها، ورموز وخطابات تُضفي المعنى والهوية والمخيال الجمعي وأشكال الوعي المختلفة على هذا التجمع البشري وتصبح أهم مصادر الشرعية ورأس المال الرمزي للفاعلين السياسيين والاجتماعيين داخل المجتمع، ثم يستدرك أندرسن موضحا أن هذه العملية -عملية خلق الرموز والمعنى والهوية والمخيال الاجتماعي ومصادر رأس المال الرمزي- لا تخلو بدورها من عمليات هيمنة وصراعات وتفاوض وإقصاء إن لزم الأمر، مؤكدا أنها هي عينها ساحة الهيمنة التي نظر لها غرامشي في منتصف القرن الماضي، فلكي يتحول أشتات الناس إلى مجتمع لا بد من هيمنة ثقافية وأيديولوجية ما، تربط الناس في رباط رمزي وثقافي واحد يكون بمنزلة عقد اجتماعي بين مكونات المجتمع المختلفة.
كانت حركة الثورة والمجتمع، خصوصا في المدن الرئيسية القاهرة والإسكندرية والمنصورة، علاقة حراك اجتماعي وثقافي واسع بين الحركات الثورية والفنية والفكرية وبين الميدان والفعل الثوري. فالشبكات الشبابية الجديدة التي خرجت من رحم الثورة والحراك الاجتماعي السابق عليها باتت تتواصل وتتشابك في حركة ممتدة من الإبداع والتجديد، أخذ يتجلى في توسّع الأعمال الفنية والثقافية المستقلة: انتشار أنواع مختلفة وجديدة من الفرق الغنائية بعد أن كانت معروفة بشكل ضيق في دوائر بعينها، وجود زخم شديد في حركات المجتمع المدني والتنمية، الأفلام القصيرة والحملات الحقوقية كحملات مقاومة التحرش، محاولات السينما المستقلة والمسرح، الحركات الاجتماعية الجديدة بما فيها المطالب الفئوية، الازدياد الضخم في مجموعات الكُتّاب والصحافيين والنشطاء والمثقفين الشباب الذين يحاولون تقديم جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى من خلال مواقع ومنصات الصحف الجديدة، حيث يقدمون نوعا آخر من الصحافة والكتابة أكثر استقلالية وحرية وإبداعا(10). وعلى النقيض تماما يمكن بسهولة ملاحظة أن الإسلاميين والإخوان تحديدا لم ينتجوا أي منتج أيديولوجي أو محتوى خطابي طيلة فترة الثورة، لا دعاة جدد ولا رموز ثقافية وفكرية ولا نقاشات فكرية معتبرة لها التأثير نفسه لرموزهم ودعاتهم وخطابهم وقت صعودهم وهيمنتهم.
وبالعودة لغرامشي، فإن استمرار أي هيمنة مرهون أساسا بقدرة الأطراف أصحاب المصلحة في هذه الهيمنة على إعادة إنتاج الشروط نفسها التي خلقت هذه الهيمنة من الأساس، ما يلخصه ألتوسير بقوله: “لا يمكن أن يحدث إنتاج للهيمنة لا يتضمن إعادة إنتاج الظروف المادية لإنتاج الهيمنة ذاتها: إعادة إنتاج وسائل الإنتاج”، نجحت الثورة والشرائح الاجتماعية الشبابية التي وقفت وراءها في كسر قدرة المجتمع القديم على إعادة إنتاج نفسه، بتحطيم قدرته على إعادة خلق شروط وجوده نفسها مرة أخرى، سواء لأدوات هيمنته الاجتماعية أو حتى لشروط قابلية هيمنته، عملية الثورة الثانية كانت في خلقها خيالا اجتماعيا جديدا ينافس خيال الإسلاميين، خيالا اجتماعيا للصواب والخطأ كان معياره في السنين الأولى الثورة نفسها كقصة كبرى بديلة عن سردية الإسلام السياسي والخلافة والشريعة، ثم أصبح المعيار الحرية والليبرالية في شكله وتجليه النهائي.
| الفيلسوف الإيطالي “أنطونيو غرامشي” أحد أكثر المساهمين في إثراء الفلسفة السياسية الحديثة (مواقع التواصل) |
ليس هذا الخيال الاجتماعي الوليد علمانيا معاديا للدين بالضرورة، لكنه أصبح أكثر علمانية مع تطور الصراع السياسي والاجتماعي الحاصل بعد الثورة ومع الاصطدام العنيف بالإسلاميين، فالرغبة في مجتمع جديد تتطلّب خيالا جديدا، وهو ما لم يتوافر لدى الإسلاميين الذين لم يستطيعوا تجديد هيمنتهم الاجتماعية في مرحلة ما بعد الثورة، وكانوا عقبة أمام الهيمنة الجديدة، و بالاستمرار في الصراع السياسي ووجود الإسلاميين في السلطة دون إصلاحات حقيقية تلبي مطالب الثورة التي رفعها الإسلاميون أنفسهم، كان المكوّن المحافظ يتراجع بشكل حاد لصالح نزعة تحررية مجتمعية أكثر وضوحا، نزعة تحررية شكّلتها بقدر كبير المواجهة مع الإسلاميين المحافظين اجتماعيا بطبيعتهم، نزعة منفتحة على حياة مختلطة ليبرالية، وتفكير نقدي يزداد حدّة تجاه الدين، وانفلات لغوي صريح بات ظاهرة اجتماعية عامة، وجرأة واضحة تجاه الجنس والعلاقات العاطفية، وخروج قضايا للعلن لم تكن لنسمع عنها وقت هيمنتهم كقضايا المثليين والشواذ جنسيا، كل هذا مع استمرار دخول أجيال جديدة يتشكّل وعيها بعيدا عن الصخب الإسلامي من البداية(11)، ليشعر شباب الإسلاميين فجأة أنهم في مجتمع جديد غير المجتمع الذي عرفوه وعاشوا فيه بل وتميزوا على أقرانهم من خلاله وبفضله في السابق، لتعود أنشودة “غرباء” أنشودة الإسلاميين الأثيرة للعزف من جديد على أوتار المحنة الجديدة والوحدة الأبدية.
(المصدر: ميدان الجزيرة)