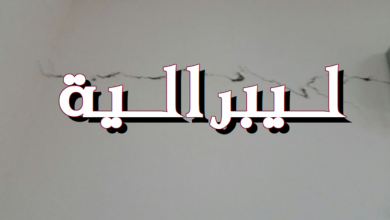بقلم مدحت القصراوي
معصيةُ الله تعالى خطر على الإنسان، ينظر إليها المؤمن كأنه في أصل جبلٍ يخشى أن يقع عليه؛ كما قال عبدالله بن مسعود.
وأصلُ شرور العالم من المعاصي والذنوب؛ قال تعالى: ﴿ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ [الأنعام: 6].
والمعصية في ذاتها مخالَفةٌ وسيئة، وقد تتغلَّظ بالمجاهرة، أو الإصرار، أو الاحتيال، أو التسبُّب في معصية الغير، أو تقليد الغير لها؛ قد تتغلَّظ بأحد هذه الأمور أو بعضها أو كلِّها.
يدخلُ في هذا الكثير؛ ومثاله: تبرجُ المرأة، وكذا الإعلاميُّ المنحرفُ عظيم التأثير، واللصُّ المليونير، والملياردير المنحرِفُ المتسبِّبُ في إفقار الآلاف، والمغنِّي أو المغنِّية الفجَّار العراة الذين يقولون فحشًا، أو يخاطبون الغرائز…
وهنا ندرك حُمْقَ مَن يطلب الشُّهرة في المعصية، ويعظم تأثيرُه؛ فيقتل بكلمته آلافًا، ويضلُّ مَلايين، ويغوي مثلهم، أو أقلَّ من ذلك، أو أكثر!
كلُّ هذه المعاصي في إطار الإسلام – لو خلَتْ عن المكفرات – بحيث لم يُكذَّبْ خبر الله، ولم يُردَّ حُكمه، ولم يُستحلَّ المُحرَّم، ولم يُطعَنْ في الحكمة، أو يُستهزَأ بالشريعة… فالتوبة مفتوحةٌ أمام الجميع ما لم يُغرْغِرْ، ويرَ ملائكةَ ربِّ العالمين التي تأتي لقبضه.
ومَن تاب، تاب الله عليه.
والتوبةُ بشروطها مبذولة، ومن شروطها ما يغفلُ عنه الكثير؛ مثل: إصلاح ما أفسد: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا ﴾ [البقرة: 160]؛ الآية، فعالجوا كتمانَ الحق ببيانه، وعالجوا الإفساد بالإصلاح، مع الإقرارِ بالخطأ والرجوع عنه، والندم عليه، والعزم على عدم العَود.
لكن الخشيةَ والخوفَ هنا هو أن تُجرِّئ كثرةُ المعاصي صاحبَها على ما هو أشد، فكثرة المعاصي وتتابعُها (قد) تفضي – وقد لا تفضي – إلى أشدَّ منها، بحسب إدراك الله تعالى للعبد، وتوبته عليه، واستنقاذه من وَحْله.
فالمعصية تُقلِّل الخشية والخوف والتعظيم بحسبها، والجُرْأة عليها، والمداومة يجرح القلب جراحات، ويميتُ منه بحسب هذه المعصية، وقد يقف بصاحبه في أي مرحلة من أودية الهلاك المُرْدي في نطاق الفساق، أو ما بعد ذلك؛ فرُبَّ جُرحٍ قَتل صاحبَه!
قد تُجرِّئُ المعصية صاحبَها مع قلة التعظيم والخشية؛ فيقتحم ما قد يستبعدُه أولَ الطريق، ولا يظن أن يفعله يومًا! فقد تُعرض على الإنسان شُبْهة، ولضعف قلبه يَنقدح في قلبه شكٌّ أو تكذيب، وقد تُعرض عليه شهوةً لا ينالها إلا بجُرأة على المكفِّر، فيقتحمُه؛ كمَن يُعرض عليه – أو عليها – الطعنُ في الدين، أو الاستهزاء بالأحكام، أو السخرية منها في الصِّحافة أو الإعلام، أو الفن بأنواعه؛ من التمثيل، أو الرواية، أو الأغاني، أو استغلال الشهرة لتأييد العلمانية، وردِّ الشرائع…
- فهذا كلُّه شأنٌ آخر، واقتحامُ مكفِّرات جرَّأت عليها كثرةُ المعاصي، وقسوةُ القلب، وقِلَّةُ الخشية من رب العالمين تعالى.
إن القلب القاحلَ من الطاعة، والمُسلَّط تحت هجير انتهاك الحرمة، وتضييع الفريضة والجرأة على الله – كلُّ هذا يقدح في القلب، فيضل بالتكذيب أو الشك، أو يغوي القلب فيتبع الشهوات، فيتقلب بين الضلال والغضب، مخالفًا سبيل من أنعم الله عليه.
قد يُكذِّب المرء بالحقِّ، ويشك فيه؛ لا لضعفِ الدليل، أو لافتقاده – بل لخراب الآلة الناظرة في الحق؛ وهي القلب، فإنه لما كذَّب قومٌ بالقرآن وقالوا: ﴿ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [المطففين: 13] قال تعالى: ﴿ كَلَّا ﴾ [المطففين: 14] ليس القرآن أساطير الأولين، ولا هم يفتقدون الدليل، بل لأن قلوبهم خَرِبة ﴿ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: 14].
وهذا أمر مشاهَد؛ إذ إنَّ بعض الفُسَّاق يَظلُّ على حاله حتى يموت معه أصل الإيمان مع خلل في الواجب، وبعضهم: يصل به الفسقُ وطلب الفجور إلى أن يكره الشريعة التي تمنعه عن فجوره، وينتفي من قلبه تعظيمُها والاستسلام لها، وقد يوقَفُ مواقفَ فارقة كما بعد الانقلاب، فيختار صفَّ الانقلاب، لا لشيء إلا لأنه عَلمانيٌّ يمنع عنه حكم الشريعة، ويكره الإسلاميِّين ولو جلبوا له الرخاء؛ لمخافته أن يؤدي وجودُهم إلى أن تُظلِّله الشريعة وتحكمه، فلما خاف من هذا وقَف مع تبديل الشرائع؛ كراهةً لدين الله وأحكامِه، وجهلاً به، وطلبًا للفسق: ﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ [القيامة: 5]؛ فكانت ردةً صريحة، ونفاقًا أعظمَ، ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد: 8، 9].
وكلُّ هذا هو معنى كلمةِ سلَف الأمة وعلمائها: “المعاصي بَريد الكفر”؛ فهي رسولٌ نحو المكفرات؛ باجتراء القلوب وخرابها.
فليتَّقِ امرُؤٌ ربَّه، وليَرْعَوِ، وليرتَدِعْ، وليُمسِكْ عن الذنوب، وليحفظ ما في قلبه من بقية الخير، و﴿ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ﴾ [الأنفال: 23]، و﴿ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنفال: 70]، و﴿ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: 24]، و﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الحديد: 17]… صدق الله، وهو العاصم.
المصدر: شبكة الألوكة.