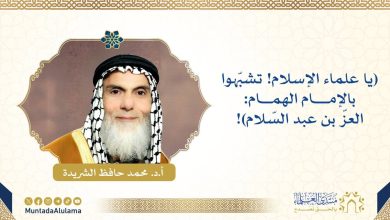بقلم حامد العطار
مع غروب شمس رمضان، تعود الحياة كما كانت على سابق عهدها من قبل، فتطوى المصاحف، وتفتر الألسنة عما كانت تلهج به من الذكر والدعاء، ويخلو القلب مما كان عامراً به من حرارة الإيمان، ويعود التكالب على الدنيا، وكأن رمضان كان طيفاً ثم ذهب! مع ذبول هذا الإيمان، تنبت الحسرة، ويتجدد السؤال: كيف نستعيد الإيمان الذي كنا عليه؟ وكيف نستبقي جذوته مشتعلة في النفوس؟
لعل أبرز صورة مقاربة لهذا المشهد هو ما رواه مسلم بسنده عن حنظلة بن الربيع الأسيدي قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة!
قال: سبحان الله، ما تقول؟
قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأنَّا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيراً!
قال أبو بكر: فو الله إنا لنلقى مثل هذا!
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما ذاك؟»، قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنَّا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»، ثلاث مرات.
وفي هذا المشهد الإجابة عن السؤال من خلال توضيح الأمور التالية:
ساعة وساعة
– لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم نزول الإيمان ونقصه عن مستواه الأعلى!
– أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن دوام الإيمان عند ذروته العليا من الأمور البعيدة على البشر، انظر قوله صلى الله عليه وسلم: “والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم”، ولم يُعهد في حياة البشر أن تصاحبهم الملائكة وتصافحهم.
– أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن دوام الإيمان عند ذروته العليا، ليس فقط مستبعداً، بل هو كذلك ليس مطلوباً طلب الواجبات، فأقر صلى الله عليه وسلم أن حياة المؤمن ساعة وساعة.
– قال في المفاتيح: “أي لا يكون الرجل منافقاً بأن يكون في وقت على غاية الحضور وصفاء القلب وفي الذكر وفي وقت لا يكون بهذه الصفة، بل لا بأس بأن يكون ساعة في الذكر، وساعة في الاستراحة والنوم والزراعة ومعاشرة النساء والأولاد، وغير ذلك من المباحات”.
رمضان أعظم مواسم زيادة الإيمان:
– وإذا كان الصحابة قد حظوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووعظه المباشر لهم، فكان ذلك أكبر سبب معين لهم على زيادة الإيمان، ومن ثم زيادة العبادات والقربات، فإننا نحن لا نحظى بهذه الصحبة، لكننا لم نحرم من دوافع لزيادة الإيمان، وعلى رأس هذه الدوافع شهر رمضان، حيث النيران مغلقة، والجنان مفتحة، والشياطين مصفدة، والطريقة مفتوحة لداعي الخير، وموصدة لداعي الشر، والفرص مواتية للإقبال على الله تعالى، فرمضان هو أكبر معين على تحقيق الساعة الأولى، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «ولكن يا حنظلة ساعة»، وما عدا رمضان هو الساعة الأخرى.
– يقول العلماء في تفسير الساعة والساعة: أي ساعة كذا، وساعة كذا، يعني ساعة في الحضور تؤدون فيها حقوق ربكم، وساعة في الغيبة والفتور تقضون فيها حظوظ أنفسكم لينتظم بذلك أمر الدين والمعاش، وفي كل منهما رحمة على العباد.
خطوط حمراء
وليس معنا هذا أننا ندعو إلى الانكباب على الدنيا بعد رمضان؛ بدعوة «ساعة وساعة»، ولكننا نؤكد أن زيادة منسوب الإيمان في رمضان أمر مشروع ومطلوب على غيره من الأيام؛ فرمضان هو أكبر موسم لزيادة الإيمان، غير أنه ينبغي مراقبة ما يلي:
– أنه إذا كانت الساعة الإيمانية الرمضانية معناها ساعة الحضور الإلهي «اعبد الله كأنك تراه»، فإن الساعة الأخرى ليس معناها الانفكاك من العبودية وإطلاق النفس من تبعة التكليف، يبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لِكُلِّ عملٍ شِرَّةٌ، ولِكُلِّ شرَّةٍ فَترةٌ، فمن كانَت فَترتُهُ إلى سنَّتي، فَقد أفلحَ، ومَن كانت إلى غيرِ ذلِكَ فقد هلَكَ» (رواه أحمد، وصححه الألباني).
ورواه أبو هريرة بلفظٍ آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لكلِّ عملٍ شِرَّةٌ، ولكلّ شِرَّةٍ فَترةٌ، فإنْ كان صاحبها سَدَّدَ أو قارَبَ فارْجُوه، وإن أُشيِرَ إليه بالأصابعِ فلا تَعُدُّوهُ» (صحيح الترغيب).
معنى الشِرَّة: أي القوة والهمة في العبادة، ومعنى الفَتْرَة: الوهن، والفتور، والضعف في العمل.
تبديد رمضان
فما دمت لم تنزل عن «السداد والمقاربة» بعد رمضان فلا تقلق، ولكن إذا نزلت عنهما إلى الوقوع في المحرمات، فاقلق القلق كله؛ لأنك حينئذ تنفق من رصيدك الذي جمعته في رمضان، أنت الآن تبدده، وتبعثره، قال صلى الله عليه وسلم: «أتدرون ما المفلس؟»، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار».
فالشتم والقذف والسب، وأكل المال بالباطل، والاستطالة على الأعراض والأبدان إنفاق من الرصيد وتعريضه للانكشاف، وربما صرت مديناً مفلساً، فتحولت من دائن إلى مدين بألفاظ الحسابات البنكية، وإن كنا نتحفظ على عبارة «دائن» فإنها لا تصح إلا بضروب من المجاز والتأويل الواسع، قال تعالى: (وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً) (النحل: 92)، فمن ذا الذي يعجبه أن يبدد هذا القيام الطويل، وذاك الصيام الشاق، فيخرج خاسراً بعد مكابدة ومكافحة لتحصيله؟!
قال ابن القيم، رحمه الله: «فتخلُّل الفترات للسالكين أمر لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد، ولم تخرجه من فرض، ولم تدخله في مُحرم، رُجي له أن يعود خيراً مما كان».
الكبسولات الثلاثون
اعلم أن الصيام لم يكن عبادة غير معقولة المعنى، بل كان تدريباً وتمريناً، للإعانة على الوصول إلى النفس الوقافة عند حدود الله، تلك النفس التي كانت تخشى أثناء الوضوء أن يتسرب مع المضمضة قليل من الماء إلى الحلق فيفسد الصيام، أصبحت الآن قادرة على ألا تضعف أمام المغريات، فسوف تجد عند سماع اللغو أن الصيام تحول إلى ثقل يسد الأذنين عن سماعه، وتحول إلى ثقل يربط الرجلين عن المشي إلى الحرام، ويتحول إلى قذى يقذي العين عن النظر إلى ما حرم الله، فإن أوصلك الصيام إلى هذه الحال، فقد نجحت في التدريب، وإلا فإن صيام رمضان مثل ثلاثين حبة من الدواء، يراد منها الحصول على مناعة وتحصين من المرض، وهذه المناعة تظهر مع انتهاء تناول الجرعات الثلاثين، فإذا وجد الإنسان نفسه لا يزال مريضاً بعد هذه الجرعات الثلاثين، كان ذلك دليلاً على أن الدواء لم يفلح معه!
(المصدر: مجلة المجتمع)