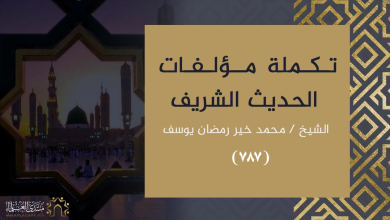في سنة 2005 ألقى الأستاذ عبد الله العروي محاضرة بالرباط حول “عوائق التحديث“، لخص فيها مشروعه الفكري، أو بعبارة أصح: حيّن من خلالها مفردات “الإيديولوجية العربية”.
وقد قام الأستاذ امحمد جبرون -ضمن كتابه “الإسلام والحداثة“-؛ بقراءة في هذه المحاضرة بعد صدورها في كتاب سنة 2006، مؤكدا بأن “الحداثة” و”الإيديولوجية العربية المعاصرة”؛ وجهان لعملة واحدة:
فالأولى: تحيل على الغاية.
بينما الثانية: تحيل على الأداة الفكرية والسياسية.
وفيما يلي قبس من نص القراءة:
“تناول الأستاذ عبد الله العروي في مستهل محاضرته مفهوم الحداثة مميزا بين المفهوم النظري وحقيقته التاريخية، وخلص من ذلك إلى أن مفهوم الحداثة يدور حول المفاهيم التالية: “الفردانية، العقلانية، الحرية، الديمقراطية، العلمية أو العلمانية”.
وهي من منظور المؤرخ: واقع تاريخي تمثل في ثورات متتالية سياسية واقتصادية ومعرفية، حدثت في مجال محدد ومعروف تاريخيا وهو الغرب الأوروبي، وقد واكبتها ظواهر مضادة لها.
ومن الأشياء التي وقف عندها العروي في هذه المناسبة: التناقضات الذاتية للحداثة؛ وقد أجملها في ثلاث: الاستعمار، والحروب، والثورة الشاملة، التي انقلبت على المفاهيم الأساسية للحداثة.
“فقد تجسدت أزمة الفردانية في الماركسية، لأنها في الأساس هي نقد الفردانية. وتجسدت أزمة الحرية في الاشتراكية. وتجسدت أزمة العقلانية في الفرويدية وغيرها. وتجسدت أزمة الديمقراطية في النظام الفاشستي وغيره. وتجسدت أزمة العلم في النظرية النسبية …”.
لكن بيت القصيد في هذه المحاضرة هو موقف العروي من الحداثة والسلبيات التي صاحبتها، ففي تقديره “لا يمكن معارضة الحداثة إلا بتجاوزها، ولا يمكن تجاوزها إلا باستيعابها”.
فلا حل لنا سوى العوم مع موجة الحداثة – على حد قوله – حتى نكون من الناجين.
وختم حديثه بذكر العوائق التي تحول دون تحقيق الحداثة في المغرب والعالم العربي، واكتفى بذكر نوعين:
الأول: عائق فكري؛ ويتمثل في معارضة الحداثة باعتبارها مروقا وتنطعا وجهالة.
والثاني: يتجلى في كل ما يعوق تحرير الفرد من مختلف التبعيات السياسية والاجتماعية العائلية.
وكان جواب الأستاذ عبد الله العروي عن الاستفسارات التي قدمها أمامه كل من الأستاذ عبد المجيد قدوري والأستاذ نور الدين أفاية، فرصة لتوضيح بعض القضايا التي بقيت غامضة أثناء المحاضرة، ومن هذه القضايا؛ قضية العقيدة والإيمان في ظل الحداثة الموعودة، فلم يغفل المحاضر في هذا التعقيب عن تبديد مخاوف المؤمنين؛ إذ أكد أن “لا خوف على العقيدة في نطاق الحداثة”، أو “لا خوف على الإسلام من الحداثة”.
وعموما، رغم إمكانات العروي التحليلية والتركيبية التي مكنته من استيعاب قضية كبيرة في محاضرة قصيرة، ويقدم خريطة إشكالاتها وتعقيداتها، فقد بقيت بعض الإشكالات الحيوية خارج التغطية، ولم تثر نظره إليها التعقيبات التي تليت أمامه، وتتلخص في الغاية والنموذج الذي نقصد تحقيقه من خلال نفي الحداثة وتجاوزها، فقد لا تختلف “الفرق الكلامية” المعاصرة إسلامية ويسارية حول الموقف الذي رآه العروي أساسيا في التعامل مع الحداثة، ومعالجة تداعياتها في عالمنا العربي والإسلامي، وهو التجاوز من خلال الاستيعاب، لكن مثار الخلاف هو الغاية من هذا التجاوز؛
فهل الغاية بناء مجتمع حداثي على الطراز الغربي؟
أم الغاية مجتمع حداثي على غير مثال سابق؟
ثم هناك إشكالية أخرى لا تقل أهمية عن الإشكالية السابقة؛ وتتعلق بمنهجية تجاوز الحداثة من خلال استيعابها؛
فهل الاستيعاب المطلوب يجب أن يكون مطلقا للقيم كما للأفكار والمناهج؟
أم لابد من رؤية انتقائية تتحفظ على بعض المواقف والقيم الحداثية؟
إن الأستاذ العروي يجزم بأن الطريق الوحيد للتحديث في عالمنا العربي هو الأخذ بأسباب الحداثة الغربية من فردانية وعقلانية وعلم حديث…، استنادا إلى فلسفة تاريخية لا يغرب عنها المثال الغربي.
فهل يمكن أن نتحقق من هذه القيم والمبادئ بعيدا عن التحقق من تاريخها (الثورة الاقتصادية والسياسية، والإصلاح الديني)؟
فيستحيل على البلاد العربية اليوم أن تعيش تاريخ شعوب أخرى وبالتالي تستجدي حداثتها، فهذا ليس من عادة التاريخ ودروسه، “فالتاريخ لا يعيد نفسه”، ولو في الفضاء الذي حدث فيه.
فإذا كانت قوانين ونواميس الحداثة الغربية واضحة لدينا اليوم وعلى مستوى العالم، فإنها ليست مطلقة بحيث تصبح شرطا للتحديث في المستقبل ولأي طرف في العالم.
فالغرب الأوروبي في عصر النهضة وهو يصوغ طريقه نحو الحداثة الشاملة لم يأخذ بالحداثة الإسلامية السائدة آنذاك إلا في جوانب محدودة علمية وفلسفية وتقنية.
والمواقف التي وقفها الغرب من تاريخه وتراثه الديني والفكري وهو يطلب الحداثة، والتي تمخضت عنها مبادئ التحديث من فردانية وعلمانية وعقلانية …؛ ليست بالضرورة هي نفس المواقف التي يجب أن نقفها نحن؛ وذلك ببساطة شديدة، لأن تاريخنا مختلف تماما عن تاريخهم؛
ففي المسألة الدينية – على سبيل المثال – لا يمكننا أن نتخذ نفس الموقف الذي اتخذه رجال الإصلاح الديني في أوروبا ككالفن ومارتن لوثر … من الديانة المسيحية في شكلها الكاثوليكي؛ ذلك أن الكنيسة في العصر الوسيط كانت العائق الأساسي أمام تحرر إرادة وعقل الإنسان الغربي، وبالتالي كانت عائقا أمام التحرر السياسي والاقتصادي، الشيء الذي لا ينطبق تماما على الإسلام.
فالمفاهيم، والقيم، والمبادئ التي ينتظر منها أن تؤطر الحداثة والتحديث في عالمنا العربي هي ستتبلور في سياق نقد شامل للتاريخ العربي والإسلامي، وبالتزامن من تاريخ جديد نعيشه، ولن تكون بالضرورة مطابقة للمفاهيم والمبادئ الغربية.
فنقد التاريخ الاجتماعي والسياسي العربي قد يؤدي بنا إلى مفاهيم وقيم تحديثه تبتعد كثيرا أو قليلا عن مفهومي الحرية والديمقراطية بصورتيهما الغربية، وهكذا في المسائل الأخرى.
ولا نستبعد في هذا السياق إمكانية الاستعانة على هذه المهمة بأدوات نقدية غربية تنتسب للعلوم الإنسانية أو التجريبية…
وأخيرا، إن التخوف على الإسلام من الحداثة الذي حاول أن ينفيه الأستاذ العروي، مبعثه توسل الحداثيين بمفردات ومفاهيم الحداثة الغربية في بناء مشروع الحداثة العربية والإسلامية؛ هذه المفاهيم التي تستبطن مفهوما كنسيا للدين وإن تعلق الأمر بالإسلام، ونشأت على خصومة وصراع معه (الدين).
ومعلوم أن هذا لا يصدق على الإسلام ودوره التاريخي، أو الدور المفترض أن يسهم في مشروع الحداثة.
والذي يعزز هذا الخوف، والشعور بعدم الاطمئنان هو انفصال قطاع عريض من النخبة في بلادنا وغيرها من البلاد العربية التي تتحمل عناء التحديث عن تاريخ الإسلام والمسلمين، وفي المقابل انخراطها في تاريخ الغرب وروحه الحضارية، الشيء الذي يجعل من مساعيها التحديثية في أحيان كثيرة موجهة ضد الإسلام في هذا البلد أو غيره، أو على الأقل هكذا تفهم من طرف جمهور المتدينين”.
وإجمالا، فالحداثة انطلاقا من هذا النص، وكما بينا في هذه القراءة هي تغيير تكتيكي في مشروع “الأيديولوجية العربية المعاصرة”، مس الجانب اللغوي والتواصلي ولم يلمس جوهر النظرية ومبادئها الرئيسية؛ فالعروي لا زال متشبثا بالمقولات الرئيسية التي أفصح عنها في “الإيديولوجية العربية المعاصرة”، ولا زال حاملا لروحها الماركسية.
تهافت النظرية العروية لمفهوم أصالة الأمة:
“في هذا السياق الثقافي والمعرفي والروحي، انتهينا إلى جملة من النتائج تمس جوانب مختلفة من النشاط النهضوي (الفكر، والدولة، والتراث)، ومن أبرز هذه النتائج:
1ـ إن أقصر الطرق لحل معضلة تأخر الفكر العربي على الواقع في البلاد العربية بشكل عام، وبالتالي تدارك التأخر التاريخي الذي تعاني منه الأمة هي:
أولا: عرض أسئلة الواقع العربي ذات الطابع المادي الصرف على الخبرة الفكرية والإنسانية، والاستفادة منها في بناء الجواب الفكري العربي، وعدم الاقتصار على خبرة الفكر العربي المحدودة والبسيطة، وهذه العملية جارية منذ أزيد من قرن تقريبا في البلدان العربية، مع تفاوت بينها، وتكفي في هذا الصدد الشواهد العمرانية، ووسائل التخطيط، والبنيات الاقتصادية…، وهو ما مكن ثلة من العرب من تجاوز خبرتهم المحلية والانتساب إلى الخبرة الإنسانية وبكفاءة عالية، وفي ميادين مختلفة.
ثانيا: عرض الأسئلة الدينية والثقافية التي يطرحها الواقع العربي، وكل خاص استقل به العرب عن غيرهم، على الخبرة الفكرية العربية، بسائر أبعادها، وهو ما سيؤدي ضرورة وحتما إلى الاجتهاد والإبداع، ولنا في الواقع العربي الذي نعيشه عدة أمثلة، وخاصة في مجال المرأة، التي عرفت أحكامها ووضعياتها الشرعية تطورا ملموسا في إطار الخصوصية الدينية الإسلامية، ولا زال الموضوع يحتمل تطورات أكبر تبعا لتطور أسئلة الواقع.
فـ “الإيديولوجيا العربية المعاصرة” التي نظر لها العروي، وبنى زخرفها تؤول بالضرورة إلى الآخر، وتتطابق بشكل تام معه، وفي كل شيء، ولا تبقي على شيء يمكن أن يدخل تحت مسمى الخصوصية، سواء كان دينا أو تراثا…
وبالمقابل “الإيديولوجيا” التي نحاول بلورتها، وننتصر لها هنا، تؤول إلى الذات، وتتطابق نسبيا معها، ومع مصالحها.
وتقوم هذه “الإيديولوجيا” على دعوى أساسية، وهي الاعتماد عل الخبرة الفكرية العربية في الجواب عن أسئلة الواقع الديني والثقافي العربي المعاصر، بينما تدعو للاعتماد على الخبرة الإنسانية في الجواب عن أسئلة الواقع المادي العربي.
فانطلاقا من هذه الرؤية تبدو أصالة الأمة، التي أنكرها العروي، أمرا ممكنا، وقابلا للاستمرارية، بل أكثر من هذا، إنها الموقع المناسب لانتقاد السلوك الغربي، وإظهار تجاوزاته، عوض الماركسية الموضوعية، وهي كذلك عنوان الذات والأنا العربية المعاصرة مقابل الآخر الغربي والشرقي.
2ـ إن واقع المجموعة البشرية العربية اليوم يؤكد من حيث المبدأ الحاجة الماسة للدولة، ولا يمكنه أن يستغني عنها، دولة بمفهوم يتناغم مع جبلة الإنسان العربي، وفطرته، فلا الدولة التقليدية قادرة على الوفاء بمتطلبات المعاصرة، الآخذة في الازدياد؛ ولا الدولة الحديثة بالمواصفات الغربية قادرة على استيعاب فعاليته الحضارية.
إن الدولة التي أجهد العربي نفسه في بناء مفهومها عمليا هي دولة “خلافة موضوعية” تلتقي عندها السماء بالأرض، ويتصالح خلالها الدين مع السياسة، فالتأخر في تبني هذا المفهوم من شأنه تبديد مزيد من فرص النهوض، وحجز الأمة في خانة المتأخرين تاريخيا وفكريا.
إن الأسلاف ـ وخلافا لرأي العروي ـ استطاعوا إنتاج مفهوم للدولة منسجم مع معطياتهم الحضارية والاجتماعية، ومنسجم أيضا مع النضج السياسي الذي بلغته الإنسانية، غير أن مفهومهم السياسي أمسى اليوم متجاوزا على أكثر من صعيد، وهو ما يقتضي من الخلف المبادرة إلى صوغ مفهوم جديد يشرف من خلاله العرب والمسلمون على العصر بكل ثقة، واعتزاز بالذات، بدل نكرانها كما يفعل الكثير من المغامرين اليوم في حقل السياسيات.
وإذا كان الوضعانيون انتهوا بعد تحليل وقائع كثيرة إلى أن الدولة الحديثة هي مجموع أدوات عقلنة المجتمع، الشيء الذي يضفي عليها الطابع المدني والعقلاني، فإن الدولة الإسلامية أو الخلافة الموضوعية، كما تبدو من خلال نفس التحليل، لا تعارض هذا المفهوم، بل تزيد على عقلنة المجتمع تديينه، فقيام الدولة بوظيفة الحراسة الدينية بمعنى العناية بالتأطير الديني وإشاعة قيم الوسطية والاعتدال، وتطبيق الشريعة الإسلامية، للمجتمع، وتوسيع فهم خاص للإسلام.
3ـ شهدت الثقافة العربية ـ والإسلامية في الفترة المعاصرة تطورات كبيرة في كافة الحقول، ولم تعد الحقائق التراثية تلزمها، أو تلتزم بحدودها، ومن الخطأ الجسيم اعتبارها مجرد صدى لكلام القدامى وإبداعاتهم، فقد ظهرت في القرن الماضي في مختلف أنحاء العالم الإسلامي أعمال وإبداعات في ميادين الفقه والفكر والسياسة .. تؤشر على عقلانية ناشئة وواعدة بالعالم العربي والإسلامي، تتجاوز في كثير من المظاهر ما أنجزه القدامى، كان وراءها التطور الموضوعي الذي عرفه العالم العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية…
فالفقه الإسلامي المعاصر بالرغم من توظيفه لأدوات منهجية تراثية، ينسب معظمها للشافعي ولمن جاء بعده، فقد استطاع مواكبة العصر وتحرير طاقة الإنسان المسلم، وبالتالي لم يعق إرادة النهضة والتقدم؛ ومن أوضح الأمثلة على هذا الأمر: وضع المرأة ومشاركتها شقيقها الرجل الكثير من الأعمال، فالفقه الذي كان يؤطر حياة المرأة المسلمة البدوية في غالب الأحيان، لم يعد المرجع في النظر للمرأة في البيئة الحضرية المعاصرة، وظهر فقه جديد أعاد رسم العلاقة بين الرجل والمرأة، وأنتج فقهيات حديثة، تناسب الأوضاع الجديدة.
ومن ثم فالحصر والمحدودية التي تميزت بها العقلانية الإسلامية خلال العصر الوسيط؛ سواء في شقها الشرعي (عقل المطلق) أو شقها التجريبي (العقل العملي)؛ هي بالأساس حصر ومحدودية في التاريخ أي الظروف المكانية والزمانية بمعناها العام، التي لم تتح للعقلانية الإسلامية التحرر والتقدم إلى آفاق أرحب وأوسع.
ولا أدل على ذلك الانفتاح واللاحصر الذي يميز العقل الإسلامي المعاصر، والنتائج الإيجابية التي بات يحققها على أكثر من صعيد، مواكبة للتطور التاريخي الذي تشهده الأمة؛ ومن ثم فإن مسايرة العروي في نظريته من شأنه أن يؤدي بنا إلى التوقف والعجز عن تفسير العديد من المظاهر في الراهن العربي والإسلامي؛ وعلى رأسها: الابتكارات العلمية الكثيرة التي يقف وراءها علماء مسلمون وعرب شرقا وغربا؛ ذلك أن عقل المطلق أو الآيل للمطلق (العقل الإسلامي) عاجز بنيويا على الإبداع والابتكار، ولا يسعفه إطاره الأخلاقي على البحث والتوسع في النقد، غير أن الشاهد يدل على خلاف ذلك، وهو ما يعزز وجهة نظرنا، التي ترجع التخلف إلى التاريخ (السياسة والمجتمع والاقتصاد…) ليس إلى العقل”.
من إيديولوجية التطابق مع الآخر إلى إيديولوجية التطابق مع الذات:
لقد انتهينا بعد مراجعة متأنية لـ “الإيديولوجيا العربية المعاصرة” إلى أن أسمى غاياتها تحقيق التطابق مع الآخر، والتماهي معه، وقد بذل العروي جهدا فكريا مضنيا للاستدلال على أهمية هذا التطابق، وفائدته بالنسبة للعرف في الدور التاريخي الذي يعيشونه، وألح على الممارسة الإصلاحية إلحاحا شديدا للعمل على تحقيق ذلك.
غير أن الناظر اليوم إلى مآل هذه الأطروحة، من جهة صدقية مبادئها، وتاريخيتها، ومن جهة قدرتها على الكشف، وتوقع شكل التقدم التاريخي الممكن للجماعة العربية، سواء في الاتجاه الإيجابي أو السلبي؛ يتضح له وبسهولة أن العروي أخطأ كثيرا في فهم طبيعة التأخر التاريخي العربي، والعوامل الأساسية التي تقف وراءه، ومن ثم أخطأ في توجيه الإرادة الإصلاحية لدى العرب التوجيه الصحيح، الشيء الذي أفرغ “دعوى التطابق مع الآخر” من محتواها الإصلاحي.
إن مآل “الإيديولوجيا العربية المعاصرة” يشبه مآل كثير من المشاريع الفكرية الإصلاحية التي ظهرت خلال القرن الماضي، والتي لم تتمكن من قيادة الممارسة، وتوجيه الفعل التاريخي العربي، وبقيت “نصا بلاغيا حجاجيا” على هامش اتاريخ، ومن وحيه“.
(المصدر: موقع أ. حماد القباج)