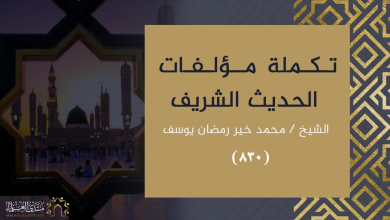في سوسيولوجيا التحولات الدينية في العالم .. ظاهرة المتحولين الدينيين نموذجًا
إعداد د. رشيد جرموني
أولًا: مدخل إشكالي (جدل الدين والحداثة)
يشهد الحقل الدينيُّ في المجتمعات المعاصرة – كغيره من الحقول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – العديدَ من التحولات، التي طالت بشكل خاصٍّ مسألة مكانة الدين في الحياة العامَّة والخاصَّة. والملاحظ أن هذا التحول شكَّل ما يمكن أن نطلق عيله موجةً ما بعد حداثية؛ لأن الدين – خصوصًا في العالم الغربي – عرف نوعًا من المدِّ والجزر في علاقته بالبنيات السوسيوثقافية والسوسيوسياسية. إذ هناك بعض الدول التي شكَّلت تجربتها التاريخية علمنةً كليَّة أو شاملة (فرنسا اللائكية)، وفي المقابل هناك تجارب تاريخية عرفت استمرارية نسبية، أو ما يمكن تسميته بـ”علمنة هادئة”، شملت عدَّة حقول، منها: السياسية والدولتية والمجتمعية (التجربة الأنغلوساكسونية). بيد أن ما يثير انتباه الباحثين والمهتمين بالمشهد الديني الحالي، هو “العودة” القوية للدين في الحياة العامَّة والخاصَّة (كازانوفا، 2005)، خصوصًا في المجتمعات التي عرفت قطيعةً تاريخيةً مع الدين، كالنموذج الفرنسي. في حين أن المجتمعات الأخرى ذات الثقافة الأنغلوساكسونية، بدورها ستعرف “انتعاشة للدين”، تجلَّت في مظاهر شتَّى، سواء في الحملات الانتخابية أو في النقاشات المجتمعية التي تطال قضايا حساسة، كالإجهاض أو الزواج المثلي أو تبني الأطفال أو غيرها من القضايا ذات الثقل الأخلاقي في هذه المجتمعات، حيث يبرز الاستدعاء القويُّ للقيم الدينية، مقابل الاحتماء بالقيم الكونية والحداثية التي انبنت عليها العديد من التراكمات الحقوقية والإنسانية والعالمية.
وعلى العموم، فإن حجم هذا النقاش الجدلي، بين الدين والحداثة أو ما بعد الحداثة، هو الذي حفز نقاشًا آخر مساوقًا، بل متجاوزًا للأول، وهو المتمثِّل في مساءلة حدود الحداثة ودور الدين في الحياة المعاصرة. وقد برز هذا النقاش لدى العديد من المفكرين والباحثين، الذين انشغلوا بفكر الحداثة وما بعدها، حيث توصل المؤرخ وعالم الاجتماع (“إيرك هوبزباوم”، 2011) إلى أن المجتمعات الحديثة في مساراتها الانتقالية ستشهد غيابًا للإجماع حول المرجعيات الكبرى للمجتمع، أو لنقل ضعفًا للإجماع حولها، أو ما يمكن أن نسميه بضبابية المرجعيات، أو فقدان الإجماع حولها. ومن ثمَّ فإن الإنسان المعاصر يعيش على وقع تحولَيْن كبيرين: الأول هو الشعور بحالات القلق واللامعيارية والصدمة والشك وفقدان الاتجاه، بينما الثاني هو محاولة بناء هوياتٍ جديدة، بعدما تمزقت الهويات الأولى، عبر البحث عنها إمَّا في الدين وإمَّا في عوالم أخرى، كالفنون أو الرياضة أو التجميل أو في السفر والاكتشاف، أو في العلم، أو حتى عبر الاستغراق في دوامة الاستهلاك “الجنوني”.
ومعلوم أنه في ظلِّ هذه الوضعية تنامى الاهتمام لدى العديد من الأفراد والجماعات، في المجتمعات الأور-أمريكية، بالأديان سواء السماوية منها أو الوضعية، بل إن البعض ذهب للحديث عن مزيجٍ من الأديان والاعتقادات (الإدريسي، 2012)، بدأ يهيمن على المشهد الدينيِّ في العالم المعاصر. وحيث إننا غير معنيين في هذه المساهمة بالوقوف على كل تلك المظاهر الجديدة في عالم اليوم، فإننا سنوجِّه اهتمامنا إلى ظاهرةٍ نعتقد أنها لم تنل حظَّها بشكل كبير من الدراسة والبحث، وهي ظاهرة التحول الديني إلى الإسلام، التي تشكِّل بحثًا عن هويةٍ جديدة في عالمٍ مليءٍ بالأسئلة واللايقينيات. فكيف يمكن فهم ظاهرة التحول الديني، باعتبارها مظهرًا من مظاهر التحول في الحقل الديني في العالم المعاصر؟ وما هي أهم مداخل التفسير المناسبة لفهم الظاهرة؟ وما هي أهم خرائط التدين التحولي الجديد؟ وكيف يمكن قراءتها في ظل الجدل بين الحداثة والتقليد؟ أو بين الدين وما بعد الحداثة؟
ثانيًا: ظاهرة التحول الديني (السياق والحيثيات)
لا يمكن القول إن ظاهرة التحول الديني ظاهرةٌ جديدة، بل عرفتها العديد من المجتمعات والثقافات؛ إذ إن “الانتقال من دينٍ إلى آخر، أو تبديل مجموعة من العقائد والشعائر بأخرى” (عبد الرزاق، 2011)، أو تغيير مجموعة من المرجعيات إلى أخرى – كان سائدًا دائمًا وأبدًا. لكن الجديد اليوم، هو أن هذا التحولَ عرف مجموعةً من الحيثيات والمظاهر التي تختلف عن السابق. فإذا كانت ظاهرة التحول الديني في السابق مجرَّد تحولٍ من ديانةٍ إلى أخرى، ومن ثقافةٍ إلى أخرى، فإن التحول الديني اليومَ يتخذ أبعادًا كونيَّة كبرى، ليس أقلها أنه أصبح عنوانًا على تملُّكِ هويةٍ دينيَّة جديدة تعوِّض الهويات السابقة، هذا علاوة على كون المعتنقين للدين الجديد يدخلون في إعادة تغييرٍ لكل البنى الثقافية والسياسية والاجتماعية، بل وحتى التاريخية لمساراتهم في بلدانهم الأصلية. إن هذا التحول بلغة “تورين”، هو نوعٌ من التاريخانية.
من جهة أخرى، يبرز التحول الدينيُّ مقرونًا بالديانة الإسلامية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات والاستفهامات؛ إذ في الوقت الذي يُتَّهم فيه الدين الإسلامي بأنه هو من يغذِّي التطرف والإرهاب والعنف (جيل كبيل، 2002، 2015)، إلى حدِّ ظهور مفهوم “الإسلاموفوبيا” كمفهومٍ حديثٍ في حقل الدراسات الأكاديمية والعلمية، فإن حجم “اللجوء” إلى الدين الإسلامي يمكن اعتباره من الآثار الجانبية غير المتوقَّعة لمسارات التحديث والحداثة، أو أنه قلبٌ لإشكالية الحداثة والتقليد، فكيف يمكن تفسير ذلك؟
لعل من أهمِّ الخلاصات التي توصلت إليها الباحثة (جيرالدين، Géraldine,2013)، هي أن فهم ظاهرة التحول الديني في الغرب لا يقف عند مؤشرات تزايد الإقبال لشراء المصحف الشريف، أو بناء المساجد والمراكز الإسلامية، أو ارتفاع أعداد الذين يقبلون على تعلُّم اللغة العربية، بل إن ذلك يتجاوزه إلى تفسيرٍ آخر، وهو المتعلِّق بالتحول الكبير في الحقل الديني، الذي يتمظهر في وجود “أزمة” إنتاج وإعادة إنتاج القيم الدينية في الأوساط الغربية، وتراجع دور الكنائس في التربية والتنشئة الدينيتين. في المقابل، تزايدت التوجهات الفردانية في عملية بناء المعتقدات والمسلكيات والتوجهات والاختيارات. هذا علاوة على مسار العقلنة والتحديث وطغيان الفكر المادي الصلب في العلاقات الاجتماعية وفي الحياة العامَّة والخاصَّة، إلى حدِّ الحديث عن “مجتمعٍ بلا قلب“، بمعنى أن المجتمع أصبح دون روح، أو دون معنى؛ أو من خلال ما عبَّر عنه الباحث السوسيولوجي “زيمل”: الفراغ الوجودي، الذي حدث جراء الحداثة ومستتبعاتها؛ كل ذلك دفع العديد من الأفراد إلى البحث عن دينٍ “عجائبي”، وعن “روحاينات” اعتقدوا أنها حاضرةٌ في الدين الإسلامي.
وبالعودة للباحثة “جيرالدين” التي أنجزت بحثًا إثنوغرافيًّا عن ظاهرة المتحولات للدين الإسلامي في كلٍّ من فرنسا ومقاطعة الكيبيك بكندا، فإنها استخلصت من خلال دراسة سير الحياة النسائية أن أغلبهنَّ كنَّ يبحثن عن عالمٍ جديد، أو عن نظرةٍ للعالم (World view) بلغة “weber”، والتي تعني إعادة تشكيل هويةٍ جديدة تقطع مع التجربة الدينية السابقة، التي اعتبروها غير مُغرية، وفيها تعبٌ دون فائدة، وأنها جري وراء المال والشهرة والربح والنجومية، لكن دون معنى ودون إحساس ودون اطمئنان. وبشكل أكبر منه بل ويضاهيه، هو أن تجربتهنَّ السابقة كانت إلى حدٍّ ما مقطوعةَ الصلة بالخالق، وهو ما يُشعرهنَّ بالفراغ الوجودي القاتل (حسب ما يروينه في شهاداتهنَّ).
ولا يمكن الركون في تفسير ظاهرة التحول الديني للأسباب الاعتقادية والوجودية، التي أبرزنا بعضًا من مظاهرها، بل إن هناك عواملَ أخرى تستحقُّ التوقف، منها على سبيل المثال: إعادة تشكيل طبيعة العلاقات الاجتماعية السابقة خصوصًا الأسرة، والقائمة على مركزية الأفراد والأنا والتعاقد، بدل الألفة الجماعية وإعطاء الأولوية للأسرة كلحمة اجتماعية، وإفساح المجال لقيم “التراحم” بجانب قيم “التعاقد”. وقد ورد في سير حياة النساء اللواتي اشتغلت عليهنَّ “جيرالدين” ما يشي برغبة النساء في إعادة خلخلة الأوضاع الاجتماعية، وخصوصًا علاقات المرأة بالرجل، واختيارهنَّ لنموذج الأسرة القائمة على “تكامل” كلٍّ من الرجل والمرأة، بدل مقولة الصراع التي هيمنت على الفكر الغربي منذ التثويرات التي دشتنها الحركة النسائية العالمية (فيمينيزم).
وبالطبع هناك عوامل أخرى ساهمت بشكلٍ أو بآخر في بروز ظاهرة التحول الديني في الغرب، ليس آخرها الطفرة القوية وغير المسبوقة في التدفقات الإعلامية التي سرعت بإحداث تحولاتٍ نوعية في مسارات الأفراد والجماعات واختياراتهم، الأمر الذي جعل من أشكال التدين عالميةً وليست محلية ولا ثقافية، وهو ما أحدث ظواهرَ أخرى، كظاهرة الإرهاب العالمي في صفوف هؤلاء المتحولين الدينيين (روا، 2017).
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن استخلاصُ تفسيرٍ واحدٍ ووحيدٍ للظاهرة، بقدر ما يجب التأكيد على أن هناك عدَّة عوامل ومداخل للتفسير، تصلح لكي نقترب من الظاهرة بشكل أكثر عمقًا. بيد أن الأمر الأهمَّ في نظرنا والذي يستحقُّ التوقف، هو طبيعة الخريطة الدينية (النماذج التدينية) التي رافقت الظاهرة، مما يعطي الانطباع أننا أمام ظاهرةٍ تنفلتُ من كل اختزالٍ في التحليل؛ لأنها تستضمر سياقات سوسويتاريخية عميقة، وبشكل يضاهيه، ديناميات سوسيواجتماعية وسوسيوسياسية وسوسيوثقافية، هي التي تؤثر في الظاهرة وتعطيها التنوعَ الذي برز في العديد من الدول والحضارات. فما هي أهم هذه النماذج؟ وكيف يمكن قراءتها في علاقتها بمظاهر التدين العام؟
ثالثًا: من هم المتحولون الدينيون؟ (قراءة في البروفايلات)
يصعب من الناحية المنهجية وضعُ نمذجة شاملة لكل المتحولين، على اعتبار أن أنماط التدين اليوم أصبحت “هجينةً” ومتداخلة، وقد تجد فيها كلَّ نوعٍ (كوكتيل)، الذي يجمع حتى بين المتناقضات. من جهة أخرى، تبقى مسألة النمذجة خاضعةً لمتغيراتٍ سياقية مرتبطة بالمجال الذي تتفاعل فيه مختلف الديناميات، مما يضفى طابعًا خصوصيًّا على نموذجٍ دون آخر. بيد أنه بالرغم من هذه الصعوبات الإبستمولوجية والمنهجية، فإننا سنجازف باقتراح نمذجة للمتحولين الدينيين، اعتمدنا فيها على دراساتٍ وأبحاثٍ سوسيولوجية وأنثروبولوجية. وعليه، يمكن القول إن البروفايلات الخاصَّة بالمتحولين الدينيين تتوزَّع على أربعة نماذج كبرى، وهي: الاتجاه المحافظ التقليدي، والصوفي الروحاني، والليبرالي الحداثي (نسوية إسلامية جديدة)، وأخيرًا الإرهابيون. فما هي خصوصية كل اتجاهٍ على حدة.
1-التقليدي المحافظ: يمكن القول إن هذا النموذج يعبِّر عن حالةٍ من التدين التقليدي المحافظ؛ لأن معتنقي الديانة الإسلامية الجدد يقدِّمون أنفسهم على أنهم ممثلون للدين “الحقيقي” الصافي والطاهر. ويتمظهر ذلك في التشبُّث بالتعاليم الدينية الحرفية، سواء في العبادات أو حتى في المعاملات والعادات وأشكال التفاعل الاجتماعي (فالحجاب يؤخذ بحدودٍ جد ضيقة مثلًا). وفي المقابل، يعتبرون أن الحداثة في شقِّها المتعلِّق بتقديس الفرد تهدم كلَّ الأواصر الأُسرية التي يدعو إليها الدين الإسلامي. ولهذا نجد أن هذه الفئة ترغب في الزواج من مسلمين أصليين، وذلك من أجل تعلُّم مبادئ الدين واللغة العربية. هذه علاوة على كونهم يرغبون في الحصول على أبناء، ويقدسون هذه الرابطة الأسرية أيما تقديس. وأخيرًا وليس آخرًا، نجدهم يرفضون تلك العلاقات الجنسية خارج الزواج، وتناول الكحول، وأكل لحم الخنزير، والسهرات “المختلطة”، وينظرون إليها باعتبارها “خروجًا عن الدين”. وفيما يخصُّ نظرتهم للدين، فهي تبقى في دائرة التقليد وإعادة إنتاج المسلكيات نفسها بنوعٍ من “الدوغمائية العمياء”، وبشكلٍ يُحدث قطائعَ “فظيعة” بين تمثُّل ماهوي ويوتوبي للتجربة التاريخية للإسلام، وإسقاطها على واقعهم المعيش، الأمر الذي يخلق توترات حقيقية في مسارتهم الحياتية. النموذج الصوفي الروحاني: ارتبط هذا النوع من التدين بالثقافات الضاربة في التاريخ، وبالمجتمعات التي لها حسٌّ صوفيٌّ عريق، كالمجتمعات المغاربية والتركية والهندية، بيد أن المتحولين الدينيين في أوروبا وأمريكا وكندا، بحكم انتمائهم لفئة من المثقفين والمفكرين والباحثين، وبحكم موقعهم السوسيواقتصادي المتقدِّم نوعًا ما – وجدوا في هذا النموذج الصوفي الروحاني ما يشفي غليلهم، وما يعبِّر عن مكنوناتهم، وما يشعرون به من فراغاتٍ قاتلة أحيانًا. ولهذا فالدين بالنسبة إليهم هو التسامي عن كل الموجودات والدخول في تجربة صوفية تقرِّبهم من المحبوب، وهو الله. وقد لا تجدهم يتشدَّدون في “الاحترام التام للتعليمات الدينية”، كما هو الشأن بالنسبة إلى التيار الأول، وهم متساهلون في مجموعةٍ من الطقوس، لكنهم يتمتعون بروحٍ “أخلاقية” عالية تمجِّد الزهد (ليس بمعناه البروتستانتي الكالفيني)، ولكن بمعنى التقلُّل من خيرات الحياة الدينا. ويجب الانتباه إلى أن انتشار هذا النوع من التدين كان بسبب وجود بعض الطرق الصوفية (العلوية والقادرية – البوتشيشية) التي تقدِّم هذا النوع من التدين (نموذج الكيبيك، كندا).
2-النموذج الليبرالي/ الحداثي: بسبب التأثير القوي الذي أحدثته الحركة النسائية في الغرب، فإن الآثار الثقافية المترسبة بقيت حاضرةً في عقول ووجدان ومواقف واتجاهات العديد من المتحولين والمتحولات دينيًّا. وقد انضاف إلى ذلك البروز اللافت لمفكرين “نيو إسلاميين”، كنموذج “طارق رمضان“، باعتباره مؤثرًا بخطابه وكتبه ومحاضراته في العديد من الشرائع الاجتماعية المسلمة، وخصوصًا الفئات المتوسطة العليا. حيث نجد أن كتابه الذائع الصيت “أن تكون مسلمًا أوروبيًّا، 1999“، شكَّل مانفيستو للعديد من النساء والرجال في العالم الغربي، وهو ما مهَّد الطريق لميلاد حركة نسوية يمكن أن نطلق عليها تجاوزًا مفهوم: “فيمينيزم إسلاموي“. ويحاول هذا التوجُّه أن يقدِّم تصورًا للعالم والدين والإسلام بشكل خاص، يتجاوز الطرح التقليدي والصوفي معًا؛ لأنه يجمع بين الحريات والحقوق، وبين الديمقراطية والدين، وبين الحداثة والتقليد. ويظهر ذلك في خطابهم حول المرأة المسلمة التي يعتقدون أن الإسلام حرَّرها من كل القيود الثقافية والتراثية، وأقرَّ مفهوم العدل والمساواة. بيد أن القراءات الحرفيَّة والنصيَّة وغير السياقية تفقد كلَّ معنى للمساواة بين الرجل والمرأة. ولهذا نجد هذا التيار يتماهى مع خطاب الكثير من الباحثات المسلمات، كـ”فاطمة المرنيسي (1940-2015) (عالمة الاجتماع المغربية الراحلة)، أو “أمينة داوود” (الأمريكية، من أصول ماليزية)، أو مؤخرًا “أسماء المرابط” (المغرب). وليس غريبًا عن هذا الاتجاه الديني أن يرفض التعدُّد لكونه يخالف مبدأ المساواة، وينظر لمسألة الإرث الإسلامي باعتبارها متعارضةً مع مبدأ العدل نفسه. وقد يكون لهذا التيار تداعياتٌ على البناء الثقافي للمرأة المسلمة في البلاد الإسلامية، عبر تثوير مجموعةٍ من الأسئلة والطابوهات، التي لا يلتفت لها أغلب المتحولين الدينيين، بل حتى أغلب المسلمين الأصليين أنفسهم.
3-النموذج الإرهابي العنيف: ولعه الأخطر في هذه النماذج، وهو ما نجده منتشرًا بشكل كبير في أوروبا وخصوصًا في دول (بلجيكا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا). وهذا لا يعني أن مسألة التطرف أو العنف مرتبطةٌ بالدين فقط، بل إنها مرتبطةٌ بسياقاتٍ محايثة أخرى، كمسألة الاندماج واللاندماج وما إلى ذلك. ويتميز هذا النموذج من المتحولين الدينيين بكونه يفصل الدين عن الثقافة المحلية التي يعيش فيها هذا المتحول دينيًّا، وهو ما دفع الباحث المتخصِّص في الحركات الإسلامية“أوليفي روا” إلى الحديث عن موجةٍ ما بعد حداثية في طريقة تمثُّل هؤلاء للدين. وقد لاحظ الباحث نفسه كيف أن عزل الثقافة عن الدين يؤدِّي إلى منزلقاتٍ كثيرة، ليس آخرها إسقاط التجربة التاريخية للإسلام على أحداثٍ ووقائعَ وبيئاتٍ غير متطابقة مع الدين نفسه. يقول “روا” (2017): “ثمة سيرورة معاصرة لتطرف أصولي في الأديان مردُّه إلى تقهقر الهوية الثقافية والقطيعة بين الأجيال، والعولمة، أو التحول الديني (الإسلام)، والعودة الفردية إلى الممارسات الدينية – يمكن أن تتقاطع وتتجاور”. ويخلص “روا” إلى أن “التطرف العنيف ليس نتيجة التطرف الديني”، وإن اقتبس منه في معظم الأحيان الطرقَ والنماذج؛ ولهذا يسميه “أسلمة التطرف“.
من جهة أخرى، فإن عملية تمثل الدين الجديد من طرف هؤلاء المتحولين أو المتحولات، والتي تتمُّ في الغالب عن طريق القنوات الرقمية (الشيوخ الافتراضيين) – يقع فيها نقل معرفة دينية غير منسجمة مع السياق الثقافي، ولا حتى السياق الذي تطبق فيه مبادئ الدين وأحكامه ومبادئه. وهو ما يجعل هؤلاء المتحولين أسهلَ شريحة لتبنِّي الأطروحات العنيفة للدين دون أن يشعروا، وكأنها – في اعتقادهم – هي الطريقة “الصحيحة” لتطبيق الإسلام و“الدفاع “عنه. في هذا السياق، نورد شهادةً حيَّة لمتحول دينيٍّ بريطاني، التحق بصفوف داعش، وبدأ يدعو للقتال معهم: “عندما ننزل إلى شوارع لندن وباريس وواشنطن سيكون الطعم أشدَّ مرارة؛ لأننا لن نكتفي بسفك دمائكم، بل سنحطم تماثيلكم ونمحو تاريخكم، ولكي نمعن في إيذائكم، سوف نحمل أولادكم على اعتناق الإسلام، وسيشرعون في التكلُّم باسمنا ولعنِ أسلافكم” (روا، 2017).
رابعًا: خلاصات واستنتاجات وآفاق للتحاور والاستشراف
نخلص مما سبق عرضه أن سرعة التحولات الدينية في العالم أفرزت العديدَ من الظواهر الجديدة، التي تستحقُّ المتابعة والاهتمام العلمي والأكاديمي. ولعل أهمَّ هذه الظواهر – في اعتقادنا – هي ظاهرة المتحولين الدينيين، التي حاولنا في هذه المساهمة أن نبيِّن بعضًا من أوجه تفاعلاتها. ولا شكَّ أن أغلب الدول الأوروبية والأمريكية قد انتبهت لحجم الظاهرة، وعملت على البدء في تنزيل مخططاتٍ ومشاريع لاستيعاب الظاهرة، عبر إقرار تعليم دينيٍّ محليٍّ ومرتبطٍ بالثقافات الأورو-أمريكية. فبعدما كانت بعض الدول (فرنسا كنموذج) تتجاهل المسألة الدينية في تدبير الشأن العام، فإن الأحداث الإرهابية الأخيرة عملت على تغيير البراديغم السابق بآخر استيعابيٍّ ومرنٍ في التعامل مع الظاهرة الدينية. بيد أن ذلك لا يكفي في نظرنا المتواضع؛ نظرًا لكون الظاهرة الدينية أصبحت عابرةً للقوميات والحدود والمجالات والثقافات والحضارات، وبالتالي فإننا نتصور أن المرحلة المقبلة تحتاج من صانعي القرار في كل الدول إلى الانكباب على بلورة رؤيةٍ شمولية وتشاركية وعبر مناطقية، لتجاوز كل التحديات التي تواجه الأفراد والجماعات والدول والحكومات، من تدينات “منفلتة” من كل ضبطٍ وتوجيه ومواكبة، ونقصد بذلك التدين التحولي العنيف. بينما بقية النماذج تعبِّر عن طبيعة التحولات الثقافية والدينية التي تخترق كلَّ الشعوب والحضارات دون استثناء.
خامسًا: المراجع المعتمدة في الدراسة
– صلاح عبد الرزاق، اعتناق الإسلام في الغرب: أسبابه ودوافعه، منتدى المعارف، بيروت، لبنان، 2010.
– أوليفيه روا، الجهاد أو الموت، ترجمة صالح الأشمر، دار الساقي، بيروت، لبنان، 2017.
– إريك هوبزباوم، عصر التطرفات: القرن العشرون الوجيز (1914-1991)، المنظمة العربية للترجمة، ترجمة فايز الصياغ، بيروت، لبنان، 2011.
– خوسيه كازانوفا، “الأديان العامة في العالم الحديث”، ترجمة قسم اللغات الحية والترجمة في جامعة البلمند، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، (لبنان)، 2005.
-Géraldine Mossière, 2013, Converties à l’islam, parcours de femmes au Quebec et en France.
-Gilles Kepel, Les banlieues de l’islam : naissance d’une religion en France, (essais),Editions du Seuil, Paris, 1991.
(المصدر: مركز نهوض للدراسات والنشر)