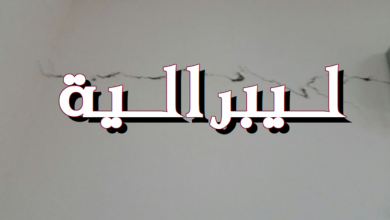عن أطروحة “ما بعد الإسلام السياسي”
لا تخلو بعضُ المقارباتِ والأطروحاتِ من ظاهرة “الاستعجال الذّاتي” و”التسطيح المعرفي” و”الأحكام المؤدلجة والمسبقة”، والتي تفتقر إلى النظرة العلمية الشاملة، وإلى الاستناد الأكاديمي الرّصين، وإلى توسيع زوايا الرؤية الموضوعية، ومنها: محاولات التسليم بالمقولات الإطلاقية والأطروحات المتهافتة مثل نبوءة: ما بعد الإسلام السياسي، لاستنجادها بالقراءات السريعة لتداعيات نتائج الانتخابات في العالم العربي، وكأنّها عملياتٌ حاسمة، واحتكامٌ فعليٌّ لإرادات الشعوب في انتخاباتٍ ديمقراطيةٍ ونزيهة، تعبّر حقيقةً عن “الأحجام الفعلية” لوزن هذا التيار أو ذاك.
وازدادت هذه الحملة التبشيرية بنهاية الدّور السّياسي للحركة الإسلامية بعد سلسلةٍ من انقلابات “الثورة المضادّة” على “ثورات الرّبيع العربي”، ومن أخطرها وأظهرها: الانقلاب العسكري على أوّل رئيسٍ مدنيٍّ منتخب في مصر، وهو الدكتور: محمد مرسي – فكّ الله أسْره، يوم: 03 جويلية 2013م، وعسكرة الانتفاضات الشّعبية السّلمية في كلٍّ من: ليبيا وسوريا واليمن، وفسح المجال للتدخل الأجنبي، وجعلها ساحاتٍ معقّدةً للحروب الإقليمية والدولية بالوكالة. وإذْ لا تُبرّأ “الحركة الإسلامية” عمومًا و”جماعة الإخوان المسلمين” خصوصًا من تحمّل جزءٍ من المسؤولية فيما وقع من أخطاءٍ استراتيجيةٍ قاتلةٍ في التعاطي مع هذه الموجات من “التحوّل الديمقراطي” في العالم العربي: استشرافًا وفهمًا واستيعابًا وسلوكًا وإدارةً للصّراع مع الفواعل المؤثرة فيها، إلاّ أنّ ذلك لا يبرّر – كذلك – لأيِّ نظامٍ أو تيارٍ سياسيٍّ أو مدنيٍّ وطنيّ أو دوليّ “عسكرة هذه الثورات”، والاحتكام إلى الدّبابة من أجل الوصول إلى الحكم أو من أجل البقاء فيه، وإلى تزكية هذه “الرّدة السياسية” عن “الشّرعية” و”الديمقراطية” و”القيم الإنسانية”.
إلاّ أنّ البعضَ الآخرَ يرى ما وقع لتيار الإسلام السياسي أنّه قد أحدث زلزالاً فكريًّا ومفاهيميًّا مدوّيًّا، وما هو إلاّ مجرّدُ إيذانٍ بدخول الحركة الإسلامية المعاصرة في مرحلةٍ مختلفةٍ، وانتقالها إلى طورٍ جديد، وهي في مخاضٍ لولادةٍ وبعثٍ آخر، تنسجم فيه “سُنة التجديد” مع “الحتمية النّصية” في الحديث النبوي الشّريف: “إنّ يبعث لهذه الأمة على رأس كلِّ مائة سنة مَن يجدّد لها أمر دينها.”، بالانتقال من “مرحلة الصّحوة” على مستوى خطّ المجتمع إلى “مرحلة النّهضة” على مستوى خطّ الدولة، وذلك بسقوط النموذج الكلاسيكي للحركة الإسلامية، والذي وصل إلى خطر “التمركز على الذات” و”تقديس التنظيم والأشخاص” على حساب “تقديس المبادئ والأفكار والمشروع”، مرتكزةً على: “الإيديولوجية الضيّقة، والتنظيم المغلق، والقيادة المركزية التقليدية”، ومعتمدةً على “الماكنة التنظيمية” في الحشد والتعبئة عبر “الشّحن العقائدي، الدّيني، والهوياتي”، مستثمرةً في فشل الأنظمة في “التنمية”، وفي “خصومتها مع الدّين”، وفي “شرعيتها المعطوبة”، وفي “غياب عدالتها الاجتماعية”. ومع عدم التسليم بصوابية ودقة مصطلح “الإسلام السياسي”، والذي لا يخلو من خلفياتٍ إيديولوجيةٍ ضيّقة، ويعتبره البعضُ ضمن “تمظهرات تنظيمية للإسلام” بعد سقوط “الخلافة الجامعة”، تخضع إلى تفسيراتٍ وتأويلاتٍ للدّين في الفهم والسّلوك، مثله مثل: “الصوفية” أو “السلفية” أو “التنظيمات الجهادية” أو “المؤسسات الدينية الرسمية”، إلاّ أنّ الحديث عنه “كمرحلةٍ زمنيةٍ عابرة” وفي “إطارٍ نظريٍّ من اللاّيقين العلمي والمنهجي” يجانِب الصواب للحقيقة الواقعية بأنّ هذا التيار قد أصبح “هويّةً مجتمعيةً” متجذّرة، وصوتًا سياسيًّا مرتفعًا، لا يمكن تجاوزه في المعادلة الصّعبة لاستقرار هذه الشّعوب والأنظمة. لأنّ الإسلام ليس مجرد “شعائر تعبّديةٍ فرديةٍ بين العبد وربّه”، بل هو كذلك مادةٌ ثوريةٌ ضدّ الظّلم والفساد والاستبداد، وأنّ التديّن الشّعبي العام أصبح يتجاوز – كمًّا ونوْعًا – القدرات التنظيمية للحركة الإسلامية، وأنّ هذا التيار ينجذب – طوعًا أو كرْهًا – إلى العمل السياسي، والقبول بقواعد العملية الديمقراطية، والعمل على التغيير السّلمي والإصلاحي، بعيدًا عن الأطروحات التقليدية للتغيير الجذري والشمولي للتنظيمات المتطرّفة.
وأنّ التعامل الاستئصالي أو الإقصائي لا يزيده إلا تعاطفًا وحضورًا بشكلٍ أو بآخر، وأنّ فشل الأنظمة في “الاحتكام إلى الديمقراطيةّ” وفي “تحقيق التنمية” وفي “احترام القيم السّياسية والإنسانية” هي من أكبر عوامل استمرار هذا التيار، ووقود وجوده وقوّته اليوم وغدًا، وأنّ صندوق “الديمقراطية الحقيقية” في العالم العربي والإسلامي يتحدّى فرضية “ما بعد الإسلاموية”، ويسقط “أطروحة ما بعد الإسلام السياسي”، لأنّه لم – ولن – ينجب إلا مَن ينسجم مع عقيدة وهوية وعمق هذه الشّعوب المسلمة، وهو ما جعل “الأنظمة العربية” وبعض التيارات العلمانية والمدنية تكفر بالانتخابات، ولا تؤمن بها كآليةٍ للوصول إلى الحكم أو البقاء فيه، بل وتساوم “الغرب” وتخيّره بين التنازل عن مطلب “الديمقراطية” أو القبول بفوز “الإسلاميين”. إنّ محاولات نمذجة وتعميم التعامل مع “الحركة الإسلامية” بنفس الأساليب والآليات في كلّ الأقطار: خطأٌ استرتيجيٌّ للدول “الغربية والعربية”، ذلك أنّ “الظاهرة الإسلامية السياسية” متعدّدةٌ ومتنوّعةٌ في التركيبة والمقاربة، وتحديدًا للفروق الظاهرة بين نموذج الحركة الإسلامية في المشرق العربي، ونموذج الحركة الإسلامية في المغرب العربي، وقد ذهبت حركاتٌ إسلامية – بكلّ جسارةٍ فقهية وشجاعةٍ فكريةٍ – إلى نوعٍ من المراجعات النقدية العميقة إراديًّا، ومنها: التنظير والتنفيذ للتجديد والتخصّص الوظيفي، بتوزيع وإدارة وظائفها الأساسية، والذهاب الواعي إلى مرحلة “ما بعد التنظيمات الشّمولية”، والانتقال السّلس من “التنظيم الهرمي المحوري” إلى “التنظيم الشبكي الرّسالي”، بتركيز “الوظيفة السياسية” في الحزب السياسي المدني البرامجي من أجل التمكين له في الدّولة، وتركيز الوظائف الاجتماعية والمجتمعية في المؤسسات المدنية، والتمكين للدّين (الهوية والقيم والفكرة الإسلامية) في المجتمع. وهي التحوّلات التي تجعل “الحالة الإسلامية السياسية” ومرحلة ما بعد “الإسلام السياسي” ليست مجرد “أطروحةٍ جدليةٍ عقيمة”، بل مشروعًا جديدًا وجدّيًّا، يخرج “الدّين” من الصراع السياسي والتنافس الانتخابي، ويتّجه بالأحزاب ذات المرجعية الإسلامية إلى الاحترافية في العمل السياسي، والخروج من “فقه الجماعة” إلى “فقه المجتمع”، ومن “فقه الدّعوة” إلى “فقه الدّولة”، ومن “الإيديولوجيا إلى التكنولوجيا”، ومن “البُعد الدولي الأممي” إلى “الدولة الوطنية القُطْرية”، ومن “مبدئية الصّحوة” إلى “واقعية النّهضة”، ومن “الصّراع العدمي” إلى “التعاون مع الغير على الخير”.
إنّ الأنظمة مطالبةٌ بالخروج من مرحلة حساسيتها المفرطة اتجاه الدّين، ومن خلطها السّاذج بين الإسلام والإسلاميين، ومن عقدة خوفها من البعد الهوياتي الثوابتي المحافظ، ومن التبعية المزمنة للإملاءات الخارجية، ومن ضغوط الأقليات الداخلية. كما أنّ الحركة الإسلامية مطالبةٌ – أيضًا – بتحرير الإسلام من الأطر التنظيمية الحزبية، وبالتسامي عن “أدلجة الدّين وتحزيبه”، وبالتعفّف عن مزاعم امتلاك الحقيقة المطلقة واحتكار الصواب الكامل في الاجتهاد السياسي، وبالانطلاق من “الشعارات إلى الممارسات” بأجرأةٍ علميةٍ وواقعيةٍ للمبادئ العامة والقواعد الكبرى والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، وهيكلة الشعارات والأفكار والأطروحات البديلة إلى برامج تنموية عملية وحقيقية، وإنهاء القطيعة بين “السّلطان والقرآن”، والانتهاء من الحالة القلقة بين الحركة الإسلامية والأنظمة الحاكمة، وتحديدًا: معالجة إشكالية اهتزاز الثقة المتبادلة بينها وبين المؤسسة العسكرية والأمنية. ذلك أنّ الشعوب – اليوم – بحاجةٍ إلى تلبية حاجاتها الدنيوية بالبرامج والمشاريع التنموية، عن طريق المشاركة السياسية العامّة، وليست بحاجةٍ إلى إشباع حاجاتها الرّوحية بالتديّن العام، وإقحامها في المعارضة الصدامية أو المواقف العدمية، لحسمها في معركة الهوية، وبقاء استحقاق سُنّة التدافع في معركتها على مستوى القيم والتنمية.
المصدر: حركة مجتمع السلم