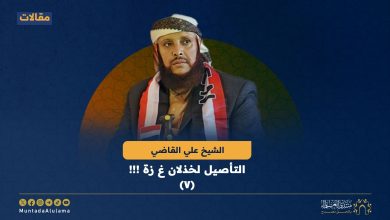بقلم أحمد طه
من أخطر دعاة العلمانية هم الدعاة الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، ويزعمون الدعوة إليه.. ثم هم بعد هذا الزعم يقولون: “ليس لنا علاقة بالسياسة” لقد تركناها، وتوجهنا إلى “العمل الدعوي” فقط !. وهذا بالضبط هو عين العلمانية ومقصدها الأساسي.
فصل الدين عن الحياة والدولة
يحسب الشباب – من ذلك القول – أن هناك فرق بين “العمل الدعوي” وبين السياسة، ومشكلات الحياة، وقضاياها… إلخ.
إن الداعية إلى الله – وإلى دينه – لا يضع حواجز بين الأخلاق، وبين سياسة حياة الناس، ويزعم أن الدعوة إلى الله محصورة في مجال “الأخلاق والعبادات” ويحصر رسالة الإسلام في مجرد “التدين الذاتي” بعيداً عن قضايا الحياة والمجتمع والعالم..
إن الإسلام جاء ليحكم، وليسوس حياة الناس: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية…إلخ، والله – سبحانه – يريد أن يكون الدين – بمعنى منهج الحياة – كله له سبحانه، بل يريد أن تكون الحياة والممات كلها لله سبحانه، فهو صاحب الخلق والأمر، وهو الملك الديان، فهو الأولى – سبحانه – باتباع شرعه وهديه، ومعالم دينه الذي ارتضاه للناس.
ومن يحاول أن يلغي عن الإسلام وظيفته الأساسية والأولى، فهو يحاول أن يُميت هذا الدين، ويُوظفه لأغراضه.. لا ليتبع هداه.
وكل دين – حتى الأديان الوضعية والمحرّفة – تحمل في ذاتها “سياسة” ونظام سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وأخلاقي، ومن يراجع تاريخ البشرية وموقفها من الدين سيجد هذه القضية واضحة، ولقد كان للأديان الوضعية والمحرّفة الأثر السيء في استعباد الناس باسم الدين، وسرقة ثرواتهم وأموالهم باسم الإله ! حتى قامت الثورات العلمانية على الدين وعلى الإله.. وقامت العلمانية كـ “دين سياسي” بديل، وقامت باستعباد الناس باسم العلمانية، وسرقة ثرواتهم وأموالهم – هذه المرة – باسم “الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان” وباسم “الليبرالية والشيوعية”!
فلم ينفصل أي دين عن السياسة يوماً، لأن الدين منهج حياة، ومنهج اعتقادي وفكري، وأخلاقي وتربوي، وقيمي ومعنوي، يحدد ما يجوز وما لا يجوز، وما هو حق وما هو باطل.. ومن ثم فهو في مكان القاعدة الأساسية والتأسيسية للنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية… إلخ.
فتنة المال والسلطة
ولأن فتنة “المال والسلطة” من أشد وأخطر الفتن.. كانت الناس تنحرف عن المبادئ الصحيحة للدين، من أجل البقاء في السلطة، أو أكل أموال الناس بالباطل، وفي سبيل ذلك استباحت ووظفت كل شيء، وأول ما وظفته في ذلك هو الدين ذاته، من أجل إعطاء الشرعية للنظم السياسية الفاسدة والظالمة، ومن ثم سخط الناس على هذا الدين الذي يأمرها بطاعة الطغاة والبغاة، فظنت أنها ستجد في العلمانية، وتحييد الدين سبيلاً رشدا ! لكنها وجدت ظغياناً أشد، وخداعاً أكبر، وحيرة أعمق.. فتخبطت في التيه البعيد.
ولقد كانت علمانية الجاهليات الأولى تتلخص في: الإلحاد والدهرية ( وإنكار البعث والحساب )، ورفض أن يكون لرسل الله قولاً أو أمراً في قضاياهم الأخلاقية ( كقوم لوط ) أو قضاياهم الاقتصادية ( كقوم شعيب ) أو قضاياهم الاعتقادية ( كقوم إبراهيم ) أو مناصبهم الاجتماعية ومصالحهم المالية والقبلية ( ككفار قريش )… إلخ، وبالجملة رفض تحديد الحلال والحرام، والحق والباطل من قِبل الله سبحانه. أو كل هذا مجتمِعاً كما هو الحال اليوم !.
العلمانية المعاصرة
حصلت اشتباكات وصراعات بين الإسلام و”النظم السياسية”:
صورة تزعم تطبيق الشرع
على نحو لكم دينكم، ولنا السلطة والشرعية السياسية.. فهي صورة تعطي للناس ما تريده من تدين أو “شكل تدين” في مقابل صفقة البقاء في الحكم أبد الدهر، دون التدخل في أي شأن جوهري فيه، ودون محاولة مجرد التفكير في إنكار المنكر في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية…إلخ، وإلا كان السيف بالمرصاد.
ومن ذلك الشكل خرج دعاة للعلمانية – باسم الإسلام – يدعون الناس إلى التدين الفردي، دون التدين السياسي والاقتصادي، ودون إنكار المنكر، وإقامة الحق والعدل، فهم يقولون: “ليس لنا علاقة بالسياسة” ويزعمون بذلك أنهم دعاة إلى الله!
صورة تلغي الشرع بالكلية
على نحو حصر التدين في الصورة الفردية، دون الانشغال والاهتمام بمحاولة التصالح معه.. في مقابل إعطاء بعض الحريات الديمقراطية، وتبادل الأحزاب على السلطة – إن سمحت الظروف المحلية والدولية بذلك – والدعاة للعلمانية فيها على نفس الصورة السابقة، يقولون: ليس لنا علاقة بالسياسة فهي شأن دنيوي خالص لا مبادئ فيه !.
وإن كانت العلمانية اليوم لا تريد فقط فصل الدين عن النظم السياسية، بل تريد فصل الدين عن المجتمع، والثقافة، والتاريخ، والفرد.. تريده “ملحداً زنديقاً” ولا مانع بعد الإلحاد بادعاء الإسلام وحبه لخداع النفس! ولمزيد من “الضلال البعيد”.
صورة تريد الإسلام حقاً
ولكنها لا تريده على “الشكل الرسالي” إنما على الصورة “الحزبية المتعصبة البراجماتية” وهي ترى في الإسلام حقاً منهج حياة، لكنها فشلت في التطبيق، ومن ثم قدّمت النموذج السيء الضعيف في محاولة تطبيق الإسلام على واقعنا السياسي ومشكلات الحياة، وخلطت بين “سياسة الإسلام” وبين “عملها السياسي”. ولم تستطع أن تفصل بين مبادئ الإسلام السياسية، وبين تجربتها الذاتية، وجعلتهما صورة واحدة.
دعاة العلمانية باسم الدين
إضافة إلى أن التعصب والبراجماتية يحطم الروح الرسالية للإسلام، ويجعله ديناً حزبياً لجماعة أو طائفة.
ومن الصورة الأولى والثانية: خرج دعاة العلمانية باسم الدين، مثل بعض الاتجاهات السلفية، وما يسمون “الدعاة الجدد”. والصورة الثالثة: لم تحسن القيام بدورها، فأخرجت نماذج مشوهة، ضعيفة.
ودعاة العلمانية باسم الدين: هل حقاً ليس لهم علاقة بالسياسة، عندما يقولون: “سنمارس العمل الدعوي دون الدخول في السياسة” ؟
الحقيقة لا.. إنهم بهذا الموقف يمارسون “سياسة” في أوضح وأجل صورها ! وسياسة مدروسة ودقيقة ومحسوبة بدقة. فكونهم يتكلمون باسم الدين، ولهم شعبية وجماهيرية واسعة، وقدرة على التأثير، وتوجيه الرأي العام فهذا في حد ذاته “قوة سياسية” يجب أن تستغلها “الأنظمة الفاسدة والباغية والمستبدة” وعندما يسكتون أو يباركون أو يؤيدون ظلم الظالمين، وفساد الفاسدين، وبغي الباغين؛ فهم يعطونها “الشرعية” الكاملة، وبذلك فهم أحد أهم دعائم “النظم السياسية” خاصة في المجتمعات المتدينة أو التي تنتظر كلمة الدين من “دعاة الدين” !
دور النظم السياسية في تدليس وعي الشعوب
والنظم السياسية المستبدة تدرك تركيبة الشعوب، فالمناطق الريفية التي يغلب عليها الاستكانة والطيبة يجعلون فيها أصحاب المنهج السلفي المنحرف الذي يجلس بهم لمناقشة قضايا تافهة، لتخديرهم عن قضايا حياتهم ومشكلات السياسة. والمناطق المتحضرة والأكثر مدنية وتعلماً يجعلون فيها “الدعاة الجدد” الأكثر أناقة لباساً وكلاماً ومنطقاً، للتدليس على وعي هذه المناطق بالأسلوب المناسب لهم.. وهكذا حسب كل شريحة وطبقة، فهي سياسة.. وسياسة مُحكمة ومدروسة !
فمثل هؤلاء الدعاة هم “جماعات دينية وظيفية” – وربما كان كثير منهم لا يقصد ذلك في بداية أمره – تستخدمها وتستغلها الأنظمة الفاسدة والباغية لأداء دور مرسوم ومدروس بعناية فائقة، وتحت رقابة مشددة لكل موضوع، بل لكل “لفظ” يتم قوله ومناقشته، وأي داعية فيهم يخرج عن الدور المحدد له، يتم إنذاره وتهديده أو فصل الأضواء عنه، وحرقه، وتشويه سمعته، والتخلص منه.. فهم مجرد عُمال في “المطبخ السياسي” للظالمين والباغين والمعتدين.
جوهر خيرية هذه الأمة
ولقد كان جوهر خيرية هذه الأمة – بعد الإيمان بالله – هو: “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية… إلخ هو جوهر “سياسة الإسلام”.
وكل داعية إلى الله ودينه.. يقف ليقول كلمة الحق، فيقوم بالقسط، ويشهد لله وحده؛ فينكر ظلم الظالمين، وفساد الفاسدين، وبغي الباغين..
وكل داعية إلى الله ودينه.. يقف على قضايا الأمة المصيرية ومشكلاتها، ليُبصِرها، ويُبصّرها للناس كافة.
وكل داعية إلى الله وينه.. يُبلغ رسالة الله، ولا يخش أحداً إلا الله.
وكل داعية إلى الله ودينه.. منشغل بنهضة أمته، وتحريرها من الاستعباد والاستبداد، ومن الطغاة والطواغيت، ويحرك في الناس معنى الاستسلام لله وحده، وينادي بالحرية التي وهبها الله للإنسان، ويستحث كرامة المسلم في مقاومة وجهاد الظالمين والمعتدين.
وليس مطلوباً من الداعية أن يكون نصيراً لحزب سياسي معين، أو يشتبك في كل صراع سياسي بين طوائف وجماعات، أو يكون اختياره السياسي هو مطلق الحق والعدل.. كلا، بل مطلوب منه: أن يشهد لله وحده بالحق، ويقوم بالقسط، وينكر المنكر عند كل طرف، ويُقر بالمعروف عند أي طرف.
راجع مقالنا: فصل الدين عن العمل السياسي
وقد يخاف الداعية على نفسه إذا هو أنكر المنكر، أو قال كلمة الحق.. والرواد لا يجوز لهم الرخصة، فهم الذين يحملون شعلة الهداية، وخلفاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعليهم قول الحق مهما كلّف ذلك من تضحيات، ولكن من هو دونهم، ويخشى على نفسه أن يُفتتن في دينه أو دنياه، فهذا قد يسعه “السكوت السلبي” – بلا إقرار للمنكر – وأن يؤدي دوره في الدعوة إلى الله دون “رضى ومتابعة” على ظلم الظالمين، وفساد الفاسدين.. وأن يُفهم الشباب وأتباعه أن دوره محصور في “قضية أو موضوعات معينة” وإذا أراد الشباب معرفة الحق في قضية – يخشى أن يتكلم فيها – فعليهم أن يذهبوا لغيره، حتى تبرأ ذمته، فلا يكون الداعية عوناً للظالمين على ظلمهم، ولا يعطيهم شرعية للحكم أبدا.
الخلاصة
وإن دعاة العلمانية الذين يعادون الدين.. ينفر منهم الناس، ولا يقبلون لهم قولاً – إلا قليلاً – أما الغالبية فهي تطمئن إلى دعاة العلمانية إذا جاءت باسم “الدين” أو من “رجل دين” فهي بذلك تثق فيهم، وهذا سر “الاهتمام السياسي” بدعاة العلمانية باسم الدين.. وعلى المسلم أن يحذر أن تُصيبه فتنة هؤلاء، ومتى أخلص النية، وطلب التقوى هداه الله.. ومن لم يجعل الله له نوراً، فما له من نور.
(المصدر: أمة بوست)