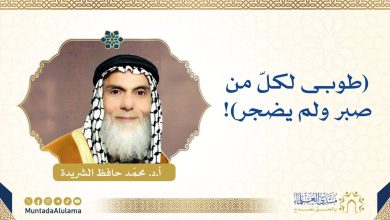دراويش توكل كرمان.. ويوتوبيا “الديمقراطية المعلمنة” (1)
بقلم حسام شاكر
لا ينبغي لشجاعتها في وجه الاستبداد أن تكبح تشغيل الحسّ النقدي إزاء ما تدفع به من رؤى ومقولات، خاصة إن اختمرت فيها وصفة إقصاء وإسكات وإن لم تكن مقصودة بحذافيرها. أطلقت السيدة توكّل كرمان نصوصاً مقتضبة ومحيِّرة في مواقع التواصل الاجتماعي عن المستقبل “الحتمي والمنشود” الذي ستؤول إليه الأنظمة السياسية في اليمن وبلاد العرب، وأعلنت عن “مشروع دولة ديمقراطية معلمنة، آتية لا ريب فيها”؛ وهي وعود سابغة تستحقّ نظراً فاحصاً وتمحيصاً نقدياً.
والنصوص التي بين أيدينا هي في جملتها حتى الآن، تغريدات مبثوثة خلال شهر آب/ أغسطس 2018، وهي موضوع الفحص والمناقشة، بصرف النظر عن مشروع الدولة المفترض الذي يقتضي فحصاً مستقلاً. يأتي في أحد النصوص مثلاً: “عليهم أن لا يخوضوا في شؤون السياسة ولا في أمور الدولة ..”!. إنه خطاب غير متوقع من ثائرة ميدان وناشطة حقوقية محسوبة على “المجتمع المدني” ومفاهيم المواطنة.
حديثها هو عن “الدراويش”، الذين طالبت بمنعهم من “الخوض في السياسة” أو التطرّق إلى “أمور الدولة”، واعتبرت ذلك حصيلة توافقات انعقدت في “الحوار الوطني”. مقتضى النصّ بحرفيّته، أنّ السياسة ليست لأحد سوى لموظّفيها؛ فهي من شأن الأحزاب السياسية ورجال الدولة ونسائها، وفق ظاهر النصّ. ومن يرضخ للنصوص بحذافيرها سيكتشف ردّة إلى تأويل متشدد للديمقراطية التمثيلية يقيِّد مشاركة الشعب ويكبح تفاعله مع الشأن العام. لكنّ الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل جاءت بنصوصها المُختزَلة هذه في مواجهة “الدارويش” تحديداً، وليس المجتمع المدني مثلاً. فهل يعني هذا أنّ الحديث في السياسة وأمور الدولة هو “لنا نحن”، في المجتمع المدني، وليس لكم أيها “الدراويش”؟
ترى توكّل كرمان في هذا السياق أنّ الخلاص اليمني، والعربي بالأحرى، فقد تحدثت عن خيار حتمي “لشعوبنا وبلداننا”، هو في “الديمقراطية المُعلْمَنة”، وهي شعار فضفاض يحتمل تأويلات شتى، ليس بعضها معصوماً من أن يتطرّف في المفهوم النظري؛ وفي التنزيل التشريعي؛ وفي التطبيق التنفيذي؛ وفي الانعكاسات المجتمعية.
وعندما تقول كرمان إنّ نصوصها ليست انتقاصاً من “الدراويش”؛ فإنها صيغة تؤكِّد النعت بما يترتّب عليه، أو تنحو إلى تأصيله وشرعنته، وهي تدرك ضمناً أنّ وصف “الدرويش” يُستَحضَر عربياً في مقامات السياسة والشأن العام لأغراض التسفيه أو الازدراء، وما على “الدراويش”، حسب ما تنادي به كرمان، سوى الانزواء عن الشؤون العامة أيضاً بسطوة الدولة الحديثة و”مخرجات الحوار الوطني” التي لم يُستَشر الشعب فيها.
راقت مفردة “الدراويش” تحديداً لتوكل كرمان في محاولتها لتصنيف المُستهدَفين بحظر المشاركة والإسكات السياسي، وهذا لأنّ الحالة الدينية أو الثقافية أو المجتمعية التي تقصدها لا تصنيف لها محدّداً في الأساس، وحتى تعبير “الإسلام السياسي” (الذي لم تستعمله هنا) لا يفي بمقصد الضبط والتحديد (وهو تعبير إشكالي للغاية أساساً ويحمل نزعة استشراقية). ليست صفة “الدراويش” قابلة للتحديد في الواقع العربي/ الإسلامي، ولا يمكن حصرهم بمتخصصي العلوم الإسلامية، ولا يتحقّق المقصد بتصنيفهم بتمايُز في هيئات أو أزياء أو ألقاب، فجميعها متحوّلة متبدِّلة، والمحيِّر أنّ كرمان لم تَقصُر حضورَهم على المساجد مثلاً؛ بل تجاوزتها إلى منصّات المخاطبة الجماهيرية والمنابر المجتمعية كافّة مما يندرج حسب مشروعها في مقام “الوعظ”.
لا تمانع توكّل كرمان من أن تكون لمن تسميهم “الدراويش” منابر ومنصّات وقنوات يتحدثون عبرها في “الوعظ والإرشاد” فقط – ويا لها من مكرمة! – لكن دون أن يتطرّقوا إلى “السياسة وأمور الدولة”. ما يُفاقم مأزق هذا الخطاب أنه يغضّ الطرف عن استعمال آخرين تأثيراتهم النافذة وحظوتهم المؤكدة في المداولات السياسية والنقاشات في الشؤون العامة، مثل مشاهير الفن والأدب والثقافة ومتحدثي الشاشات، وحشد الشخصيات العامة وديناصورات رأس المال، ومالكي القنوات والمنصّات، والمتحكِّمين بفرص التصدّر الجماهيري، وبعضهم وثيق الصلة بالسياسة وأمور الدولة أساساً.
ألا يلحظ القوم أنّ مقولة الدولة “الديمقراطية المُعلمَنة”، كما تؤسِّس عليها توكل كرمان مقولاتها، لا تضمن بصفتها المجردة تكافؤ الفرص بين مكوِّناتها؟ صحيح أنها قد تمنح مساواة لفظية على أوراق مخرجات “الحوار الوطني” التي يحملها العالقون في منافيهم؛ لكنّ الذين يملكون الثروة ويستحوذون على المنصّات سيحظون بحصّة أعلى من البروتين والشوكولاتة وفرص التأثير في المعادلة الواقعية. وقد يطفو على السطح، فجأة، برلسكوني عربي، أو ترمب يمني، بقوّة المال والنفوذ، وشحنة الوعود الشعبوية، وبأساليب تسطيح الوعي والأخبار المزيفة وشراء الذمم وتواطؤات الخارج. فهل ستكون “الديمقراطية المعلمنة” هي فردوس المواطنة الموعود الذي يملأ الأرض عدلاً؟
تعتور ملامحُ القصور المشروعَ الديمقراطي حتى في منابته، وقد صارت المعضلة شاغلاً للمنتديات التخصصية ومنابر الفكر، ولم تبالغ “فورين أفيرز” في ربيع 2018 عندما فتحت ملف “احتضار الديمقراطية واضمحلالها” كما فعل كثيرون غيرها. على النخب العربية المندفعة بحماسة منقطعة النظير أن تتحلّى بنظرة واقعية تتجرّد من الشعارات الحالمة والتوقعات المبالغ بها وأن تلحق أخيراً بمتغيّرات الزمن الجديد، وعليها أن تملك الجرأة على المشاركة في تطوير المشروع الديمقراطي على مسارات متعددة وليس بتقمّص نسخة جاهزة منه كمصنع قابل للاستيراد والتشغيل المباشر. وعلاوة على الإشكاليات المزمنة في المشروع الديمقراطي؛ فإنّ الطغيان الرقمي غير المرئي يفرض تحديات جسيمة على الديمقراطيات العريقة التي يخترقها أولو الأمر الشبكي ويتلاعبون بمواسمها الانتخابية، فهل ستنجو بلاد العرب المكشوفة لتلاعبات الخارج من عواقب ذلك؟
هذا غيض من فيض الإشكاليات القائمة؛ لكنّ اليوتوبيا العربية المنصرفة عن الواقع استولت عليها أدبيات التأسيس السلفية للتجارب الأوروبية، وتعطّل عندها الزمن أو لم تعترف به، كما انطبعت في وعيها مواد مخصصة لدول العالم الثالث لتثقيف نخبتها الحالمة على “الديمقراطية والحكم الرشيد”؛ كالتي سبقت عهد ترمب، على أيدي مدربي “المعهد الديمقراطي الأمريكي” مثلا، ومبشِّري المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. من المصارحة القول إنّ أطيافاً من نخب “العالم الثالث” لم تجرؤ بعد على مناقشة عالمها العريض أو مراجعة أفكاره، ولا تملك الثقة الكافية لشغيل حسّها النقدي في مواجهة مقولات ساطعة، أو استدعاء روح التمحيص إزاءها، بما يُغري باحتكار الحقيقة، وحمل النبوءة، والتبشير بالخلاص، ونثر الحتميات الحالمة.
في دولتنا الديمقراطية المُعلمَنة سيكون هناك مئات الآلاف من المساجد والمنابر بالتأكيد”. يبدو الدين، عند كرمان، والتديّن محصوريْن عملياً في المساجد والمنابر والوعظ والإرشاد وأداء الشعائر والأجواء الروحانية التي لا تُناقِش ولا تُسائل ولا تعترض
عندما لا تترفّق النصوص مع أشواقها الجامحة ووعودها الحالمة؛ فإنها تستسهل مصادرة المستقبل لصالحها، حتى أنّ الدولة “الديمقراطية المعلمنة” آتية لا ريب فيها، وهو صنو المنطق الذي تستعمله أطراف الاحتراب العربي الراهن ومنها شعارات “باقية وتتمدّد”. تتأجّج هذه الحتميات الصارمة ولا تتواضع لاحتمالات المستقبل؛ فيأتي في نصوص كرمان المبثوثة للجمهرة مع تغريدات الصباح: “صباحكم علمانية وديمقراطية قادمتين (قادمتان) لاريب فيهما”، أو “صباحكم ديمقراطية معلمنة قادمة الى كل شعوبنا كقدر حتمي لاريب فيه”.
وتساوقاً مع نزعتها الحتمية الصارمة التي لا تقبل احتمالات أخرى؛ تأتي نصوصها مشفوعة بالترهيب من المآلات التهديدية المفترضة في حال الإحجام عن قبول المشروع، وهو من أساليب الخطاب الشعبوي التي ترى في الخيارات البديلة كافةً؛ وصفة رعب محقّقة. إنها تقول مثلاً “دون دولة ديمقراطية معلمنة سيتقاتل الاسلاميون طوائف ومذاهب ومدارس وتيارات ونِحَل حتى يموت آخر مسلم”؛ فهل هذه حتمية مؤكدة حقاً؟
يذهب الخطاب خطوة أبعد بالحديث عن الشعب ومكوِّناته بصيغة “أنتم” متعالية، وبصفة لا تبتعد عن منطق التصنيف بوصم “الدراويش”. إنها تقول مثلاً: “ما نطرحه من مقترح الديمقراطية المُعلمَنة هو حل للصراع المتزايد في المنطقة والمفتوح على مآلات كارثية بين طوائفكم وجماعاتكم ومذاهبكم ونحلكم، والتي يبدو أنها لن تتوقف قبل إراقة آخر قطرة دم مسلم في المنطقة”. المتحدثة الكريمة، للتذكير، ليست مبعوثة دولية إلى “الشرق الأوسط”، لكنّ نبرتها في هذا الموضع تبدو وفيّة بصفة جارفة لخطاب “مُعلمَن” منزوع الهوية ويحيِّد الشعور بالمشترك الجمعي وروح “نحن” على صعيد الأمة وعلى مستوى القُطر اليمني ذاته؛ وهذا لصالح خطاب أقليوي لا يرى سوى مكوِّنات مبعثرة ومتصارعة لا ينظمها ناظم ولا يجمعها إلاّ حياد تجود به “الديمقراطية المعلمنة” على الأطراف التي ستعيش به ومعه في وئام وسلام يُعلِنان نهاية التاريخ.
ومقابل “أنتم” المأزومة والموصومة تلك؛ تأتي “نحن” المنعّمة والمتحررة في مقام الخلاص الفردوسي مع محاولة لطمأنة مَن أقلقتهم التغريدات الصادمة.. “التديّن الأعظم يحصل فقط في ظل هذا الجوّ (تركيا)، حيث حرية الاختيار وغياب الاكراه. في دولتنا الديمقراطية المُعلمَنة سيكون هناك مئات الآلاف من المساجد والمنابر بالتأكيد”. يبدو الدين، عند كرمان، والتديّن محصوريْن عملياً في المساجد والمنابر والوعظ والإرشاد وأداء الشعائر والأجواء الروحانية التي لا تُناقِش ولا تُسائل ولا تعترض ولا ترفع صوتها، حسب ما يُفهَم من ترويجها للمشروع، لكنهما دين وتديّن مكبّلان في نطاق مضامينهما أيضاً.
لا يصحّ وفق نصوص كرمان أن يصدر أي وعظ أو إرشاد أو تعبيرات دينية، من أي نوع كان، عن المشتغلين بالسياسة. وهكذا يُخطئ الرئيس التركي، إذن، عندما يتلو آيات القرآن الكريم أو يدفع بمواعظ في ثنايا إطلالاته
لا تعمل الشعارات وحدها في الدولة الديمقراطية الحديثة، فهي دولة قانون ومعايير ومؤسسات بالأحرى، بما يقضي بتنزيل الشعارات في تشريعات ونُظم وإجراءات، وهذا يتطلّب تعريف “الدرويش” ومَن يكون تحديداً إن كان للنعت من معنى ومغزى.
لا يشير نصّ كرمان بوضوح إلى مَن يكون هذا “الدرويش” تحديداً بمعايير دولة القانون، كي يُصار إلى حرمانه دون غيره من التعبير السياسي. وستبقى وصفتها “الديمقراطية المُعلمَنة” عرجاء قاصرة إن لم تفترض تشكيل كهنوت إسلامي هيكلي يحتكر الوصاية على “رعيّته”؛ وبهذه الحيلة فقط يمكن الشروع في افتراض محدِّدات أو مواصفات معيارية لتنزيلها على “الدراويش” إياهم، مع كثير من التعسّف في الأحكام والسطوة في التطبيق على أي حال.
ستعجز كلّ خيارات التوصيف المتاحة لفئة “الدراويش” المزعومة عن الاشتغال في ديمقراطية شفافة أو دولة قانون محترمة. فإن اقتضى المعيار، مثلاً، شرطاً في الهيئة؛ ألا يسع أحدهم تغييرها؟ أو لعلها تَشمَل مَن ليس درويشاً كأن يُعفي ذقنه استجابة لصيْحة تصميم مُعوْلمة صاعدة أو لنزعة بوهيمية جارفة. وكيف يسع القوم التفريق بين لحية “دينية” وشبيهة بها “علمانية”؛ دون استحداث شرطة مجتمعية تراقب سلوك “الدراويش” المحتملين وأشباههم؛ مع تزويدها بمعايير قياسية كالتي حملها موظفون عموميون متعجرفون في صيف 2016 لحرمان مسلمة من الجلوس على رمال الشاطئ الفرنسي؛ لمجرد أنها تستر جسدها؟ كانت الواقعة مادة لرسم كاريكاتيري لاذع على صدارة “لوموند” وقتها، ولن تدنو التفاعلات الشبكية في اليمن أو غيره عن هذا المنسوب الساخر عندما تتورّط “الدولة الديمقراطية المعلمنة” في مطاردة مواطنيها بمعاييرها القياسية.
وفيرةٌ هي التأويلات التي يجوز افتراضها لكيفية تنزيل معايير الحظر في الواقع، فإنْ تعلّق معيار الفرز بمؤهِّلات علمية لازمة لبلوغ مرتبة “درويش”، مثلاً، ألا يقضي ذلك بطرد كل النواب من البرلمان الذين سيثبت حصولهم على شهادة “دينية” أو تخصّص “شرعي” أو إجازة في القراءات مثلاً؛ وإن كانوا أطباء ومهندسين ومحامين وفقهاء قانون دستوري أيضاً؟ وإن لم يكن هؤلاء جميعاً معنيين بتصنيف “الدراويش”؛ فمن يكون المعنيّ به إذن؟ وما العمل أيضاً مع من كان “درويشاً” ولم يَعُد كذلك؛ أو من لازم أهل الوعظ والإرشاد معلناً توبته عن موبقات اقترفها؛ من يضبط أمر هؤلاء وهؤلاء في أحقية المشاركة في الشأن العام؟ أفتونا مأجورين!
لا تقضي هذه المناقشة بصرف النظر عن خطايا بعض متصدري الخطاب الديني أو إغفال موبقات سياسية ولغ فيها نفر منهم، كما أنّ تحييد المنابر الدينية عن دعاية الترويج السياسي والاستغلال الحزبي يبقى موضع نقاش وله وجاهته، لكنّ ذلك في جملته لا يعني التساهل مع الوصم التعميمي الذي يأخذ الصالح بجريرة الطالح، أو يختصّ ببواعث المروق “الدراويش” دون غيرهم. وقد شهد اليمن ما يفوق الاحتمال من الحروب والصراعات والمكائد والانقلابات على جبهات متعددة وألوان متفرقة وشعارات شتى، وكان من أشدّها ضراوة، مثلاً، ما وقع ضمن استقطابات دولة اليمن الجنوبي اليسارية التي سبقت إلى إزاحة “الدراويش” وأشباههم جانباً.
من عادة القضم من حقوق المواطنة بعقوبات تصنيفية على أساس تمييزي؛ أن يأتي مشفوعاً بمبررات ذرائعية، وما يستدعي الملاحظة مثلاً أنّ مشروع كرمان “الحتمي والمنشود”، حسب تعبيرها، لا يكتفي بتقييد أحزاب أو مساجد أو مؤسسات دينية؛ بل يتحدّث ضمناً عن فئات مجتمعية ومواطنين أفراد يمكن الإسراف في إسباغ نعت “الدراويش” عليهم. وإن استلَلْنا مفردة “الدراويش” على عمومها أو إطلاقها؛ فإنّ منظور السيدة كرمان يقضي بإخلال جسيم بتوازنات المفاوضة المجتمعية ضمن العملية الديمقراطية؛ على صعيد أطرافها وشركائها، وكذلك على مستوى ثقافة التفاعل السياسي بمنطق قد يُحَيِّد مرجعيات لصالح أخرى.
على النخب الديمقراطية أن تحترس من مقولات قد تدفع هي بذاتها ثمن تطبيقها، كالذي امتدح المقصلة فجرّوه إليها. فإن تحمّس بعضهم لهذه المقولات ثم بانت عليهم آثار الصلاح أو “الإصلاح”؛ صاروا ضحايا محتملين لمنطق إقصائي جارف بعد أن بشّروا بوعوده. وكي لا تسبح الشعارات في أفلاك قاصية؛ يجدر بالناشطة العربية البارزة أن توضِّح إن كانت مقولاتها تسري على مجلس نواب الشعب التونسي أيضاً الذي يتصدّره شيخ معمّم؟ وهل يشفع للقيادي البرلماني المبجّل الشيخ مورو؛ ظهوره بلباس أوروبي أحياناً وبلباس المحامين أحياناً أخرى؛ بما يجيز إدخاله في زمرة المواطنة التي ترسم السيدة توكّل مفهوماً ضيِّقاً لها؟
لا يصحّ وفق نصوص كرمان أن يصدر أي وعظ أو إرشاد أو تعبيرات دينية، من أي نوع كان، عن المشتغلين بالسياسة. وهكذا يُخطئ الرئيس التركي، إذن، عندما يتلو آيات القرآن الكريم أو يدفع بمواعظ في ثنايا إطلالاته، فهو يقترف مخالفةً جسيمة لمعايير الدولة “الديمقراطية المُعلمنة” كما تعرضها العربية الحائزة على جائزة نوبل. قولوا للطيِّب أردوغان أن يكفّ عن هذا، إذن، كي لا يُفضي به المنطق “الديمقراطي المُعَلْمن”، الذي يُراد فرضه عربياً، إلى وَصمِه بنعت “درويش” وإخراجه من الحلبة السياسية كما فُعل به وبغيره من قبل بسطوة “دولة القانون” ذاتها، بما يعيد الثقافة السياسية التركية إلى قرن مضى بمغامراته ونُدوبه. تخوض توكل كرمان حملتها على أهل “الوعظ والإرشاد”، لكنها لا تُفصِح عن نطاق أحكامها وهل ستسري على صنوف الوعظ جميعاً، في أمور الدين والقيم والأفكار والأيديولوجيات؛ أم ستقتصر على الدين السماويّ وحده وحسب.
ما جاءت به صاحبة النصوص يُفهِمنا أنها تعني الوعظ في شأن الدين، لكنهم جميعاً في بلاد العرب يتحدّثون في شؤونه، ساسة ومحكومين، وديمقراطيين وعساكر، ومتستِّرات وسافرات، حسب مشاربهم واصطفافاتهم، فهل ينبغي فرض الحظر على “الدراويش” منهم فقط بتخييرهم بين مجاليْن غير محدّدين هما “السياسي” أو “الديني”؛ وإطلاق أيدي كل من نجا من الوصمة ومرق من الوصف لمجرد أنه حليق الذقن مثلاً، أو تنازل عن عمامته، أو أقحم مفردات إنجليزية في حديثه، أو تخرّج من دورات “لغة الجسد” المُعولَمة؟
إن أطلقنا العنان لخيال خصب كي يذهب بالنصّ إلى مداه؛ فقد نرتقب عهداً عربياً محتوماً تبشِّر به رؤى النخبة “الديمقراطية المُعلمنة”؛ سيفرض تشكيل منظمات مجتمع مدني تنادي بفكّ هذا القيد المفتعل عن حقوق المواطنة والمشاركة وحرية التعبير، وقد تحمل التشكيلات عناوين من قبيل “دراويش بلا حدود”، أو “دراويش بلا قيود”، أسوة بأسماء التشكيلات الحقوقية التي قادتها السيدة كرمان زمنَ علي عبد الله صالح. يا للمفارقة!
تقوم نصوص توكّل كرمان على اضطراب مفاهيمي جسيم، ومن ذلك أنّ العلمانية في مفهومها وواقع تطبيقاتها تقتضي تجسيد الكهنوت وتفترض ترسيم نطاقاته؛ ومع ذلك فإنّ كرمان تعلن أنّ “العلمانية للتخلص من الكهنوت والديمقراطية للتخلص من القيصر”. وبغضّ النظر عن النزعة المركزية الأوروبية الطافحة في هذا الخطاب وإسقاطه التاريخ الأوروبي على الحالة العربية في مقولة “القيصر”؛ فمن قال إنّ العلمانية أنهت الكهنوت حتى في معاقلها؟ ما الذي يفعله بابا الفاتيكان إذن؟ وماذا عن القطاعات الدينية الكنسية بتراتبياتها السلطوية الدينية على الرعيّة؟ ماذا عن التنظيم القانوني والتعاقدي المُبرم بين الدول والكهنوت الكاثوليكي والأرثوذكسي؛ وشبيهه البروتستانتي الذي تخفّف مع مارتن لوثر من نزعة الهيكلة البنيوية لتعظيم مرجعية النص في مقابلها؟ وماذا عن اعتبار الكنائس الإنجيلية واللوثرية والبروتستانتية “كنائس الدولة” أو “كنائس الشعب” في دول أوروبية غربية؛ أليست تجسِّد شرعنة الكهنوت بل تستوعبه في الدولة ولو كان ذلك بصفة طقوسية وبروتوكولية تحكمها أعراف وتعاقدات؟
واقع الحال أنّ الشعارات المطلقة والتغريدات المختزلة والرؤى الخلاصية ووعود نهاية التاريخ لا تتسع سوى لقطعيّات جاهزة وفرضيات انتقائية؛ تبقى وفية لأحكامٍ مسبقة تُذكيها سطوة الواقع وصدماته.
لسنا في مقام مناقشة العلمانية ذاتها، ولا فحص الديمقراطية بالأحرى، ولا تدقيق النظر في مفهوم “الديمقراطية المعلمنة” أيضاً. ففي هذه جميعاً مباحث ومقاربات وزوايا نظر. أمّا الشاغل هنا فهي مقولاتٌ عربية مبثوثة في زمن الحيرة والاضطراب الذي تتناوشه صراعات وأزمات وتحوّلات، وتتعاقب عليه حروب الأفكار وجولات كيّ الوعي، ومنها وعود إطلاقية نثرتها كرمان للجمهرة المكلومة عن “ديمقراطية ذات مضامين علمانية؛ تقف على مسافة متساوية من جميع الاديان والمذاهب ويعيش الجميع في ظلها بحرية ورفاه”.
ومما يقتضي التنبيه أنّ شيوع المزاعم لا يقضي بالتسليم بها كحقائق غير قابلة للنقاش. ومن ذلك أنّ بعض الخطابات تتسرّع بمنح الانطباع بحياد العلمانية إزاء المكوِّنات والأطراف والمشارب، وهي مقولة علمانية تقليدية لا تُلزِم غيرها من المشارب دون فحص أو تمحيص. والزعم ليس دقيقاً هنا، لأنه يحيِّد العلمانية ذاتها من المشارب المتنافسة ويمنحها القدح المعلّى في المشهد المجتمعي والسياسي إلى درجة قد تستحوذ معها في عاجل الأمر أو آجله على عقيدة الدولة والنظام وربما مرجعية الأمة والمجتمع.
تنثر توكل كرمان الوعود المعقودة على ناصية مشروع الدولة “الديمقراطية المعلمنة” بسخاء، وتدفع في سبيل ذلك بمقاربات صارمة ورؤى حالمة تقتضي نظراً وفحصاً
ومن الوهم القول إنّ مشروع كرمان يقتصر على فرض قيود على الأحزاب وتشكّلها على أساس ديني، فما أوردته يتجاوز هذه الجزئية بمراحل، كما أنّ مسألة السمة الدينية للأحزاب لا جديد فيها تقريباً في الواقع العربي وقد تم حسمها منذ عقود في بلدان عدّة تشهد جولات انتخابية متعاقبة.
يوحي بعضهم أنّ “العلمانية” التي يتذرّعون بها ترسم مدوّنة سلوك للحياة السياسية وحسب؛ ولا يلحظون أنها بموجب خطاباتهم ذاتها كفيلة بأن تفرض معايير صارمة على المجال الديني بالأحرى، وعلى ثقافة المجتمع عموماً، ومرجعية الأمّة، مع إجراءات إحلالية قسرية. لهذا المسار تبعات ملموسة في الحياة اليومية، ينبغي المصارحة بها أيضاً، في التعليم والإعلام والثقافة والفنون وأولويات دعم المجتمع المدني وغير ذلك كثير.
ألا يلحظ حاملو الشعارات، أيضاً، أن العلمانية في فلسفاتها ومفاهيمها وفي أنظمتها وتطبيقاتها، هي متعدّدة النسخ والنماذج، وتبقى كل نسخها ونماذجها مفتوحةً على تأويلات واجتهادات متحركة وليست سبكاً مقدّساً لا تبديل له. وقد كانت “العلمانيات” منذ منشئها، ولا زالت، حلبة استعمالية لتحيّزات واستقطابات وتجاذبات وصراعات في داخلها، ولم تكن وحدها الضامن لشراكة متكافئة بين المكوِّنات المجتمعية والأطراف السياسية في مجتمعها وحتى ضمن أي عملية ديمقراطية كانت؛ فكيف بها وقد باشرت الإقصاء وفَرض القيود الانتقائية حتى قبل أن تتنزّل من أوراق بعض النخب العربية ومقولات السيدة توكّل؛ إلى واقع التطبيق وفضاء الممارسة؟
وعندما تشتغل العلمانية، أو العلمانيات المتعددة بالأحرى، في دنيا الناس؛ فإنها تدفع بمقولات وأحكام وتحيّزات ومزايدات، كأي قيمة مرجعية عُليا في أمّتها؛ مثل الحرية، التي تجاوزت التمثال البديع في نيويورك ليشنّ البيت الأبيض حملاته الوحشية باسمها؛ وكان أن أحرق “المارينز” رقاعاً واسعة من العالم الإسلامي تحت لواء “نشر الديمقراطية” وبإذكاء من امبريالية “حقوق الإنسان”.
جدبر بالنظر كيف تتّخذ دول “علمانية” من القيم المرجعية العليا عقيدةً لها، فتُرفَع شعاراً وتُدوَّن دستوراً وتُتّخَذ حجّةً وتغدو مادة وَعظ وإرشاد من منابر الدولة ذاتها ومنصّات الحياة السياسية. إنها في فرنسا “قيم الجمهورية” التي أزاحت الدين فصارت تحاكي ديناً بحياله، وباسمها تُلقَى المواعظ في الإليزيه، وبها يتذرّع سياسيو الإقصاء والتهميش والتفرقة في محاولتهم للانقضاض على فرص مكوِّنات هشّة لا تجد سبيلاً عادلاً للحضور في المشهد أو الصعود في الحياة السياسية. هل ستستثني النخبُ العربية “الديمقراطية المعلمنة” هذا الضربَ من “الوعظ والإرشاد” أم ستتسامح معه في دولتها “الحتمية المنشودة”؟ وما العمل إن بلغ هذا الوعظ حدّ الإتيان على مساحة “الديني” الأصيلة فتزاحمه دون أن يجد “الدراويش” فرصة تعبير سياسية أو مشاركة متكافئة في الشأن العام بالتالي؟
تنثر توكل كرمان الوعود المعقودة على ناصية مشروع الدولة “الديمقراطية المعلمنة” بسخاء، وتدفع في سبيل ذلك بمقاربات صارمة ورؤى حالمة تقتضي نظراً وفحصاً. فهل مقولاتها هذه دقيقة حقاً؛ أم أنها مجازية افتراضية صيغت لعالَم متخيّل؟ هذا ما سنواصل مناقشته في حلقة تالية من المقال، إن شاء الله.
(المصدر: مدونات الجزيرة)