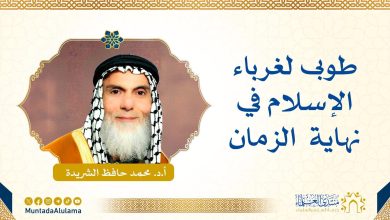حركة حماس في مفترق طرق
بقلم د. وصفي عاشور أبو زيد
بعدما وضعت الحرب أوزارها في معركة سيف القدس، وانقضت بانتصار ملحوظ لحركة حماس وعمت الفرحة أرجاء الأمة المسلمة باستعادة بصيص من الأمل في واقع مدلهم بالانكسارات والتراجع في المشروع الإسلامي، وانهالت التهنئات على الحركة لما حققته من ناحيتين:
من ناحية الداخل من خلال كسر هيبة العدو الصهيوني وجرح كرامته وعلوه وغطرسته مما حدا به إلى شن حرب استهدفت بها البنية التحتية لقطاع غزة حفاظا على كرامتها، وانتصارا لما لحق بسمعتها أمام المجتمع الدولي.
ومن ناحية الخارج، فقد شكلت “سيف القدس” منعطفا تغيرت به ومعه البنية التحتية الفكرية والسياسية للمجتمع الغربي بأفراده وهيئاته وأحيانا مؤسساته الرسمية انتصارا لفلسطين وتغييرا للصورة الذهنية لدولة الاحتلال بما هي دولة إجرامية تمارس كل صور الإجرام والاعتداءات المحرمة والمجرمة، ونشأ جيل جديد يحمل هذه القضية في المحافل المدنية والسياسية الدبلوماسية، ومن ناحية أخرى فإن هذا الانتصار والتغير الدولي قد أتاح لحركة حماس القيام بزيارات عربية استقبلتها فيها أنظمةُ حكمٍ رسمية، وهذا مما يعزز مكانة الحركة ويُعلي أسهمها.
الرؤية الجديدة عند بعض قيادات الحركة
وقد هيأ هذا التغير لبعض قيادات الحركة أن تعيد النظر في استراتيجيتها؛ حيث كانت السياسة أو الاستراتيجية من قبلُ تقضي بأن أهل فلسطين يقومون بحراسة القضية ومشاغلة العدو وتمثيل حائط الصد لها أمام جرائم الاحتلال، وحفظ المقدسات التي هي ملك للأمة المسلمة جمعاء، إلى أن يحين وقت التحرير الذي لن يكون إلا بإسهام مصر وبلاد الشام كما جرت سنة التاريخ.
والآن ترى بعض هذه القيادات أن الأمر يجب أن يتغير طبقًا للتغير الحاصر بعد “سيف القدس”، فقد أصبح النصر والتحرير ممكنا ومرموقا بالعين والمدى القريب المنظور بعد أن كان مقصورا على الإيمان في القلوب وكامنا في اليقين القوي الثابت، ومن ثم لم يعد هناك مسوغ لانتظار الأمة أملا في أن يسهموا الإسهام الجذري والأصلي في التحرير، لا سيما أن علاج مشكلات القاهرة وبغداد ودمشق وطرابلس وصنعاء وتونس أصعب بكثير من علاج مشكلة الاحتلال والتي أصبحت -طبقا لرؤية هذه القيادات- ممكنة ومتاحة بما يفرض خطابا جديدا وتخطيطا جديدا برؤية جديدة.
وهذا التفكير لا يوجد ما يمنعه من حيث التصور وإن كانت سنة التاريخ تقول إن فلسطين لم تتحرر يوما إلا بجهود مصر والشام مع أهل فلسطين المرابطين والمجاهدين، ولكن دعونا نمشي مع هذه الاستراتيجية الجديدة ونسلم بها تحققا وتحقيقا، فأين المشكلة إذن؟!
المنعطف الذي تمر به الحركة
المشكلة تكمن في أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقف على مفترق طرق في هذه اللحظة:
بين أن تستبقي خطاب الأمة وتستنهضها، وتضع طاقاتها بأفرادها وعلمائها وشعوبها ومؤسساتها ضمن هذه الرؤية الجديدة، وتستحضر دائما وأبدا في خطابها الشرعي والفكري والسياسي بُعدَ الأمة وأهمية دورها ومحوريته في عملية التحرير، وأن تؤمن أن مشورع الاحتلال ليس مجرد كيان وإنما مشروع معادٍ للأمة كلها.
وبين أن تستبعد في خطابها بُعد الأمة وتقتصر في خطابها على الداعمين المباشرين، فهذه الأمة – في نظر هذا البعض – لم تقدم لهم شيئا، وهي أمة عاجزة لن تُفيق من مشكلاتها، ولن تنهض بما يليق بها مع قضية فلسطين؛ نظرا لعرقلتها في مشكلاتها الداخلية النازفة التي تستوعب طاقتها ولا تُبقي منها شيئا لقضية فلسطين!.
والخطاب الأخير في الحقيقة ليس جديدا، بل هو موجود من قديم، وهو خطاب فكري وسياسي وتربوي وليس سياسيا فحسب، لكنه الآن يتعاظم بعد “سيف القدس” بما يوجب التأمل فيه والوقوف معه.
هل خطاب الاكتفاء الذاتي مناسب؟!
حركة حماس حركة إسلامية، تستمد قوتها من امتدادها الجغرافي والتاريخي في الأمة، ومن كونها حركة مجاهدة؛ إذ إنها تحمل قضية مقدسة وليست وطنية فقط، وإنما هي قضية أمة ووقف للأمة ومقدسات للأمة وليست للفلسطينيين وحدهم.
من حق حماس أن تقرر لنفسها أن تكون حركة تحرر وطني، وتقطع امتدادها التنظيمي بأي حركات أخرى وإن تربت على فكرها؛ حتى لا يؤثر ذلك عليها سلبيًّا في حركتها ومشروعها، ومن حقها أن تقرر ما تشاء وفق الأطر والإجراءات المقررة داخلها.
ومن أجل أن نصل إلى كلمة معقولة أمام هذا التحول الذي يريده البعض للحركة بعد “سيف القدس” لابد من استحضار عدة أمور:
الأول: أن العدو الصهيوني ليس مجرد مشروع احتلال لقطعة مطلقة من الأرض، بل إن الواجب اعتقاده والإيمان به والانطلاق منه أن دولة الاحتلال هي الممثل للمشروع الغربي الصليبي الصهيوأمريكي، فلولا ما يقدمه هذا المشروع لدولة الاحتلال من دعم غير محدود لما بقي هذا الكيان البغيض يوما واحدا.
الثاني: أن الأرض المحتلة ليست أي أرض، وإنما هي أرض فلسطين وقضية فلسطين، وهي أرض للأمة، وأوقاف للأمة ومقدسات للأمة، وليست مجرد قطعة أرض احتلها أي محتل، وليست الكلمة الأخيرة فيها والنهائية لمن يعيشون عليها ويدافعون مباشرة عنها حتى لو كان خط الدفاع الأول فيها!
الثالث: أن “سيف القدس” لم تكن هي الأشرس ولا الأكثر انتصارا في تاريخ فلسطين أو تاريخ الحركة على الأقل، فهناك من المعارك ما كان أكثر شراسة وأطول مدة، وكانت نتائجه أعظم من “سيف القدس”، وإن كنا في “سيف القدس” أمام تحول في القناعات والتغيرات، على أن الزهو المبالغ فيه بما حدث في “سيف القدس” ينبغي ألا يكون بهذه الدرجة من المبالغة، فالمعركة كما أشرنا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وليست أهم ما جرى، ولو افترضنا ذلك فإن أطرافًا أخرى حاولت استيعاب هذا الانتصار ومحاولات إجهاض منجزاته.
الرابع: أن التاريخ الماضي كله يقرر أن فلسطين لم تحرر نفسها يوما ما، وأن سنة تاريخها في التحرير أن أهلها كانوا يشاغلون الاحتلال حتى أتى المدد الخارجي: فتْحُها في عصر عمر مثالا، وتحريرها في عصر صلاح الدين نموذجا، وأن الرؤية بعيدة المدى ترشح ذلك.
الخامس: أن أرض فلسطين وترابها الشريف قد اختلطت عليه – كما هو ثابت تاريخيا – دماء العراقيين والسوريين والمصريين واللبنانيين والأتراك بدماء الفلسطينيين، وهذه الدماء لها مقتضيات وقتها وبعدها.
السادس: أن الجراحات التي يمر بها كثير من المسلمين، والاعتقالات التي يتعرضون لها، والأحكام التي تصدر بحقهم، وقتل الأنظمة المستبدة لهم، في مصر وسوريا والعراق وغيرها، سببها الرئيس هو حملهم لهم هذه القضية وتكريس حياتهم للعمل لها.
انطلاقا من هذه الحقائق الثابتة، والمسلّمات العقدية والشرعية والفكرية والتاريخية والواقعية، فإن التنكر لهذا كله يعد انحرافًا واضحًا في الفكر والتصور، وفي الحال والمآل على حد سواء، وتنكرًا لدماء الأمة الغالية وتضحياتها النبيلة حتى اليوم، وأحسب أن المتضرر من التوجه الذي يرى التركيز على الداعمين وإضعاف استحضار خطاب الأمة هو القضيةُ نفسها بإطالة أمد الاحتلال، وخسارة هذا الامتداد الواسع والكبير والداعم معنويا وماديا، وإن التركيز على المبادئ وصون التصورات العقدية التي تأسست عليها الحركة، وبها تتحرر الأرض ويحفظ العرض، يجب أن يسود خطابه وتترسخ معالمه، وتواجه هذه الألوان من الخطابات التي قد تكون صادرة عن حسن نية ومصلحة القضية، لكنها -بلا شك- خطأ وانحراف في التصور والممارسة على السواء.