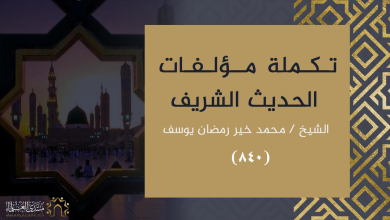تفكيك نظريات الاستبداد الشرقي: الحالة المصرية
بقلم وسام فؤاد
أدت الانتكاسة التي تعرضت لها ثورة يناير إلى فتح الباب للتساؤل عن سبب هذه الانتكاسة، وعما إذا كان السبب في هذه الانتكاسة نخبوي أم جماهيري. من وجهة نظر الباحث، كان الاستسلام لهذا التساؤل يعبر عن قدر من عدم النضج بالنظر لكون يناير 2011 نتاجا لتحرك الجماهير وليس النخبة.
مرت ثورة يناير بمرحلتين أساسيتين. حيث بدأت في مرحلتها الأولى كحركة احتجاج رافضة لما صار مسلكا معتادا للشرطة المصرية. تبلورت الحركة الاحتجاجية في الواقع الافتراضي خلال هذه المرحلة مع مقتل شاب مصري إثر خلاف مع ضابط شرطة، وهو ما أعقبه محاولة لتفسير سبب القتل بأن الشرطة ضبطت الشاب يحوز مخدرات بغرض الإتجار. أدت هذه الوقائع لتحرك بعض أصدقاء الشاب “خالد سعيد”؛ تضامنا معه، لتحويل القضية إلى “تريند”، وقرروا أن يجعلوا عيد الشرطة القادم في مصر (يحتفل به في 25 يناير) مناسبة للاحتجاج ضد تعسف الشرطة في التعامل مع المواطن المصري، وهو ما حدث بالفعل.
قاد اتساع نطاق مشاركة الجماهير في الحدث التمهيدي، وتهور قوات الأمن في مواجهتهم، ووجود إصرار جماهيري على رفض هكذا تهور، والتحرك لمواجهة القوات الأمنية، إلى المرحلة الثانية التي حولت يناير من حركة احتجاجية محدودة الوجهة ومحددة الهدف إلى حركة شعبية، حيث اتجه مديرو صفحة “كلنا خالد سعيد” إلى تعديل الحدث القادم من مجرد احتجاج ضد الشرطة المصرية إلى “جمعة غضب” ضد سلوكيات الدولة ضد المواطن، بما في ذلك سلوكيات الفساد والتوريث والقمع1 .
كانت المشاركة الجماهيرية أكثر نضجا من جهود الشباب الذين تكاتفوا مع حملة “كلنا خالد سعيد”، وبالتأكيد كانت أكثر نضجا من النخبة التي لم تكن تتوقع أن يتمكن هؤلاء “العيال” من الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق “مبارك”. وطيلة عامين في أعقاب الثورة ظلت الجماهير تخرج لتلبية نداءات الحركة السياسية، حتى وإن كانت غير راضية عن الإفراط في الخروج والتظاهر، أو لداعي إنهاكها فيما سبق من فعاليات، لكنها كانت حاضرة وساندت الحضور، حتى خذلتها النخبة، وأعادت لها ما سلف أن احتجت عليه وثارت ضده.
أدى السؤال المغلوط حول “المسؤولية عن انتكاسة ثورة يناير” لاكترار عدد من النظريات “المعلبة”، وأعيد طرح القضية باعتبارها مشكلة مزدوجة، نخبوية – جماهيرية. وبينما تضاءلت الرؤى التفسيرية التي تتحدث عن دور النخبة، وإن اتسع نطاق النقد السياسي لأداء النخبة، وبخاصة جماعة “الإخوان المسلمون”، فإن النظريات المتعلقة بالقصور الجماهيري أعيد إنتاجها بعد “تنقيح”.
ولم يخل الأمر من بعض المراجعة المهتزة لهذه النماذج والنظريات التفسيرية، لكنها لم تق لتفكيك نظرية أرى بوضوح أن التاريخ يكذبها. الدراسة التالية تطرح هذه النظريات على معيار النقد التاريخي.
أ. مشكلة البحث:
ينطلق البحث من اعتبار النظريات التي فسرت ميل المصريين لقبول الاستبداد والاستسلام له هي محض نظريات دعائية لا تصمد أمام حقائق التاريخ. تنطلق هذه النظريات من تعليق قاله فيلسوف اليونان، المعلم أرسطو، لتلميذه الإسكندر المقدوني، يعظه بالتعامل مع شعوب الشرق باعتبارها شعوبا غير حرة، بل إن طبيعة أولئك الناس أقرب للعبيد. وتقفز هذه النظريات عبر التاريخ لتصل لكلمة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه حين وصف أهلها بـ “الخضوع لمن غلب”، وتنتقل النظريات عبر الاستناد لدعاوى فلسفية غير مثبتة تاريخيا بين مونتسكيو في “روح القوانين” وحتى فيلسوف الدولة الأكبر الألماني “جورج هيجل”، وتمر عبر فيلسوف الاشتراكية “كارل ماركس” لتنتهي عند أقدام الأكاديمي “كارل فايتفوجل” في كتابه “الاستبداد الشرقي” الذي يطلق تعميمات تعكس عدم تعرضه للتاريخ المصري بـ “القراءة”.
وتلت هذه الكتابات مشاركات من باحثين أفذاذ في مصر وغيرها من دول العالم، منهم العلامة “جمال حمدان” في رائعته “شخصية مصر”، أو أحمد صادق سعد في “تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصادي”، لتمر من دون أن تقدم فحصا حقيقيا لعلاقة المصريين بالسلطة عبر التاريخ، وهي العلاقة بالغة التركيب، والتي بلغت في محاولات قمع ثورات المصريين وحركاتهم الاحتجاجية حدودا غير مسبوقة من العنف الذي كان يميل للاختتام بمهادنة أو قل “ملاطفة” سياسية تنتهي بخلع هذا الحاكم أو ذاك الوالي، وتعديل سياسات أو الامتناع عن انتهاج أو تكرار سياسات معينة، لتجنب احتجاجات هذا الشعب.
قد يبدو من باب السياسة العملية توجيه “أرسطو” لتلميذه “الإسكندر المقدوني” باستعباد “البرابرة” أو غير اليونانيين، وقد تبدو كراهية الغازي المسلم سببا لكراهية “مونتسكيو” و”هيجل” للشرق وغلبة تصورهم عن الاستبداد الشرقي الذي يصح أن يتعلق بكثير من الخبرات السياسية عبر العالم، وليس فقط في الشرق، لكنها مع غياب التأكيد التجريبي محض روايات أو وجهات نظر، أو على أكثر تسميات التسامح مع هذه الأطروحات أنها تعمل على تقديم تعميم غير ناضج. لكن المشكلة تثور لدي مع إصرار نخبة من الباحثين المصريين على احتذاء هذه المقولات والاستسلام لها، بالرغم مما يتوفر لديهم من داعي المحلية، وكثافة الارتباط بالتاريخ المصري والقدرة على التواصل معه، وهو ما دفعني للظن بأن هكذا نموذج لا يعدو أن يكون دعاية للاستبداد أو استسلاما له أو أنه محاولة للنجاة؛ باستخدام أكثر التعبيرات تقديرا لعلمائنا الذين أثروا العقل المصري الاكاديمي، وربما من حقهم علينا أن نتجاوز عن ضعف أصابهم في مواجهة سلطة ما بعد 1952 التي لم تبق ولم تذر قامة مصرية قادرة على تقديم قيمة مضافة لمشروع الديمقراطية وعلاقاتها بإعمار مصر.
مشكلة البحث تقتصر على محاولة التثبت من كون النظريات المفسرة لتاريخ الاستبداد في العالم العربي محض دعاية، وأنها على أكثر التقديرات موضوعية لا تنطبق على مصر. وتحاول أن تفتح الباب لتقديم إجابة على سؤال يتعلق بسبب وجود استعداد لقبول هكذا قناعة.
ب. فرضية البحث:
ينطلق الباحث في تعاطيه مع مشكلة البحث من مطالعات استطلاعية في التاريخ المصري بعصوره المختلفة، حقب ما قبل الفتح الإسلامي الذي تم بعد تنفيذ معاهدة تسليم الإسكندرية في 10 ديسمبر 641م، ثم حقبة ما بعد الفتح الإسلامي وحتى الفتح العثماني في 1517م. وكانت تركيز الباحث خلال هذه المطالعات على دور المصريين كمجتمع وليس كسلطة. وبينما كانت النماذج والنظريات التفسيرية المتاحة تتدفق حول مسؤولية المصريين كشعب/ مجتمع عن هذه الانتكاسة، كانت القراءة الاستطلاعية للتاريخ – وللحاضر على السواء – تشي بعكس ذلك.
تحدث العلامة “برهان غليون” في كتابه “الدولة ضد الأمة” عن وجود مشترك بين خبرات الاستبداد يتجاوز مقولات التراث الشرقي (كنموذج تفسيري ثقافي مرتبط بالدين)، والاستبداد الشرقي (كنموذج تفسيري اقتصادي منبني على تأثير الجغرافيا على الاقتصاد ومن ثم على السياسة). وفي هذا الكتاب، تساءل برهان غليون عما يدعو لأوجه التشابه بين خبرات الاستبداد عبر معايير عدة للاختلاف. فالاستبداد تكرر باختلاف التاريخ (ففي دولة مثل روسيا نجد الاستبداد الإمبراطوري، ثم الاستبداد السوفيتي، ثم الاستبداد السلطوي في نموذج “بوتين”.. والنماذج كثيرة في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.. إلخ)، كما أن الاستبداد تكرر بحذافيره عبر الجغرافيا (فمن الصين وروسيا في آسيا إلى مختلف خبرات الاستبداد في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ودول أفريقيا المختلفة2 .
إن نماذج الاستبداد عبر متغيري التاريخ والجغرافيا لها دلالاتها في تحجيم أثر المتغير الثقافي كعامل مفسر، فبهذا المعنى لا تعد هذه النظريات التفسيرية قادرة على تفسير حالات لا حصر لها، أبرزها سبب تعمق الديمقراطية في كوريا الجنوبية بينما يشهد الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية نظاما مغرق في الشمولية، ونفس الأمر ينطبق على ألمانيا المنقسمة بعد الحرب العالمية الثانية، كما لا يفسر سبب ثورة المجر على الاتحاد السوفيتي في أوجه في 1956 ثم نزوعها إلى السلطوية.
وبالعودة للتاريخ المصري، نجد أن مختلف المؤرخين تناولوا المواجهات الحادة بين المجتمع والسلطة، منهم من أشار ومنهم من استفاض. بعض هذه المواجهات كلف السلطة حربا طويلة لقمعها. أحد أهم الأمثلة في هذا ثورة الدلتا المصرية كلها ضد الوالي عيسى بن منصور في 216هـ، والتي لم يتمكن الوالي من القضاء عليها إلا بعد معارك كثيرة قادها الإفشين قائد المأمون في ولاية برقة، ولم تهدأ الأمور حتى اضطر المأمون للقدوم بنفسه إلى مصر في 217هـ للقتال بنفسه إلى جاني الإفشين والوالي3 ، ونجح في إخمادها بعد أكثر من ستة أشهر قضاها بنفسه في مصر، وبعد نحو عامين من اندلاعها. هكذا نماذج لعلاقة المصريين بالسلطة لا نجدها محل فحص تاريخي من جانب مساهمي نظرية “الاستبداد الشرقي” و”الشخصية المصرية” ولا محل مراجعة مفاهيمية وسياقية من جانب مساهمي نظريات “الثقافة الشرقية”. اللافت هنا ان عشرات الثورات على مدار التاريخ المصري الوسيط والمعاصر والتي انتهت غالبيتها بتغيير الحاكم، لم تنته بتغيير النظام. وهذه القضية الثانية التي ينبغي أن تشغل الباحثين في الشخصية المصرية.
هذه الاعتبارات دفعت الباحث لوضع فرضيتين بحثيتين:
أولاهما: أن نظريات الاستبداد الشرقي والتراث الشرقي والشخصية القومية غير دالة في تفسير سلوك المصريين تجاه السلطة السياسية.
وثانيهما يغلب عليه أن يكون تساؤلا بحثيا أكثر منه فرضية حول سبب عدم انتهاء عشرات الانتفاضات في مصر لتغيير النظام بدلا من اكتفائها بتغيير الحاكم.
ج. صعوبات البحث:
صعوبة إجراء هذه الدراسة تبدأ وتنتهي مع قلة المصادر وتحيزها. ويلفت الدكتور حسين نصار إلى أن “بعد مصر عن مكانة الحاضرة أدى إلى ضياع كثير من المؤلفات التي صنفها المصريون حول أوضاع بلادهم، ما أدى لنقص المعروف من أخبار ثوراتها مقارنة بدول أخرى مثل العراق والشام”، وينبه نصار إلى أن وفرة الأخبار في حركات الجماهير في العراق والشام كان سببه كون هاتين الدولتين حاضرتين للخلافة، وما يرتبط بهذا التوصيف من اهتمام بالتأريخ للحواضر وما تواجهه من تحديات4 .
وكانت العراق كذلك قبل الدولة العباسية مركزا من مراكز الاحتجاج على الدولة الأموية، ما آل بها لاحقا للانهيار لصالح دول قوية نشأت في الأطراف كالدول العثمانية في الأناضول والطولونية والإخشيدية والأيوبية في مصر والحمدانية في الشام والأموية في الأندلس وغيرها من الدويلات في المغرب والمشرق العربيين. وبرغم عدد الثورات التي حصرها كتاب د. حسين نصار في كتابه “الثورات الشعبية في مصر الإسلامية، إلا أنه يلفت إلى أنه لم يستطع الوقوف على كثير من الفاعليات الثورية وتوابع بعض الهبات الجماهيرية بسبب ضعف التأريخ.
ويتابع القضية “عمرو السكندري” و”أ. ج. سافيج” في مؤلفهما عن تاريخ مصر ما قبل الفتح العثماني ليشيروا إلى أن ما كتبه قدماء المصريين أو معاصروهم لم يصل لنا منه إلا النزر اليسير، وأن أكثره يفتقر إلى إثبات، بحيث لا يجمل بنا الاعتماد على شيء منه ما لم يكن قد أيدته الاستكشافات العديدة، أو استنبط صحته كبار المؤرخين والأثريين 5.
المتابع للقسم الأول من الدراسة سيفاجأ بكم هائل من الاحتجاجات الجماهيرية المصرية منذ الفتح الإسلامي لمصر، وغلبة المواجهات المسلحة عليها انتهاء إلى يوليو 1952، وسيبدو له الأمر وكأن الشخصية المصرية قد شهدت تطفرا هائلا في علاقتها بالسلطة، وفي الاحتجاج على أدائها. وبصرف النظر عن غياب المراجع التاريخية، لا ينبغي أن يلفتنا عن وقائع مهمة ومحدودة تعرض لها المؤرخون لمسيرة مصر التاريخية، حيث يذكر المؤرخون بدء التاريخ المصري المكتوب من عند أعتاب الملك مينا موحد القطرين (3400 ق.م بحسب تقدير “جون أريستيد”، حيث تتواجد تقديرات أخرى تعود بالتاريخ للعام 5500 قبل الميلاد)، ومواجهات ملوك الأسرة الثامنة عشرة من” سقننرع الثاني” وحتى “أحمس” مع الهكسوس مرورا بالمقاومة التي أبداها ما بين الملكين مثل الملك “كامس”6 ، ليبدو أن الأمر من صنع قادة عظام ظهروا من العدم، وكأن هذه الحركة التاريخية لم ترتبط باحتجاجات متعددة ضد مستعمرين استمرت عقودا طويلة من المواجهات، تخللتها جهود للتجسس الصناعي انتهى إلى معرفة سر التطور العسكري للغزاة واستنساخه وتطويره وصولا للحظة المواجهة. وكأن توحيد الملك “مينا”/ “نارمر” للقطرين أتى من العدم بسبب مشروع شخصي لم تسبقه معاناة ومواجهات لعدد من الأسر الحاكمة انتهى للاتجاه لاحتواء السخط عبر قضاء أسر حاكمة على بعضها. غير أن اتساع الدراسات حول مصر القديمة، سواء لمستشرقين أو لتلامذة مصريين لهؤلاء المستشرقين لا يمنع من أن ثمة مركزية في الاهتمام بالسلطة لدى كل من اجرى البحوث عن الأحوال السياسية في مصر القديمة، وكذلك مصر المعاصرة، وكأن الاستشراق أصاب الأكاديميين بهوس لدراسة السلطة، بينما لم نشهد اهتماما بحركة المجتمع إلا فيما ندر.
ينتمي هذا البحث لتيار قوي يسعى لإعادة الاعتبار للمجتمع، وإحلاله في مركز الاهتمام البحث، وتحري وزنه كمتغير مستقل في تاريخ مصر عبر العصور. وهو ما يستتبعه توفير وعي بالمصادر التي ركزت على هذه المساحة – قدر المستطاع.
القسم الأول: الحالة المصرية والصلاحية التفسيرية لنظريات الاستبداد
يختص هذا القسم بفحص صلاحية نظريات تفسير الاستبداد للانطباق على النموذج المصري. وفي الجزء الاول من هذا القسم نعرض لتعريف واف موجز لهذه النظريات، ويتناول الجزء الثاني وقائع التاريخ في علاقتها بهذه النظريات.
أولا: في ملامح النظريات المفسرة للاستبداد الشرقي
تجابه الحركة الوطنية المصرية بما أشير إليه بأنه نوع من التضليل الأكاديمي الذي لا يمكن وصفه بأنه تجاهل للتاريخ المصري برغم تورط علماء أفذاذ في ترتيب هذه النظريات وتسريبها للوعي الجمعي المصري. هذا الجزء يتعلق بتوضيح البنيان النظري لنظريات ثلاثة: أولها “نظرية الاستبداد الشرقي” التي تنتهي لخضوع مطلق من المحكومين لطبقة بيروقراطية احتكارية بسبب طبيعة النظام الاقتصادي.، وثاني النظريات هي نظرية “الشخصية القومية المصرية” التي ترى أن شخصية المجموع المصري نتاج التفاعل بين الجغرافيا والتاريخ التي جعلت آفة مصر في الطغيان الداخلي والاستعمار الخارجي وبينهما يقف الشعب المصري مسؤولا مسؤولية كاملة عن عبوديته وخضوعه. أما النظرية الثالثة فهي نظرية “ثقافة الاستبداد الديني” التي ترصد تراكم خبرات استلاب الحرية لصالح مقولات دينية مبتدعة لإسباغ الشرعية على حكام الدول الإسلامية المتعاقبة.
فما ملامح هذه النظريات؟
أ. الاستبداد الشرقي:
المتتبع لمحاولات صبغ الشعوب الشرقية بصفة الخنوع والخضوع للحاكم المستبد يجدها ترتبط بنزوع عنصري/ استعماري في آن، يتجه لتبرير استخدام الوحشية في التعامل مع الشعوب المحتلة. وفي الأدبيات التاريخية، في معالجته لهذه القضية، ميز أرسطو في “كتاب الأخلاق” بين نوعين من البشر، أعلاهما اليونانيون7 وأدناهما البرابرة، وهم كل ما دون الإغريقيين، ويتحول أولئك إلى عبيد من وجهة نظر أرسطو؛ تحت ما اعتبره ضغوط الثقافة السائدة؛ ويؤكد في هذا السياق أن هذه الرؤية تخص أرسطو من بين فلاسفة اليونان، وربما تأثر به بعض الفلاسفة السوفسطائيين الذين وسعوا نطاق العبودية، لكنها في النهاية تظل رؤية لـ”أرسطو” خالفه فيها آباء الفلسفة اليونانية، ومنهم “أفلاطون” الذي أكد أن الطغيان سمة لفرد يستولي على السلطة بالقوة، ويشيع القهر بين خصومه، ويلاحق من يمتازون بالشجاعة والحكمة وكبر النفس حيث يراهم اكبر خطر عليه. كما أنه يسعى لبناء حالة رضاء عن فترة حكمه بمنح بعض المنافع ومن بينها وهبة الأراضي، وينتج حالة حرب لكي تستمر حاجة الناس إليه 8. ويعكس الفارق بين صياغة كل من أفلاطون وأرسطو مركزية عالية للذات، ونظرة دونية للأطراف الحيطة بهذه الذات اليونانية.
ويلفت د. نصر محمد عارف إلى أن كتابة أرسطو تعكس تناولا عرقيا من جانب العقل الذي شرع في دراسة العقل غير الأوروبي، وهي مسيرة انطلقت مع أرسطو، واستمرت ذات المركزية مع أوروبا المسيحية، حيث “استعاضت المسيحية عن التقسيم الأرسطي بمعار الإيمان، حيث كانت تستبعد كل ما هو غير مسيحي من دائرة الحضارة”9 . وفي هذا الإطار يمكن قراءة التأسيس الثاني لنظرية الاستبداد الشرقي مع مونتسكيو.
تأخذ صيغة “نظرية الاستبداد الشرقي” مع مونتسكيو في “روح القوانين” منحنى جديدا يربط فيه بين الاستبداد والدين الإسلامي، فينقل تهمة “استعذاب الاستبداد” من النطاق العنصري شبه الثقافي الذي صاغها به أرسطو إلى أفق ثقافي أرحب يتضمن الدين الإسلامي كمصدر لقبول الشعوب المتدينة بالإسلام للاستبداد، حيث كتب أن “الحكومة المعتدلة تعد أصلح ما يكون بالنسبة للعالم المسيحي، بينما الحكومة المستبدة هي أصلح ما يكون للعالم الإسلامي”10 ، وهو ما اعتبره إمام عبد الفتاح إمام صياغة غير مدعومة بشواهد وسوابق، فضلا عما تعكسه من “جهل” بطبيعة الديانة الإسلامية، فضلا عما ساقه من نصوص لآباء الديانة المسيحية تكذب المقولة التي ذهب إليها11 .
ويذهب هيجل لما هو أعجب من ذلك. فذلك المفكر الألماني الفذ الذي رأى في الحضارة الجيرمانية شيخوخة الفكر والحضارة، واصفا شيخوخة الفكر باعتبارها قمة النضج، يرى أن الفلسفة تعلمنا أن كل صفات الروح لا توجد إلا بواسطة الحرية. وأنها كلها ليست إلا وسيلة لبلوغ الحرية12 . ويرى أن الطغيان السائد في بلاد المشرق يعود إلى أن الشرقيين لم يتوصلوا إلى أن الروح، أو الإنسان بما هو إنسان، حر، ونظرا إلى أنهم لم يعرفوا ذلك فإنهم لم يكونوا أحرارا، وكل ما عرفوه أن شخصا معينا حر13 .
وفي كتاب العالم الشرقي، يقدم إمام عبد الفتاح إمام قراءة في فكر هيجل وينتهي فيها لمقولته بأن المرحلة الأولى التي تبدأ منها الروح في حركة التاريخ هي “العالم الشرقي: الصين والهند وفارس ومصر. حيث يرى أن كل ما عرفه الشرقيون أن شخصا واحدا حر: وهو الحاكم، أما الباقين فهم عبيد لهذا الحاكم الذي كانت حريته استجابة لنزواته لا تعيينا لذاته، وبالتالي فهو طاغية وليس حرا14 .
وبينما يرى أن العالم الشرقي يمثل مرحلة طفولة العالم، وأن العالم الإغريقي يمثل الشباب، فإنه يصل لنهاية التاريخ المتصلة بعالمه حين يقرر أن العالم بلغ منتهى حكمته مع الأمم الجيرمانية بتأثير المسيحية15 . وفي هذا السياق، يمكننا أن نتفهم موقعه الحضاري وتحيزاته مع نظرته للشرق باعتباره نقيضا كاملا للغرب، وبالتالي فإنه يتسم بغياب العقلانية والطفولية والاستبداد والأنثوية والقوة والبربرية، ولا يخفى ما تحمله هاتان النظرتان من منطلق للتحيز الحضاري، وهو تمييز لم ينظر لحال التداول التي شهدها – على الأقل المشرق الإسلامي بين عدة دول في الشرق وامتدت حتى الغرب الأوروبي، وربما كان الخوف من الظاهرة العثمانية أحد محركات هذا الموقف.
ويوجز د. نزيه نصيف الأيوبي البنية الأساسية لنظريات الاستبداد الشرقي بسجالاتها بين كارل ماركس وفريدريك إنجلز وجورج ليختاين من جهة، وبين آدم سميث وجون ستيوارت ميل وماكس فيبر من جهة ثانية، وإضافات كارل فيتفوجل مرتأيا أن نمط الإنتاج الأسيوي تجاوز التحكم بالنهر – بحسب ماركس – لصالح إنتاج تنظيم ممركز للوظائف الاقتصادية الأساسية من ناحية وسيطرة اقتصاد ريفي يقوم على الاكتفاء الذاتي من ناحية أخرى، بما يعني أن الدولة هي الإقطاعي الأساسي، وهو ما رتب للمركزية الشديدة، والتي أضاف إليها كل من ماكس فيبر وكارل فيتفوجل نشوء بيروقراطية مركزية قوية، ويكون الفرد فيها موضوعا للخوف الشامل والخضوع الشامل والوحدة الشاملة، ويكون البنيان الطبقي متميز الطابع، أما الطبقة الحاكمة فتتمثل في “بيروقراطية احتكارية” 16.
ب. نظرية الشخصية المصرية:
برغم بناء نظرية “الاستبداد الشرقي” للقضية موضع الدراسة بأنها بنية فوقية مؤسسة على بنية تحتية من نمط الإنتاج الخراجي المرتبط بالنهر، يرى جمال حمدان أن القضية ثقافية، وأنها تعود إلى “التخلف”17 . ويرى أن مصر تعاني بسبب طبيعتها تأثير الجغرافيا لآفتين خطيرتين، هما: الطغاة في الداخل والاستعمار من الخارج، ويرى أن “هاتين الآفتين جانبين لشئ واحد، وأن بينهما علاقة مباشرة هي علاقة السبب بالنتيجة. فنحن – كما يقول – “كشعب نخضع بانتظام لحكامنا الطغاة، وحكامنا يركعون بسهولة للأجانب الغزاة”. ويرى أن المصريين يبرأون ساحتهم “من هذا الوقر المزدوج القاصم لظهورنا بمقولة أننا ببساطة شعب مغلوب على أمره مفترى عليه، وأن الفاعل المباشر هو الطغيان، والمجرم الأكبر هو الاستعمار. ومن جانبه، فإن الطغيان الداخلي بدوره يزيح المسؤولية عن كاهله مسارعا، بكل ترحيب، بإلقائها على عاتق الاستعمار الآثم الزنيم”.
ويتهكم حمدان على عملية إلقاء المسؤولية مباشرة على الشعب الخاضع للطغيان، يقول: “إننا بتبريرنا تعرضنا للغزو بإلقاء اللوم على الاستعمار نكون قد وضعنا لأنفسنا سلما مريحا ومرضيا (ولكنه كما سنرى مقلوبا رأسا على عقب) من المسؤولية، قمته الاستعمار، وقاعدته الشعب نفسه، ويأتي بينهما – على استحياء أحيانا – الطغيان المحلي، وبعد أن يؤكد على أن “كبرى الآفتين ليست الاستعمار، بل الطغيان المحلي”، نجده يؤكد كذلك على “أن مسؤولية الطغيان تتضاءل أمام مسؤولية الشعب نفسه”، ويحيل إلى مقولة الكواكبي الأثيرة: “إن مبعث الاستبداد هو غفلة الأمة”18. ويؤسس جمال حمدان لنظرية الاستبداد الثقافية بتأكيده على أنه “إلى جانب إرث الماضي التعيس، يأتي التخلف الحضاري ومعه التخلف الثقافي والفكري فيحكم على الشعب بالتخلف السياسي”. ويرى حمدان أن الحضارة والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، فالحضارة هي الديمقراطية والديمقراطية هي الحضارة بقدر ما إن الدكتاتورية هي التخلف والتخلف هو الديكتاتورية، وما الدكتاتورية في عصرنا الراهن إلا الصيغة العصرية من عبودية العصور القديمة، فالفرد والمجتمع تحتها عبيد للحاكم في صورة مقنعة أو مبرقعة، مخففة أو ملطفة” 19.
ج. نظرية الاستبداد الديني:
إلى جانب هذه النظرية في الاقتصاد السياسي، ثمة نظرية أخرى في الثقافة السياسية تربط بين الاستبداد وما ترسخ في عقل المصريين من الثقافة الموروثة عن الدول الإسلامية التي حكمت العالم العربي والإسلامي، ومن ضمنها مصر. يرفض انصار هذه النظرية الاصطدام بالدين الإسلامي، ويؤكدون أن السمة الغالبة للتاريخ العربي هي سمة الاستبداد ماعدا بعض البقع الزمنية المحدودة والطارئة (دولة الرسول في المدينة , الخلفاء الراشدين , عمر بن عبد العزيز، ويؤكد أن عمر الاستبداد وثقافته يمتد الى ما قبل الإسلام؛ العصر الجاهلي القبلي والإمبراطوريات القديمة الرومانية والفارسية التي سيطرت على المنطقة العربية شرقاً وغرباً، والتي كان فيها الحاكم إلهاً أو نائب الإله، وما بعد الإسلام بقيام ما سمي في الثقافة السياسية الإسلامية (الملك العضوض بعد أن كانت خلافة راشدة). يرون في هذا الإطار أن الإمبراطوريات الإسلامية (الأموية والعباسية، والمملوكية, والعثمانية) قد ورثت أنظمة الإمبراطوريات القديمة نفسها ولكن بلون إسلامي فقط.
ويربط ذلك التيار هذه الثقافة بدعم الدولة الأموية لمفهوم “القضاء والقدر” بلوغا لحد القول بعقيدة “الجبر”، وباعتماد الدولة العباسية مفهوم “إرادة الله” كأساس للدولة؛ ما بلغ بالعباسيين حد تأليه خلفائهم؛ هذا فضلا عن الدور السياسي للقول بعقيدة المعتزلة في “خلق القرآن؛ وهي العقيدة التي أراد منها العباسيون التسوية بين الخليفة والقرآن وتبرير مخالفة الخليفة للقرآن باعتبارهما أندادا، كما اعتمد المذهب الشيعي ودوله المختلفة مفهوم “العصمة”. ويضاف إلى ذلك كله توظيف علماء الدين لإقرار العقائد الداعمة لمشروعية الدول الإسلامية، والتأكيد على مبدأ الرضا والسمع والطاعة، وإجازة حكم الإمام المتغلب. ويرى أنصار هذا الاتجاه أن حركات ما بعد الاستقلال فشلت في تحقيق نموذج ديمقراطي حقيقي لمجتمعاتها لأن الموروث التاريخي الاستبدادي كان أكثر قوة وحضورا في تكوينها وآلياتها وأساليبها من قوة وحضور أهدافها وشعاراتها20 .
ثانيا: تتبع تاريخي لعلاقة المصريين بالسلطة
دعاية “الاستبداد الشرقي” كانت من التكثيف والتأثير بمكان بحيث استبطنها كثير من المفكرين العرب والمسلمين، ناهيك عما وجدت له من دعم عبر كتابات عدد من المفكرين، ومنهم أحمد صادق سعد في رؤيته لـ”تاريخ مصر الاجتماعي الاقتصادي”. بل إن إمام عبد الفتاح إمام الذي اتهم دوائر منتجي النظرية من فلاسفة اليونان بأنهم عنصريون، ومن دوائر الحضارة المسيحية بأنهم لم يقرأوا عن الإسلام وتعاليمه، يذهب هو الآخر إلى القول بأن عذر مونتسكيو ومن ذهب مذهبه أن “التاريخ الإسلامي كله كان يسيطر عليه الطغاة، فظن – للأسف – أن هذا ما يدعو إليه الإسلام، وأن الحاكم المسلم لابد وان يكون طاغية بطبعه، وأن المسلمين لا يصلحون للحكم الديمقراطي. وبرغم أنه أكد لاحقا خطأ هذه النظريات كصيغة مطلقة21 ، إلا أن مصر – كجزء من العالم الإسلامي – لم تشهد حراكا ثوريا كذاك التي شهدته خلال فترة ما بعد الفتح الإسلامي وحتى انقلاب يوليو 1952.
أ. الجماهير والسلطة في مصر في فترة ما قبل الفتح الإسلامي
المتأمل لمعالجات العلاقة بين الجماهير والسلطة في مصر الفرعونية، يجد أننا أمام اتجاهين أساسيين:
1. الاتجاه الأول يتجاهل وجود الجماهير في سلوك السلطة، فيحدثنا عن بدء الممالك وانتهائها على أيدي ملوك من ممالك أخرى، وبناء الدول المختلفة القديمة والوسطى والحديثة، ويحدثوننا عن قهر الغزاة الهكسوس والفرس واللوبيين، ثم غزو الإغريق ثم الرومان، ثم الفتح الإسلامي. أحد أبعاد هذا النمط من أنماط المعالجة تختزل تاريخ مصر القديم في “مشروعات السلطة والممالك” و”أحلام وطموحات الفراعين”. وفي اتجاه المستشرقين وعلماء الآثار للتأريخ لمصر كان المركز بالنسبة لهم حكم الأسر الملكية22 ، حيث قسموا التاريخ المصري منذ حكم الملك مينا إلى 31 أسرة ملكية، قسموها لثلاث طبقات (الدول القديمة والوسطى والحديثة)23 .
وربما كان الوقوف على التاريخ المصري القديم من هذه الزاوية مرهون بمنهج المعرفة. ففي النهاية وبعيدا عن كتابات المؤرخين من حضارات احتكت بالحضارة المصرية القديمة، فإن الوقوف على التاريخ المصري من مصادره بدأ مع اكتشاف الحملة الفرنسية لحجر رشيد، وفك دلالات رموز الكتابة الهيروغليفية عبر المقارنة ما بين النصين غير الهيروغليفيين (الإغريقي والديموتيقي: وهو اللغة المصرية القديمة الدارجة)24 ، وهو ما مكن من قراءة الكتابة على جدران المعابد والمقابر الفرعونية، وكلها رموز سلطوية.
2. الاتجاه الثاني فيتحدث، في نفس إطار علاقة المصريين بالسلطة، عن وقوف المصريين عند حد الشكوى للملوك والولاة، ودرجات حدتها المتصاعدة، بضرب أمثلة من الشكاوى التسعة التي رفعها “الفلاح الفصيح” “خون آنبو” للملك “نب كاو رع” أحد ملوك “إهناسيا” من الأسرة العاشرة، وشكوى “رع سنب”25 . كما يتحدث أنصار هذا الاتجاه كذلك عن وصايا الملوك لأبنائهم بالعدل والإنصات لشكوى المظلوم، كما في حالة وصية الملك “بتاح حوتب” لابنه والتي تعود للأسرة القديمة في نحو 3000 ق. م26 . ويخلص الباحثون من تحليل تلك الشكاوى لمكانة الحاكم الإله وعلاقته بالحقيقة والعدل (ماعت) التي وفرت ما يشبه العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، الذي تتضح فيه حقوق الرعية بقدر ما إن حقوق الملك/ الإله واضحة جلية، وأن شكوى الرعية وحرية تعبيرهم عما حاق بهم من ظلم كانت ظاهرة حاضرة وذات تأثير إيجابي في تحقيق العدالة27 .
3. الاتجاه الغائب: هكذا معالجة تجاهلت العامل الاجتماعي والجماهيري خلف تلك الحركة التاريخية، وكأن الأمر من صنع قادة عظام ظهروا وسط حالة من العدم الاجتماعي، وكأن هذه الحركة التاريخية لم ترتبط باحتجاجات متعددة ضد مستعمرين استمرت عقودا طويلة من المواجهات، تخللتها جهود للتجسس الصناعي انتهى إلى معرفة سر التطور العسكري للغزاة واستنساخه وتطويره وصولا للحظة المواجهة. وكأن توحيد الملك “مينا/ نارمر” للقطرين أتى من العدم بسبب مشروع شخصي لم تسبقه معاناة ومواجهات لعدد من الأسر الحاكمة انتهى للاتجاه لاحتواء السخط عبر قضاء أسر حاكمة على بعضها. هناك من المكتشفات في التاريخ الفرعوني ما لم يوجه له الباحثون عن الشخصية القومية جهد يذكر. فمن جهة، لم تول بردية “تفر تي” التي تتحدث عن أبرز الثورات الاجتماعية في تاريخ مصر القديم، وهي بردية يرجح المؤرخون أنها كتبت في عهد الملك “أمنمحات الأول” من أوائل ملوك الأسرة الثانية عشرة. وتتحدث البردية المحفوظة في متحف “لينينجراد” في روسيا عن عملية تعبئة قوية قام بها نخبة من الأثرياء لترتيب ثورة شعبية وإنهاء حكم الأسرة الحادية عشرة في مصر28 .
وبرغم أن دراسة غزو القبائل الأسيوية الهندو أوروبية المعروفة باسم “الهكسوس” لمصر يرتبط بحالة فوضى سياسية اجتاحت مصر، فإن الدراسات التاريخية لهذه الفترة اقتصرت كذلك على دراسة الملوك والأسر والمعابد، ولم تعن بتقصي تاريخ سقوط الأسر الثالثة عشرة والرابعة عشرة وارتباطاتها بانتفاضات جماهيرية مكنت لما وصفه سمير اديب بتعدد الأسر الحاكمة، حيث لم تسيطر على مصر أسرة واحدة خلال أكثر من 150 عاما، ما انتهى بالأمر إلى سقوط الإقليم المصري بأسره في يد الهكسوس مكونين ما يعرفه العلماء والمؤرخون باسم الأسرة الخامسة عشرة (الهكسوس الكبار) ثم السادسة عشرة (الهكسوس الصغار) حيث تراجعت مع هذه الأخيرة سيطرة الهكسوس على كامل التراب المصري، ما سمح لحركة اجتماعية/ سياسية بتأسيس الأسرة السابعة عشرة التي تمكنت من مواجهة الهكسوس29 . ويبقى الشاهد هنا أن تحدي سلطة الهكسوس جاء على مرحلتين، اولاهما تحرير صعيد مصر، وهو ما ارتبط بحركة اجتماعية أدت لنشوء الأسرة السابعة عشرة، ثم تتويج المقاومة بإخراجهم من مصر تماما في القرن الخامس عشر قبل الميلاد.
ملمح آخر مما وصلنا من تاريخ المصريين الاحتجاجي كذلك ما يعرف باسم “ثورة طيبة” ضد الملك البطلمي “بطليموس الرابع” أو “فيلوباتور” الذي انتهت فترة حكمه لمصر في 197 قبل الميلاد. ربما نجد في قص أخبار هذه الثورة ما يشير لدور “فيضان النيل” في كبح احتجاج المصريين، لكنه ينفي عمليا أي أساس إمبريقي لنظرية نمط الإنتاج الريعي وأثر المجتمع النهري. فقد أدت سياسات “فيلوباتور” إلى تراجع الزراعة والنشاط الاقتصادي من ورائها، كما واجه ضعفا في النشاط التجاري بسبب فقدان مصر لممتلكاتها خارج حدودها؛ باستثناء قبرص وبرقة، ما دفع المصريين لمواجهته بعنف، وحاول خلفة، الملك “بطليموس الخامس” أو “أبيفانيس” استرضاء المصريين حتى جاء الفيضان في 196 ق.م. ليتغير معه توجه “أبيفانيس” لقمع الثورة بوحشية وإعدام قادتها بعد إذلالهم، حتى نشبت ثورة طيبة لتصل حد إعلان الاستقلال عن حكم البطالمة في 187 ق.م.
ويذكر المؤرخ سمير أديب أن سقوط الدولة الثورية تم بعد أعوام وحروب عدة، وأن هذه الثورة لم تكد تخمد حتى واجه “أبيفانيس” ثورة جديدة في دلتا مصر، وهي الثورة التي لم تنته إلا بإلغاء الضرائب، وصدور عفو شامل عن الجنود الذين ساندوا الثورة، ومنح كهنة آمون امتيازات جديدة، ومنح قادة الثورة مناصب عليا في الدولة وغدارة الجيش30 .
ولم يصمت المصريون إزاء الحكم الروماني كذلك، ويذكر المؤرخون أن المصريون هادنوا الولاة الرومان الذين اعتنوا بالبلاد ونظموا توزيع ثرواتها بصورة استثمارية، وهي فترة تمثل الشطر الأعظم من تاريخ الوجود الروماني، لكنهم لم يتوانوا عن الثورة ضد الوالي الفاسد، بل إن أكبر الثورات ضد ولاة الرومان وقعت خلال زيارة “جرمانيكوس” ولي عهد الإمبراطور الروماني “تيبريوس” لمصر في 18 – 19م. هذا بالإضافة للحرب الأهلية التي قامت بين أهل الإسكندرية من الوثنيين واليهود خلال فترة حكم الإمبراطور “كاليجولا” بسبب مشاركة اليهود للإمبراطور في التضييق على المصريين، وبلغ الأمر حد وصف المؤرخين حزن الإمبراطور دقلديانوس على حال الإسكندرية بسبب قمعه الثورات والهبات الاجتماعية، سواء للمسيحيين أو الوثنيين من المصريين والإغريقيين، إلى الحد الذي أضر بمباني المدينة التي تهدمت جراء الحروب والمعارك المتوالية31 . وفي إطار الحراك الاحتجاجي المصري جاءت معاونة المصريين، وبخاصة الأقباط للفاتح الإسلامي عمرو بن العاص32 .
لا شك في أن ضعف المصادر عن هذه الفترة سبب من أسباب عدم وجود تفاصيل كافية عن الحركات الاحتجاجية المصرية، فتطوافة سريعة في كتابات المؤرخين جعلتنا نخرج بتصور قاطع مفاده أن خنوع المصريين القدماء للسلطة، والاستسلام لها، أمر ليس بالصحيح. لكن الصورة تتضح أكثر حول مواقف المصريين من السلطة، ومواجهتهم العنيفة لها بعد الفتح الإسلامي لمصر لأسباب ثقافية واقتصادية بالأساس، وتكشف عن التحول الذي بدأ يطال المسيحية من عقيدة ثورية أدت لاستقلال الكنيسة المصرية إلى بناء نموذج مهادنة السلطة السياسية.
ب. الجماهير والسلطة في مصر الإسلامية قبل الفتح العثماني
فيما يتعلق بفترة ما بعد الفتح الإسلامي، يميز د. حسين نصار بين 4 مسارات ثورية في تاريخ مصر الإسلامية، مساران منهما مبنيان على معيار الصدام، صنف فيه ثورات المصريين بين دموية وبيضاء، وهناك ضربان آخران منبنيان على معيار طبيعة الأسباب، حيث يلفت إلى أن بعض الثورات التي عرفتها مصر كانت بتأثير أحداث ثورية محيطة بمصر صار لها انعكاس داخلي، ومنها ما كان خاصا بمصر مما له مسببات محلية33 .
ويتحدث د. نصار عن “الفتنة الكبرى”، وكيف أدت لانقسام داخل المجتمع المصري المسلم حديثا وانقسامه بين “عثمانيين” أيدوا الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ورفضوا جهود خلعه، ورفضوا المشاركة في “الفتنة” وبين “علويين” شايعوا الخليفة الرابع “علي بن أبي طالب” رضي الله عنه، وأيدوا دعوة كونه أحق بالخلافة، ويلفت إلى أن أشد المشاركين في أحداث هذه الفتنة وطأة على الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه هم المشايعون للخليفة الرابع من أهل مصر، بل إن ابن جرير الطبري يرى أن قاتل “عثمان” مصري يدعى “عبد الرحمن بن عديس”. كما ِأشار إلى أن المصريين تمكنوا من استقطاب الصحابي الجليل “عمار بن ياسر” رضي الله عنه لصفوفهم عندما أوفد إلى مصر لتقصي الفتنة فيها.
ومن خروجات المصريين في إطار هذا الصراع، خروج أنصار الخليفة الثالث عثمان بقيادة “معاوية بن حديج” على الوالي “محمد بن أي حذيفة”، والي مصر من قبل الخليفة “علي بن أبي طالب” ري الله عنه بعد حادث مقتل أمير المؤمنين “عثمان بن عفان” رضي الله عنه، والمعارك التي دارت بين الطرفين في “دقناش” (بمحافظة المنيا اليوم)، ثم معركة “حربتا” (بمحافظة البحيرة اليوم)، هذا فضلا عن سلسلة من الخروجات، أبرزها خروج موالي عثمان على والي مصر “محمد بن أبي بكر” الصديق وتحالفهم مع معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص في “موقعة المسناة” وهزيمتهم لابن أبي بكر، لتدخل مصر بعدها في طاعة الأمويين من دون حضور علوي يذكر34 .
ومع قيام الدولة العباسية، عاد العلويون للظهور مع الدعوة للإمام “محمد بن عبد الله” المعروف بـ”النفس الزكية”، وشهدت مصر حركات مسلحة مثل حركة “خالد بن سعيد الصدفي”، ومساندتهم لخروج “محمد بن علي بن الحسين” في 248هـ، وخروج “بغا الأكبر” وهو مصري يحمل اسم “محمد بن إبراهيم” وخرج بالصعيد في 254هـ، ثم خروج “بغا الأصغر” وهو مصري يحمل اسم “محمد بن طباطبا” في أوائل عهد “أحمد بن طولون” في 255هـ في العلمين؛ ثم خروج ابن الصوفي العلوي في “إسنا” بصعيد مصر في نفس العام، وخروج “أبو الروح سكن” في منطقة الإسكندرية في 260هـ. هذا بالإضافة لخروج “ابن السراج محمد بن يحيى” على “محمد بن طغج الإخشيد” في 330هـ، وتوجت جهود العلويين في مصر بالفتح الفاطمي. وإن كان من أثر لثورات المصريين المساندة للعلويين فإنها دفعت الولاة في العصرين الأموي والعباسي لمداهنة المصريين والتخفيف عنهم في الفترات التي أعقبت الخروج35 .
لم يكن العلويون وحدهم أصحاب الدعوات الاحتجاجية والخروجية في مصر، فالأمويون أيضا لهم في ذلك باع، وكان خروجهم خروج معاش لا خروج عصبية، أي أن خروجهم كان لاعتبارات اجتماعية – اقتصادية. رضي الأمويون بالعيش في كنف قيس بن سعد والي مصر من قبل الإمام علي رضي الله عنه، حيث كان يداهنهم، فلما ولي الأمر “محمد بن أبي بكر” الصديق وتنكر لموالي عثمان خرج عليه محمد بن حديج، وتحول آل عثمان إلى “أمويين”. وبرغم كثرة خروج الأمويين مع تأسيس الدولة العباسية، إلا أن خروجهم كان خروج نسب، لم يشارك فيه المصريين إلا جندا. ومن بين ثورات المصريين ثورة الشراة ضد والي مصر من قبل الأمويين “قرة بن شريك” في 91هـ، ثم خروج “وهيب اليحصبي” في 117هـ، ثم خروج “بني تجيب” في 128هـ، لكنه كان خروجا ذا طابع ديني أكثر منه فيما يخص المعاش، وكان الخوارج يتمركزون في منطقة الواحات في غرب مصر ويبدو أنهم قرروا اعتزال القتال وانزووا بعيدا عن مصر الملتهبة بمواجهات العلويين والعثمانيين/ الأمويين، حتى وفد إليهم “دحية بن المعصب” وطلب نصرتهم في مواجهة الوالي العباسي “إبراهيم ابن صالح” في 165هـ؛ فأجابوه بأنهم لا يقاتلون إلا مع أهل دعوتهم من الخوارج، فأوهمهم أنه من أهل الخروج فنصروه حتى رأوا منه محاباة للعرب على المسلمين من غير العرب، فامتحنوه فأقر لهم بالحقيقة، فتركوه ما أدى لهزيمته ومقتله في 167هـ36 .
غير أن قطاعا واسعا من خروج المصريين كان لأسباب اقتصادية. وكان عهد الدولة الأموية في مصر مفعما بالخروج ذي الطابع الديني أو القومي. إلا أن مصر كانت خلال حكم العباسيين بشطريه الأول والثاني في حالة ثورة دائمة يبلغ معدلها كل عامين، تارة بسبب زيادة الخراج، وأخرى بسبب قلة النفقات الموجهة للأرض المصرية، وثالثة بسبب فرض ضرائب جديدة، وأخرى بسبب التحايل لزيادة الخراج، ولم تسترح مصر من هذا الرهق إلا في عهدي الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية. وكان من بين ثورات المصريين خروج مشترك بين الأقباط والعرب على والي مصر في عهد الخليفة الأموي “هشام بن عبد الملك” بسبب زيادة الخراج على الأرض الزراعية من دينار إلى دينا وقيراط، وكان ذلك في 107هـ.
وثمة أيضا ثورة الجنود المصريين ضد “حسان بن عتاهية” بسبب تضييقه في أرزاق الجند، حيث خلعوه لينصبوا سلفه “حفص بن الوليد”، وبلغ الأمر أن طالبوا بخلع الخليفة الأموي الأخير “مروان بن محمد” حين أصر على خلع “ابن الوليد” وتولية “حنظلة بن صفوان”، وحاربوا جيش “حنظلة” ومنعوه من دخول الفسطاط، وبدأت هذه الحركة في 124هـ واستمرت 3 سنوات. وعلى نفس المنوال ثار أهل الحوف واليمانية (مصريون ذوو أصول عربية) على الوالي العباسي “موسى بن مصعب الخثعمي” في 167هـ عندما ضاعف الخراج وارتشى في الأحكام، ولم تخمد الثورة إلا بعد أكثر من عام عندما أرسل الخليفة العباسي جيشا ضخما مع الوالي الجديد “الفضل بن صالح”.
وتكرر نفس الأمر في عين المنطقة مع الوالي العباسي “إسحاق بن سليمان” عندما ضاعف الخراج؛ فحاربوه وهزموه حتى أرسل هارون الرشيد جيشا ضخما فرفضوا القتال وأدوا الخراج. وفي ولاية “الليث بن فضل” الذي قام بمسح الأرض ودلس في مساحتها ليزيد الخراج، فأبى عليه أهل الحوف كذلك فقاتلهم وهزمهم، لكنهم برغم هزيمتهم لم يؤدوا الخراج؛ فطلب جيشا من الخليفة العباسي “هارون الرشيد” في 187هـ، فعين “الرشيد” بدلا منه على الخراج “محفوظ بن سليمان” الذي تعهد بالإتيان بالخراج بدون قتال. كما ثار المصريون في 193هـ على “الحسن بن التختاج” والي الخليفة العباسي “المأمون” الذي دفع عطايا الناس حبوبا ومتاعا، وشاركهم في ثورتهم أهل الرملة في فلسطين. وفي العام التالي ثاروا ضد والي المعتصم “حاتم بن هرثمة” وخرجوا عليه ما اضطره لقتالهم.
ونفس الموقف وقفوه من “صالح بن شيرزاد” والي الخليفة العباسي “المعتصم” حيث حاربوه بسبب الخراج وقاتلوا جيشه وهزموه في 214هـ. وثمة كذلك ثورة المطرية ضد الوالي العباسي “عيسى بن يزيد الجلودي” في 214هـ. وكذلك ثورة الدلتا المصرية كلها ضد الوالي “عيسى بن منصور” في 216هـ، والتي لم يتمكن الوالي من القضاء عليها إلا بعد معارك كثيرة قادها “الإفشين” قائد جيش “المأمون” في ولاية برقة، ولم تهدأ الأمور حتى اضطر الخليفة “المأمون” للقدوم بنفسه إلى مصر في 217هـ للقتال بنفسه إلى جانب “الإفشين” والوالي. هذا بالإضافة لخروج “الجروي” في 219هـ37 .
ويرصد د. نصار استقر حال أهل مصر خلال فترتي الدولتين الطولونية ومعظم فترة حكم الإخشيد. ويلفت إلى أنه بين فترتي الطولونية والإخشيدية شهدت مصر ثورات عدة بين الأهالي والجند، لكن كان أغلبها من تمردات الجند بسبب إسقاط عطايا قطاع منهم38 . غير أن نهاية الدولة الإخشيدية مع السفه في إنفاق السلطان “خمارويه”، وسوء إدارة “كافور الإخشيدي” (905 – 968م) أدى لضعف الدولة، وانتشار القحط والوباء، وضعفت قدرة الدولة عن صد الطامعين فيها من القرامطة والنوبيين، وهو ما أدى لمساندة المصريين للدعوة الفاطمية39 .
السلوك المجتمعي المصري الذي شهد هذه القفزة من الانضباط في اداء الدولة إلى التردي الذي أعقب حفل زفاف ابنة “خمارويه” (884- 896م)، والذي أدى لترد غير مسبوق في التاريخ المصري، أديا بالمجتمع إلى البحث عن دولة بديلة، فما كان الاحتجاج ليكون الأسلوب الأمثل في مواجهة السقوط؛ لأنه كان راجحا أن يؤدي لمزيد سقوط في دولة لم يكن بإمكان رعاياها دفن موتاهم بسبب الوباء.
لم تكن دعاوى الخروج والثورة وأحداثهما حكرا على المسلمين، حيث كان للأقباط نصيب وافر من الثورات في مصر الإسلامية. ولم يكن خروجهم لدواع دينية، بل تعلق بأعمال الخراج ومكامن إنفاقه. وإلى جانب ثورة 107هـ التي شارك فيها الأقباط مشاركة ومبادرة بسبب قيام “عبيد الله بن الحبحاب” صاحب الخراج بزيادته، نجد ثورتهم على “حنظلة بن صفوان” في 121هـ، وثمة أيضا ثورة “يحنس القبطي” ضد جيش الخليفة الأموي “عبد الملك بن مروان” في 132هـ، ثم ثورة أقباط رشيد ضد الخليفة الأموي “مروان بن محمد” الذي هرب لمصر بعد غلبة العباسيين في نفس العام 132هـ، وهناك ثورة “سمنود” القبطية بزعامة “أبو مينا” في 135هـ، ثم ثورة أقباط “سخا” ضد “يزيد بن حاتم المهلبي” في 150هـ؛ والتي ألحقت به هزيمة قوية؛ حتى عزله الخليفة وولى محله “موسى بن علي بن رباح” فهزمهم، وتجددت ثورتهم في 156هـ فهزمهم مجددا.
وهدأت مصر حتى الثورة الكبرى في 216هـ إبان حكم الخليفة “المأمون”، والتي أشرنا إليها عاليه، وشارك فيها المسلمون والأقباط معا. وخلال هذه الثورة، رفض الأقباط دعوة “البطريرك يوساب” بالامتناع عن القتال بحسب الأسقف والمؤرخ القبطي “ساويرس بن المقفع”، وكانت خسائر الثوار فادحة، وكانت خسائر الأقباط من الفداحة بمكان بحيث لم يثوروا بعد ذلك40 .
وبالإضافة لكل هذه الفعاليات، أورد د. حسين نصار قائمة تضمنت 7 ثورات غير معروفة الأسباب، أكبرها ثورة “جابر بن الوليد” التي جمعت مسلمين وأقباطا في 250هـ، واضطر الخليفة العباسي إلى إرسال جيش كبير بقيادة “مزاحم بن خاقان” واستمرت عملية قمع هذه الثورة نحو عامين لتنتهي في خواتيم 254هـ41 .
كانت الأحداث السابقة تتعلق بالثورات التي انطوت على مواجهة مسلحة بين المصريين وولاتهم، وتدخل الخلفاء في بعض هذه المواجهات بأنفسهم وجيوشهم. غير أن مصر شهدت مقاومة بدون دماء. من أبرز الأحداث من هذا القبيل رفض المصرين من استخلفه والي مصر “عتبة بن ابي سفيان” خلال زيارته لمقر الخلافة في الشام، حيث استخلف “عبد الله بن قيس التجيبي” فرفض المصريون ولايته في 43هـ لشدته، فعاد عتبة لتدارك الأمر قبل اشتداده. كما رفض المصريون والي مصر من قبل الخليفة الأموي “معاوية بن أبي سفيان” رضي الله عنه في 58هـ “عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي” الذي كرهه أهل الكوفة؛ فمنع المصريون دخوله وطالبوه بالعودة لأمير المؤمنين فعاد، ثم ذهب من طرده وهو “عمرو بن حديج” للشام فتحدى “معاوية” في واليه وتدارك “معاوية” الأمر، واستقبل “بن حديج” بالإحسان.
وفي 62هـ، ولى “يزيد بن معاوية” على مصر واليا شابا يدعى “سعيد بن يزيد الأزدي”، فاحتقره المصريون لصغر سنه؛ ولم يلبث “يزيد” أن مات ودعا “الزبير” لنفسه بالخلافة؛ فوثب أهل مصر على “سعيد” فعزلوه. كما تسببت كراهية المصريين للوالي “حفص بن الوليد” حتى عزل بعد 40 يوما من ولايته في 108هـ. كما طالب المصريون بعزل “عبد الرحمن الفهمي” في 118هـ لجبنه العسكري، وقد عزله الخليفة بعد تأكده من هزيمته أمام الروم بسبب الجبن. ومثل ذلك حدث مع “محمود بن جمل” الوالي عن الخليفة المقتدر في 309هـ. ومن الأحداث اللافتة في هذا المقام أن الخليفة الأموي “هشام بن عبد الملك” أراد توحيد المكاييل في كل إمارات دولة الخلافة، فأرسل مدى معياريا ليعتمده الناس في الوزن، فكسره الزعيم المصري المسلم من أصول قبطية “عبد الرحمن بن حيويل”، وهو من المعافر، وأعلن تمسك أهله بموازين الويبة والأردب، ورفضه بعده قطاع واسع من قادة الرأي وسادة القبائل من أهل مصر، ولقب “ابن حيويل” بلقب “كاسر المدى”، وصار لقبه نسبا لبنيه من بعده 42.
وبرغم التحيز السافر للمؤرخ د. حسن إبراهيم حسن لصالح “مدخل الدولة” و”الاقتراب البيروقراطي” في رصد التطور التاريخي لظاهرة السلطة في مصر، إلا أن معالجته للعصر الفاطمي لم تخل من كشف عن دور قوي للمصريين في ضبط السلطة وتحديها، وبخاصة مع اتجاه التشيع في مصر نحو الغلو، وضعف الخلفاء الفاطميين، واستئساد الوزراء لحد تلقيبهم بألقاب “الملك”. ولا يمكن لوم د. حسن في هذا الإطار، فتتلمذه على يد المستشرقين من جهة، واعتبار مرجعه من أوائل المراجع المعاصرة في هذا الباب (ألف الكتاب في 1932). ويشير حسن من طرف خفي لدور الاحتجاجات المصرية في الإطاحة بالوزير الأرمني “بهرام” (المتوفي في 1140م)، ومن وظفهم من طائفته المسيحية حتى انتهى الأمر بعزله وعزل 2000 موظف أرمني قام بتعيينهم في بنية الدولة.
كما تحدث عن مناصرة المصريين للوزير “رضوان” (تولى الوزارة في 1136م) الذي كان أول من حمل لقب “ملك” بين الوزراء في مواجهته مع “الخليفة الحافظ” (1130 – 1149م)، وهي الثورة التي أحبطها الجنود السودانيين للخليفة. وتحدث عن ترجيح المصريين لكفة الوزير “ابن السلار” (1299 – 1380م) على الوزير “نجم الدين بن مصال” (توفي في 544هـ)، وهما وزيران مثلا تجليا للخلاف بين غلاة الشيعة وأنصار المذهب السني، وكان “ابن السلار” سنيا، وهو ما جعله محط عداء الخليفة “الحافظ” وابنه “الظافر” (1149 – 1154م). كما ذكر طرفا من مقاومة الأهالي للوزير “العباس” أبي قاتل الوزير “ابن السلار، ورجم جنده بالحجارة في أزقة القاهرة ما انتهى بمقتله، ثم مقتل ابنه “نصر” قاتل “ابن السلار” بعد تسليم “الفرنجة” إياه للمصريين.
غير أن أهم ما في حركات المصريين ثورتهم على الوزير “ضرغام” (تولى الوزارة عام 558هـ) حين أراد أن يتعاون مع ملك “القدس” الصليبي “عموري” (1136 – 1174م)، لكي يحتفظ بملك مصر في مواجهة الوزير “شاور” (توفي في 1169م) المتحالف مع “نور الدين زنكي” (1118 – 1174)، وبرغم كراهية المصريين له عندما أغرق مصر من قبل لتجنب غزو صليبي، فقد زادت مقاومة المصريين له عندما أراد سلب أموال الأوقاف43 ، وهو ما أدى لانفضاض جنده عنه ومقتله، لتدخل مصر عهدا جديدا.
ربما كانت الحملات الصليبية الكثيفة علت منطقة الشرق خلال الدولة الأيوبية (1174 – 1263م) سبب عدم ورود أخبار عن علاقة المصريين بالسلطة تتجاوز المساندة في مواجهة الاستعمار الصليبي، وبخاصة مع احتلال الصليبيين للمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، وما حوله من أقطار عربية، وما اقترفوه من اعتداءات على حرية العبادة في هذه المناطق، وهو ما تأثرت به مصر مباشرة خلال الحملات على دمياط خلال الحملة الصليبية الخامسة (حملة الملك يوحنا بريين في مايو 1218)، ثم الحملة الصليبية السابعة التي هددت دمياط والمنصورة (بدأت في مايو 1249)44.
نفس الحال شهدته مصر مع بدايات الدولة المملوكية، حيث تراجعت الاحتجاجات في البداية بسبب الهجمة التترية على نحو ما يرى قاسم عبده قاسم، ثم ازدهار الأسواق والعدالة في فترة ما بعد الحرب لدرجة تولي بعض السلاطين شؤون الحسبة بأنفسهم (فيما يخص الرقابة على الأسعار والأسواق والأبعاد الصحية لها وقضايا الغش التجاري)، ومع بداية عهد المماليك الجراكسة وتزايد عدد الجلبان (المماليك المشترون من أسواق النخاسة) بدا أن فرص الاحتجاج تقل بسبب الزيادة الهائلة في عدد المماليك والجلبان برغم تراجع التجارة والتدهور النقدي، وتكفلت المجاعات بالقضاء على قدرة المصريين على الاحتجاج، هذا فضلا عن أن القيادات التقليدية التي اعتاد المصريون قيادتها إياهم في الملمات كانوا يتوارون بعيدا عن المدن والمناطق المأهولة في فترات الاوبئة، ما جعل الحركات الاحتجاجية تتوارى لحين ارتفاع الأوبئة والمجاعات45 .
ج. الجماهير والسلطة في مصر العثمانية وحتى ثورة يوليو
بدت ظاهرة احتجاج المصريين وخروجهم على الولاة وتأديبهم أكثر وضوحا بعد الفتح العثماني لمصر. ولأن ظاهرة احتجاج المصريين ارتبطت بتوفر قيادة تبلور آمال وآلام المصريين، وتقودهم للتعبير عنها، فإن فترة الخلافة العثمانية شهدت نبوغا لدور الأزهر في بلورة مصالح المصريين والتعبير عنها وقيادتهم لتحقيقها والدفاع عنها. وكان من أبرز أدوار الأزهر في هذه الفترة تصدي مشايخه للحركة الانفصالية التي قادها أحمد باشا والي مصر ضد الدولة العثمانية (930هـ)؛ والذي باشر خلال انفصاله مظالم اجتماعية وسياسية عدة، فضلا عن مخالفته للهوى المصري الذي كان قد رضي عن الدولة العثمانية بعد طول مقاومة لها46 .
كما تحرك المصريون لعزل الوالي العثماني موسى باشا (1040هـ) بعد تحايله للاستيلاء على حملة عسكرية موجهة ضد الدولة الصفوية. وهناك أيضا موقف الأزهر الرافض لفرمان السلطان (1071هـ) بنفي الأمراء “الفقاريين” (فرقة مملوكية عسكرية) وتجريدهم من أموالهم، وهو ما كان يهدف به أهل مصر للحفاظ على توازن القوة العسكرية في الشارع في مواجهة الأمراء المماليك “القاسمية” و”الجراكسة” (فرق مملوكية عسكرية)، وهو درس استفادتاه مصر من المحن التي ارتبطت بتغول المماليك. ثم كانت انتفاضة مواجهة الوالي “رجب باشا” (1033هـ) الذي استهل فترة حكمه بمذبحة دموية ضد منافسيه من المماليك، ما أدى بثورة مصرية انتهت بعزل السلطان العثماني له، ثم عزل “سليمان باشا العظم” (1152هـ) لنفس السبب47 .
وإلى جانب هذه الاحتجاجات الكبرى، فإن العهد العثماني شهد عدة انتفاضات شعبية لعل أبرزها انتفاضة البحيرة (1103هـ)، وانتفاضة بني سويف (1109هـ)، ومع مجئ الحملة الفرنسية شهدت مصر عدة انتفاضات وثورات شعبية كان أبرزها انتفاضة القاهرة الأولى (1128هـ)، وانتفاضة طلبة الأزهر (1191هـ) التي ساندت الجماهير فيها طلاب الأزهر، بالإضافة لثورة الحسينية الأولى (1199هـ)، وانتفاضة القاهرة الثانية (1201هـ)، وثورة الحسينية الثانية (1205هـ). ومن أهم الثورات التي قام بها المصريون بمساندة شيوخ الأزهر بعد رحيل الحملة الفرنسية؛ ما عرف بثورة مقاومة النهب المملوكي (1209هـ)، والتي أعقبت تجدد الخلافات المملوكية التي انتهت بحملة نهب واسعة في الوجهين القبلي والبحري، ما ترتب عليه ثورة ضخمة تجمع فيها مصريون من مختلف الوجهين البحري والقبلي، وقادهم علماء الأزهر لمحاصر القلعة، ثم تراجعوا إلى الجامع الأزهر، حيث اعتصم المصريون حول الأزهر لليلتين، قبل أن ينزل والي مصر لمنزل شيخ الأزهر ويبرم صلحا بين الأزهر وأمراء المماليك48 .
ولا يمكن في هذا الإطار التغافل عن دور المصريين في حمل السلطان على خلع الوالي “محمد خسرو” باشا في 1805م، وتعيين الأمير “محمد علي” واليا، وهو ما قاد “محمد علي” لتنفيذ مشروعه الذي عرفه المؤرخون لاحقا باسم “بناء مصر الحديثة”، وهو المشروع الذي بدأه “محمد علي” بتجريد المجتمع المصري من قادته عبر تهميشهم واغتيالهم معنويا وإضعاف مراكز تأثيرهم عبر تشويههم وبث الفرقة بينهم، وهو ما أدى لتحجيم الحركة الاحتجاجية للمصريين، هذا فضلا عن دور المشروع السياسي لـ”محمد علي” في استيعاب طاقات المصريين، وبخاصة بعدما اتجه لتجنيد المصريين في الجيش.
وبالرغم من أن بعض المؤرخين يميل لاعتبار وسيلة الرفض الأساسية لدى المصريين، وبخاصة الفلاحين، تتمثل في الهروب من نظام “محمد علي” الضريبي إلى الشام 49، إلا أن ذلك لم يمنع المصريين من الانتفاض ضد حكم الوالي، حيث شهدت مصر عدة انتفاضات قوية ضد نظامه الضريبي، منها انتفاضة فلاحي الصعيد في أبريل 1824، بالإضافة إلى تمرد قرى قسم “زاوية المصلوب” في “بني سويف” الذي تزعمه ناظر القسم بنفسه متحالفًا مع مشايخ القرى في فبراير 1838، وكذلك التمرد الذي قام به أهالي ناحية الكريمات بقسم “أطفيح”، وانتفاضة أهالي قرية “الحاج قنديل” بمديرية “أسيوط” في أواخر عام 1838، والعصيان الذي عم قرى مديرية “الشرقية” كلها في مطلع سنة 1840، وكان “محمد علي” يحرص على ارسال قوات أجنبية من “الباشبوزق” و”السواري” التركية لقمع هذه الانتفاضات، وبعضها تم قمعه بشق الأنفس كما في حالة انتفاضة الصعيد التي تزعمها “الشيخ رضوان” والتي انتفضت وأسرت الحكام المحليين، وبلغ من شراستها أن ضباط قات محمد علي التي توجهت لقمع التمرد رفضت الاستمرار فيه، ما حدا بقيادة القوات لإعدام 45 ضابطا منهم هرب أمام الاحتجاجات الجماهيرية 50.
وقد شهدت الدولة العلوية نمو الوعي النيابي مع الاتجاه لتأسيس أول مجلس نيابي في 1866م إبان حكم الخديوي “إسماعيل”، وهو ما خلق أشكالا جديدة لجهود الاحتجاج، لعل أبرزها ثورة 1919 التي واجهت الاحتلال عبر تشكيل الوفد المصري عبر حملة لبناء هيئة يزكيها أعضاء مجلس شورى النواب الذين لم تسقط عضويتهم خلال الحرب، بحيث يكون للهيئة المختارة صفة الوكالة العامة51 ، كما قادت لبلورة نماذج احتجاج نيابي جديدة؛ منها اجتماع مجلسي النواب والشيوخ المصريين في “فندق الكونتننتال” لتحدي قرار الملك فؤاد بحل “البرلمان المصري”، ودور هذا المجلس ضد سلسلة الاتفاقات التي وقعت قسرا مع سلطات الاحتلال البريطاني، لحين رحيل قوات الاحتلال في 1954.
شكلت تنظيم الضباط الأحرار الذي نفذ حركة 23 يوليو 1952 خليطا غير متجانس من الضباط من جهة الفكر، ولم يجمعهم إلا الانتماء العسكري ورفض النظام السياسي القائم في مصر آنذاك، ويصف المستشار “طارق البشري” كيف أدى طغيان العقلية العسكرية على النزوع الديمقراطي لبعض الضباط، ما أدى إلى إبعاد كل من الضابطين “يوسف صديق” و”خالد محيي الدين” من مجلس قيادة الثورة، ثم ما حدث في 15 يناير 1953 من إلقاء القبض على ضباط سلاحي المدفعية والفرسان الذين طالبوا بإعادة تنظيم هيئة الضباط الأحرار، وبخاصة عبر الانتخاب من بين الضباط، وتشكيل جمعية عمومية من الضباط تعرض عليهم قرارات مجلس قيادة الثورة؛ لئلا تنفرد قلة من الضباط بقرارات تمثل مصير مصر ومستقبلها 52.
وإلى جانب هذا النزوع للسيطرة، أدت قرارات الإصلاحات الاجتماعية التي أكسبت مجلس قيادة الثورة شرعية رضائية إلى التغطية على تداعيات قرارات حل الأحزاب ثم مواجهة بقية الحركات الشعبية، هو ما ادى في النهاية إلى حرمان المصريين من قياداتهم، وهو ما انصرف إلى الأزهر لاحقا عبر قانون إصلاحه، وما اقترن بهذه المسيرة من وحشية في التعامل مع رجل الشارع أسست لاحقا لحالة الصدام بين النخبة الحاكمة والجماهير، وبخاصة بعد فشل الخطة الخمسية الثانية للرئيس “جمال عبد الناصر”. وأضحت ظاهرة اعتقال القيادات قرينة كل قرار كبير تتخذه الإدارات المصرية المتعاقبة، سواء أكانت موجة الاعتقالات كلية (اعتقالات سبتمبر 1981 – اعتقالات ما بعد 3 يوليو) أو جزئية عبر الإدارات المختلفة منذ “جمال عبد الناصر” وحتى “محمد حسني مبارك”.
القسم الثاني: خلاصات واجتهادات تفسيرية
خلاصة ما سبق عرضه من خبرة تاريخية يمكننا تجريد ملامحها فيما يلي:
أ. حركة احتجاجات دؤوبة:
أثبتت الاحتجاجات المصرية الدؤوبة إلى أن نظريات الاستبداد الشرقي تنصرف صحتها إلى ما يتعلق بناء الدولة المركزية وتعاظم نزوعها للسيطرة على الموارد التي تتمتع بها الدولة، ولكنها لن تعن بأي حال أن الشعب المصري قد رضخ أمام هذه السلطة، ويكأن مد نطاق نظريات الاستبداد الشرقي تجاه المجتمع المصري، وبخاصة من جانب النخب العربية لم يكن سوى دعاية تستهدف همة المجتمع وعزيمته.
الشهادات التاريخية أكدت – بما لا يدع مجالا للشك – أن المصريين وقفوا موقف المحاسب للسلطة دوما، وأن معدل وقوفهم في وجه هذه السلطة ربما فاق معدل انتفاضات الشعوب الأوروبية في مواجهة الأباطرة والملوك في أوروبا، وكانت الجهود المنصرفة لقمع الشعوب العربية من الوحشية بمكان بحيث لم تشارك بها قوات شرطية وحسب، بل اشتركت فيها جيوش جرارة، ومن أهم الأمثلة على ذلك ما ورد سبق أن عرضنا له في حرب دقلديانوس ضد المسيحيين في الإسكندرية إلى الحد الذي أبكاه على حال المدينة بعد انتهاء المواجهات، ومنها أيضا حرب الخليفة المأمون على “ثورة الدلتا” المصرية، والتي استدعت تدخل 3 جيوش لدولة الخلافة في عملية قمع استمرت نحو عامين.
ولا يمكن أن ننسى قطع محمد علي لحملة قواته في شبه الجزيرة العربية، وإعادتها إلى مصر لقمع ثورة الصعيد، ومن ثم العودة لمواصلة الحملة بعد قمع هذه الانتفاضة. بل يبلغ الأمر في بعض فترات التاريخ أن تكون احتجاجات المصريين فيها دورية بمعدل حركة احتجاجية كبرى كل عامين، على نحو ما رأينا خلال فترة حكم الدولة العباسية، والدولة العثمانية. ولم يخل الأمر من وجود مجموعة احتجاجات صغرى متناثرة عبر أرجاء الإقليم الذي تسمى باسم مصر حاليا.
لم تكن الحركات الاحتجاجية على نحو ما رأينا ذات طابع واحد، فبعضها كان دينيا، وبعضها سياسيا، وكانت بعض الحركات الاحتجاجية ذات طبيعة ثقافية، وفي أوقات الهجمات من ذوي غير اللسان العربي أو فيما تعلق بفرض عقيدة غير العقيدة السنية، كانت الاحتجاجات تأخذ طابعا قوميا أو دينيا، وتمثل الاحتجاجات الاجتماعية – الاقتصادية وزنا معتبرا بين الحركات الاحتجاجية.
ومن جهة ثالثة، فإن الاحتجاجات لم تقتصر على مكون عرقي أو طائفي أو ديني أو جهوي في الإقليم المصري، بل كان يشارك فيها الجميع؛ وبخاصة إن كانت ذات طبيعة اجتماعية – اقتصادية، أما المواجهات الدينية فكانت بحسب الانتماء العقدي أو المذهبي.
اتسع نطاق الوعي بكم الحركات الاحتجاجية للمصريين بعد تحول القاهرة إلى حاضرة للدولة، وذلك بدء بالدولة الطولونية وحتى العلوية؛ نسبة لمحمد علي. وتعد خبرة الوعي بالاحتجاجات خلال الدولة العثمانية استثناء، حيث لم يزد الوعي بها نتيجة التأريخ للدولة، بل بسبب تبلور الدور الريادي للأزهر، وتأريخ علماء الأزهر للتفاعلات السياسية في مصر، وبخاصة تلك التي قادها الأزهر أو شارك فيها.
ب. شرط القيادة:
كانت القيادة شرطا هاما من شروط تبلور الحركات الاحتجاجية للمصريين، حيث لم يعرف المصريين الهبات العفوية إلا بصورة نادرة فيما بلغ الباحث من معلومات، وإن كان بعض المؤرخين قد تحدث عن هبات نادرة ولم تكتمل التفاصيل حولها. كانت القيادات السياسية من الأسر الملكية والوزراء والأثرياء مصدرا للحركات الاحتجاجية في مصر الفرعونية، وكانت القيادات المذهبية والدينية على رأس الاحتجاجات الدينية والمذهبية في مصر الرومانية والإسلامية، سواء تعلق الأمر بمواجهة المسيحيين للاضطهاد الروماني، أو مواجهات العلويين مع الأمويين أو الخوارج. وقادت العائلات والقبائل المواجهات مع الجباة والملتزمين وولاة الخراج، وتزعموا محاولات فرض المكاييل والموازين الموحدة، وتولوا الدفاع عن قياسات الأرض عندما حاولت السلطات أن تدلس في المساحات لزيادة الخراج.. إلخ.
ويمكن القول إن فترات تراجع الحركات الاحتجاجية ارتبطت بضعف القيادات أو هجرتها، على نحو ما شهدته مصر خلال فترات الشدة الكافورية والمستنصرية والمملوكية، حيث كانت القيادات تميل لترك مناطق انتشار الأوبئة التي كانت تتفاقم خلال فترات القحط؛ وتذهب بعائلاتها إلى مناطق أكثر صحية وأمنا، وهو ما جعل المشكلات الاجتماعية تتفاقم خلال هذه الفترة، وذاع معها نمط التفكير القدري التواكلي من دون الاتجاه لتفكير عملي لمواجهة الأحداث.
وبينما غلبت على الاحتجاجات حتى العصر الفاطمي أن كان قادتها من الرؤوس القبلية والعشائرية والمناطقية أو كبار التجار وملاك الأراضي، فإن عملية قيادة الاحتجاجات بدأت في التحول باتجاه أكثر عمومية ومدنية مع الدولة العثمانية، حيث تبلورت في هذه الفترة حالة قيادة أزهرية واضحة؛ ارتبطت بقيمة “العلم”، واستخلاص الدروس والعبر من التاريخ، بالإضافة لامتلاك النخبة الأزهرية لمنطق أصولي يحمل من ملكات التفكير المنطقي والاستقرائي وفقه الموازنات وتقييم المصالح والمفاسد؛ ما عزز من مكانة الفقيه الأزهري.
واتضحت دلالة هذه البلورة فيما مثلته نخبة الأزهر من قدرة على بلورة رؤى تقييم لمواطن الخطر في مسالك قيادات المماليك، وهي المسالك التي عانت منها مصر بشدة في ختام الدولة المملوكية، ومكنت الأزهر من التدخل أكثر من مرة لوضع حد لخلافات المماليك وتهور جنودهم، وكان منطقهم العملي في هذا الصدد ما يسر لهم إقناع ولاة مصر أو إقناع السلطان العثماني نفسه بدقة تقييمهم للمواقف، وصواب قرارهم حيال الولاة والأمراء المماليك، والأهم أن مكانتهم المجتمعية جعلت رأيهم موضع تقدير سياسي لقدرتهم على قيادة عموم المصريين لتحقيق ما يرونه صوابا وأسلم لمعاش الناس ومصالحهم.
ومع إتيان نظم التعليم الأجنبية في مصر لثمارها، ازدادت حداثة القيادات لتنتقل إلى جانب مشايخ الأزهر لتطال قيادات مدنية لعل أبرز أمثلتها قادة الأحزاب السياسية مثل مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول وحسن البنا وأحمد حسين وغيرهم من القيادات التي أنتجت أفكار متجددة لتمثيل المصريين ومواجهة السلطات مثل “التوعية الإعلامية” أو “الدبلوماسية الشعبية” أو “التوكيلات التمثيلية” أو “الحركات الشعبية” أو “الحركات السرية” التي استخدمتها تيارات سياسية مختلفة سواء قومية أو إسلامية أو يسارية.. وغيرها من الآليات.
ولعل أهمية عنصر القيادة ما دفع قيادات الدول التي حكمت مصر عبر التاريخ لتقدير القيادات المجتمعية المصرية، سواء أكان هذا التقدير إيجابي كما كان الحال إبان الدولة الأموية أو العثمانية اللتين اعتبرتا أن احتواء القيادات الجماهيرية من بوابة العدل يمثل رأس مال سياسي للدولة، ويوفر لها شرعية رضائية تزيد في التمكين للدولة، أو كان تقديرا سلبيا يستهدف الاستقرار من بوابة “قطع الرؤوس” كما كان الحال في الدولة العباسية والعلوية وغيرهما.
ج. في الربط بين الإسلام والخضوع للسلطة:
من الخلاصات المهمة للتتبع التاريخي السابق أنه يقدم إجابة عن علاقة الدين الإسلامي بقضية الخضوع للسلطة السياسية. وبما أن قضية الخضوع قد انتفت من أساسها، فإنه لا يصبح ثمة تطبيق موضوعي لذلك النموذج التفسيري. وربما نلمس من خلال العرض أن الميل للاحتجاج ومواجهة السلطة قد زاد بعد دخول الإسلام إلى مصر، وهو أمر وارد، وإن لم يكن ثمة ما يدل عليه بصورة قاطعة، حيث إن المؤرخين الراصدين للظاهرة في العصور الإسلامية منذ الفتح يؤكدون أن ثمة قصور في التأريخ للظاهرة باعتبار أن مصر لم تكن عاصمة لأية دولة من قبل حتى قيام الدولة الطولونية، باستثناء العصر الفرعوني. ولهذا يثور تساؤل لدى الباحث: لماذا اختار قطاع من النخبة المصرية الالتحاق بالتاريخ من باب الدولة وما ارتبط بها من جهود التطبيع مع الاستبداد ولم يتواصلوا مع تاريخ المجتمع المصري المفعم بالحياة؟ الانتقاء في هذا الصدد يستحق التفسير.
ولا يصرفنا انقضاء المجال التطبيقي للنظرية عن الإشارة لوضع الإسلام كديانة تحررية استهدفت تحرير الإسلام من رسن السلطة السياسية التي قد يكون لها مقتضيات تخالف العدل وإعمار الأرض، وهما هدفا الشريعة الإسلامية الأسميان، وهو ما يتضح من رسالة الصحابي “ربعي بن عامر التميمي” موفد الصحابي المثنى بن حارثة رضي الله عنه لقيادة الجيش الفارسي، حيث أعلن رسالته بأن “الله قد ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد”. رسالة التحرير هذه تقيدت بتحقيق العدل وتنظيم مصالح العباد.
وتحققت الخيرية للأمة الإسلامية – وفق التعبير القرآني – بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن “أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”، وقوله صلى الله عليه وسلم: “سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب يوم القيامة، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه، فقتله”. وربما مالت بعض الفرق الإسلامية، ومنها الجامية والمدخلية للتمسك بأحاديث البيعة والسمع والطاعة برغم “سلب المال” و”جلد الظهر”. وهكذا تبلور منهج سياسي داخل الإسلام يعفي السلطة من المساءلة، وكان نتاجه أن نرى “نخبة وهابية” ترفض مساءلة الحاكم ولو ظهر على شاشات الفضائيات يزني ويقترف سائر المنكرات.
ومن سيرة المصريين وسلوكهم السياسي، وقد خالطوا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن استقروا في مصر بعد الفتح، نجد أنهم انخرطوا في مواجهات شتى مع السلطة بعد الفتح، وما تلا من دول، وهو ما يعني أنهم لم يلمسوا ممن عاش بينهم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون رفض الظلم مما ينكر البيعة، واعتبروا أن العدل والامتناع عن المجاهرة بالمنكر مما يوجب الاحتجاج البالغ حد الخروج. وتقديري أن انزواء الخوارج في مصر، وقلة حضورهم في المشهد السياسي او المشهد الاحتجاجي يعني أن تأثيرهم كان محدودا في العقل السياسي للمصريين، ومن ثم؛ فغن خروج المصريين كان تعبيرا عن فهمهم للإسلام كما يعكسه مذهب أهل السنة، حتى وغن مال بعضهم للتشيع.
د. سيادة قيمة العدل:
بالإضافة للوزن الهام في الشريعة الإسلامية لقضية البيعة، يمكن القول باطمئنان أن الحركات الاحتجاجية للمصريين، باختلاف دوافعها ونطاقاتها وتوجهاتها كانت تستهدف قيمة إحقاق العدل ونصرته كقيمة عليا، بما في ذلك الحركات ذات الطبيعة الدينية. ويمكن تصور استقامة الحركات الاحتجاجية المصرية مع قيمة العدل فيما يتعلق بالحركات الاحتجاجية ذات الطبيعة الاجتماعية – الاقتصادية التي استهدفت منع التدليس في تقدير مساحات الأراضي الزراعية، ورفض المغالاة في الضرائب، ورفض التعسف في جباية الضرائب في توقيتات الشدة والأزمات الاقتصادية، ورفض تأخر الرواتب والمستحقات على الولاية لصالح التجار والزراع.. إلخ.
إلا أن احتجاجات المصريين ذات الطابع الديني كانت تتغيا العدل وعدم التمييز بين الناس كذلك من قبيل التماس العدل بالرغم من الاختلافات في العقيدة بين الأديان المختلفة، سواء أكان ذلك بين الأديان في فترة الاحتلال الروماني أو بين المذاهب والملل والنحل المختلفة بعد الفتح الإسلامي، وتمثل احتجاجات المسيحيين ضد الرومان في رفض الظلم والاضطهاد الناجم عن شعور الرومان بكون العقيدة التوحيدية المسيحية تمثل أساسا لثورة اجتماعية قد تعصف بالنظام الاجتماعي الروماني، أو رؤية العلويين والأمويين حول “أحقية الخلافة”، أو رفض المصريين لفرض نموذج تدين مخالف ويحمل قدرا من الغلو مثلما حدث بين السنة والشيعة في مصر خلال إبان الدولة الفاطمية التي اشتعل خلالها الخلاف بين الخلافة الشيعية والوزارة السنية.
ويميل أصحاب التوجه الذي يمد دلالات نظريات “الاستبداد” المختلفة إلى جمهرة المصريين إلى اتهام المصريين بالخضوع للسلطة لأن أي من مسالكهم لم تؤد إلى تغيير سياسي، فقط تغيير مسالك. غير أن هذا الأمر غير صحيح على إطلاقه، إن لم يكن صحيحا مطلقا. فمن ناحية، أدت احتجاجات المصريين وانتفاضاتهم إلى تغيير أعداد كبيرة من الولاة، وإذا جاز لنا ان نقتصر على دولة واحدة، فإن الدولة العثمانية وحدها شهدت منذ الفتح وحتى تولي “محمد علي” قد شهدت تغيير 5 ولاة (أحمد باشا – رجب باشا – موسى باشا – سليمان باشا العظم – خسرو باشا)، وسبق أن خلعوا 4 ولاة للدولة الأموية، وستة ولاة للدولة العباسية.
كما أن احتجاجات المصريين يلغت حد الوقوف في وجه خلفاء كذلك، فقد كسرت زعامات مصرية “مدي” الأوزان التي أرسلها الخليفة “هشام بن عبد الملك” أمام رسله؛ وكان ذلك في أوج الدولة الأموية، كما طالبت بخلع الخليفة الأموي “مروان بن محمد” بعد تحدي واليه وعزله، وتحدت “ثورة الدلتا” الخليفة “المأمون” وواجهته في حرب استمرت قرابة العام بعد أن فشل واليه وقائدة “الإفشين” في هزيمتها. ومن جهة ثالثة، تمكنت الحركات الاحتجاجية المصرية في الإجهاز على دول مريضة، ومكنت فاتحين جددا من فتح مصر، يستوي في ذلك ما فعله المصريون مع الفتح الإسلامي ضد الرومان، وما فعلوه مع العباسيين ضد الأمويين، وما فعلوه كذلك مع الفاطميين ضد الإخشيد، وما فعلوه مع الزنكيين ضد الفاطميين.. إلخ. وقد بنت القيادات الأهلية المصرية مواقفها في التمكين لفاتحين جددا مواقفها على أساس حالة الضعف التي دخلتها الدول الآيلة للسقوط.
ومع مساهمة جمهرة المصريين في الإجهاز على دول مهملة وضعيفة لصالح دول قوية، لا يمكن التحجج في هذا الإطار بأن المصريين جلبوا أسيادا أقوى. إن قيمة العدل كانت القيمة الأعلى في العصر الإمبراطوري الذي انتهى نسبيا مع نهاية “الحرب العالمية الثانية”. وكان تحقيق هذه القيمة هو الأساس. فلم يبال المصريون بوجود دولة سنية أو شيعية بعد فترة “الشدة الكافورية”، طالما أن الدولة القوية ستحقق العدل من دون أن تفرض مذهبها، كما حدث مع سابقاتها باستثناءات شكلية تمثلت في الدعاء على المنابر من دون حمل الناس على تغيير اعتقادهم، ومع الضعف وغياب العدل قرر المصريون استبدال الدول التي تحكمهم.
لكن مقاومة “الإمبراطوريات” كان لها ثمن باهظ، ويكفي أن نعود لحصاد المواجهات مع الخليفة “المأمون” لندرك عظم الثمن الذي دفعه المصريون لثورتهم، ويكفي أن نشير هنا إلى أن الكنيسة المصرية اتخذت قرارها منذ ذلك الحين بتجنب مواجهة الحكام، وهو قرار ما زال فاعلا حتى يومنا هذا.
في هذا الصدد، نلفت إلى أن قيمة الحرية كقيمة سياسية قطب لم تكن تحمل نفس الأولوية التي حملتها قيمة العدل التي كانت القيمة القطب في العقل الإسلامي. ومن جهة أخرى، فإن المصريون لم يحتكوا بقيمة الحرية إلا مع الحملة الفرنسية ثم الحملة الإنجليزية، ومن ثم؛ كان مدخل هاتين القيمتين مثير للريبة أكثر منه مدعاة للحضور. ومع اتجاه هذه القيمة للاستقرار في العقل المصري، كانت مصر على أعتاب نظام عسكري أسست له حركة يوليو 1952، وما لبثت الإدارات التي استظلت بمرجعية يوليو السياسية أن باشرت في استخدام شكلي وغير صحي للديمقراطية انتهى لتشويهها، شأن مصر في ذلك شأن كل دول الجنوب التي تعرفت على قيمة الحرية ضمن “الموجة الثالثة للديمقراطية”، ولعل هذا التلاقي الشائه هو ما أدى لتراجع الخبرات الديمقراطية في العالم وفق مؤشرات عدة قدمتها مراكز تفكير معنية بالديمقراطية مثل “فريدام هاوس” بالإضافة لمؤشرات مركز الخبرة الخاص بمجلة “الإيكونوميست” Economist Intelligence الذي يصدر مؤشر الديمقراطية السنوي، وغيرهما.
في هذا الإطار لا يمكننا تجاهل ما حدث في مصر في يناير 1977، ويناير 2011. كما لا يمكننا تجاهل دور جماعة مثل “الإخوان المسلمون” في نقل العقل المسلم من مربع القول بـ”كفر الديمقراطية” إلى مربع وجود أحزاب إسلامية سلفية في مصر مثل “حزب النور” و”حزب الوطن” و”حزب البناء والتنمية” ومن قبلها “حزب الراية” و”حزب الفضيلة” و”حزب الأصالة”، وذلك جنبا إلى جنب مع أحزاب وسطية منها الذراع السياسي للإخوان نفسها “حزب الحرية والعدالة” أو احزاب أخرى خرجت من عباءتها وتجاوزتها مثل “حزب الوسط” و”حزب مصر القوية”.
خاتمة
عود على السؤال الذي سبق أن أشرنا إلى طرح النخبة الديمقراطية إياه حول ما إذا كانت الجماهير قد عاودت عزوفها عن الممارسة الديمقراطية استسلاما لمنطق “الاستبداد الشرقي” أم أن المسؤولية تقع على عاتق النخبة السياسية، فإن الدراسة التي بين أيدينا حاولت أن تحدد موضوع نظريات التي تربط الاستبداد بالشرق ونظمه الاقتصادية أو تربطه بالثقافات الدينية الشرقية ومن بينها الإسلام.
ويتيح هذا العرض التاريخي أن ننأى عن الإلقاء باللائمة على المصريين في التمكين للاستبداد، خاصة وأن مفكرين وأكاديميين بارزين من مختلف التيارات، من بينهم برهان غليون وعمرو حمزاوي وعلي الرجال وغيرهم أكدوا على ضلوع قطاع واسع من النخبة المصرية في التمكين للاستبداد مع نجاح حركة يوليو 1952؛ وأن هذه النخبة نظرت للدولة الحديثة، وللمؤسسة العسكرية – معا – باعتبارهما أداة التنوير؛ وأنهما الآلية المثلى لمواجهة ما اعتبروه الرجعية الاجتماعية وما ارتبط بها من رجعية فكرية، وأن هذه النخبة سلكت هذا المسلك هذا المسلك نتيجة حالة من عدم الثقة في المجتمع وفي ميوله لمساندة هياكل الإنتاج والروابط الاجتماعية التقليدية وما ارتبط بها من بنية فوقية، ومن ثم أحلوا “بطريركية سياسية” محل “البطريركية المجتمعية”، وساندوا نزوع الدولة للتحرر من الضغط الداخلي والثقافة السياسية التمثيلية، والذي كان يعني التضحية بكل القوى السياسية والاجتماعية التي كانت موجودة قبل 1952، ودعموا الدولة فيما اتخذته من إجراءات لتجريد المجتمع من قواه باعتبار أن ذلك مما ييسر تحقيق الدولة لدورها كطليعة تحديث، ودفعها للسير في هذا الاتجاه ما ارتبط بحركة يوليو من إجراءات اجتماعية تمثلت في سياسة التوزيع التي نالت رضا رجل الشارع.
كما يرى مفكرون أيضا، منهم المفكر اليساري هاني شكر الله، أن ما نشهده اليوم من عزوف المصريين عن المشاركة السياسية بعد يوليو 2013، يمثل حذرا من المصريين بعد أن خذلته النخبة التي أولاها ثقته في يناير 2011، وفقد لأجلها نفائس من الأهل والأموال. وكانت دراسة سابقة للباحث قد أشارت إلى أن النخبة السياسية المصرية فقدت قدرا كبيرا من رأس مالها السياسي بعد انقلاب الثالث من يوليو، وتكاد مقدمات الباحث تتفق تماما مع ما ذهب إليه هاني شكر الله، مهما كانت المبررات حاضرة من “تجريف مباركي” و”مخططات إقليمية” و”غياب لشرط الدعم الدولي”. فالخطأ صدر عن النخبة المصرية قاطبة، وشارك فيه كل القوى الداعمة لمشروع يناير، ما أدى لنجاح قوى “الثورة المضادة”.
لا تريد الدراسة بجانب تحديد موضوع النظريات التي تربط بين الاستبداد والبنيتين الاقتصادية والثقافية المشرقيتين أكثر من أن تضع المشكلة أمام مصدرها الحقيقي: النخبوي، لعل في ترتيبات مصالحة ثم حوار ثم توافق أن تنجز هدف استرداد رأس المال السياسي المفتقد، فتعيد بناء اللحمة بين الجماهير وقياداتها، مما يوفر قيدا على سلوك السلطة الشاطحة في اتجاهات يُجمع الديمقراطيون المصريون على أنها تضر بالمصلحة القومية المصرية ( 53).
الهامش
1 جمال علي زهران، الاتجاهات المناطقية وعلاقتها بالمركز إبان ثورة 25 يناير، في عبد الفضيل: محررا، الثورة المصرية.. الدوافع والاتجاهات والتحديات، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسية، ط 1، مارس 2012، ص ص: 145 – 148.
2 برهان غليون، المحنة العربية.. الدولة ضد الأمة، بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، ط4، سبتمبر 2015، ص ص: 20 – 21.
3 حسين نصار، الثورات الشعبية في مصر الإسلامية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1983، ط2، ص: 54.
4 حسين نصار، مرجع سابق، ص: 4.
5 عمر الإسكندري وأ. ج. سفدج، تاريخ مصر إلى الفتح العثماني، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1966، ط 2. ص: 12 – 14.
6 سمير أديب، تاريخ وحضارة مصر القديمة، القاهرة، د. ن، 1997، ص ص: 141 – 148.
7 إمام عبد الفتاح إمام، الطاغية؛ دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي، سلسلة عالم المعرفة، الكتاب رقم 183، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مارس 1994، ص: 263.
8 عبد الجليل كاظم الوالي، قراءات جديدة في قضايا فلسفية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 2010، ص: 161 – 162.
9 نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية: نموذج للتحيز في العلوم السياسية، في عبد الوهاب المسيري محررا: إشكالية التحيز، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالتعاون مع نقابة المهندسين، 1995، ج: 2، ص: 611.
10 مونتسكيو، روح الشرائع، ترجمة: عادل زعيتر، القاهرة، دار المعارف، 1953، ط1، مج: 2، ص: 178.
11 إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سابق، ص: 264.
12 فريدريك هيجل، العقل في التاريخ؛ المجلد الأول من محاضرات في فلسفة التاريخ، سلسلة المكتبة الهيجلية، الكتاب الأول، بيروت، دار التنوير، ط 3، 2007، ص: 86.
13 المرجع السابق، ص: 87.
14 فريدريك هيجل، العالم الشرقي؛ المجلد الثاني من محاضرات في فلسفة التاريخ، سلسلة المكتبة الهيجلية، الكتاب الثاني، بيروت، دار التنوير، ط 3، 2007، ص: 13.
15 المرجع السابق، ص: 13.
16 نزيه نصيف الأيوبي، الدولة المركزية في مصر، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، سبتمبر 1998، ص ص: 15 – 18.
17 جمال حمدان، مختارات من شخصية مصر، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط1، 1996، ص: 148.
18 المرجع السابق، ص ص: 142 – 144.
19 المرجع السابق، ص: 149.
20 محمد عابد الجابري، العل السياسي العربي.. محدداته وتجلياته، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط4، أغسطس 2000، ص ص: 329 – 362.
21 إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سابق، ص ص: 264 – 265.
22 انظر كنموذج لسيطرة المدخل الدولتي في الاقتراب من التاريخ الدولتي: ناصر الأنصاري، المجمل في تاريخ مصر: النظم السياسية والإدارية، القاهرة، دار الشروق، ط 2، 1997. ولا يقدح الباحث في قيمة هذا الاقتراب، وإنما يرى الاقتراب يتجاوز دور المجتمع في الظاهرة السياسية، ويغيبه.
23 عمر الإسكندري، مرجع سابق، ص: 5.
24 المرجع السابق، ص ص: 3 – 4.
25 مصطفى النشار، الخطاب السياسي في مصر القديمة، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر، 1998، ط.1. ص: 87.
26 المرجع السابق، ص: 89.
27 المرجع السابق، ص ص: 89 – 90.
28 سمير أديب، مرجع سابق، ص ص: 103 – 106.
29 المرجع السابق، ص ص: 140 – 141.
30 المرجع السابق، ص ص: 283 – 286.
31 المرجع السابق، ص ص: 303 – 316.
32 عمرو الإسكندري، مرجع سابق، ص ص: 177 – 180.
33 حسين نصار، مرجع سابق، ص ص: 5 – 6.
34 المرجع السابق، ص ص: 11 – 15.
35 المرجع السابق، ص ص: 16 – 28.
36 المرجع السابق، ص ص: 31 – 41.
37 المرجع السابق، ص ص: 44 – 57.
38 المرجع السابق، ص: 56.
39 حسن إبراهيم حسن، الفاطميون في مصر، القاهرة، وزارة المعارف العمومية، 1932، ص ص: 95 – 97.
40 المرجع السابق، ص ص: 64 – 70.
41 المرجع السابق، ص: 76.
42 المرجع السابق، ص ص: 78 – 83.
43 حسن إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص ص: 293 – 302.
44 محمد سهيل طقوش، تاريخ الأيوبيين في مصر والشام وإقليم الجزيرة 1174 – 1263م، بيروت، دار النفائس، ط2، 2008، ص ص: 284 – 386.
45 انظر في التأريخ الاجتماعي للعهد المملوكي: قاسم عبده قاسم، عصر سلاطين المماليك، القاهرة، دار الشروق، ط1، 1994.
46 عبد الجواد إسماعيل، الدور السياسي للأزهر إبان الحكم العثماني، القاهرة، مكتبة وهبة، ط: 1، 1996، ص ص: 24 – 25.
47 المرجع السابق، ص ص: 23 – 63.
48 المرجع السابق، ص ص: 126 – 161.
49 منير البعلبكي وآخرون، المصور في التاريخ، دار العلم للملايين، الحملة المصرية، ج7، ص: 157.
50 لمزيد من النماذج عن انتفاضات الفلاحين في عهد محمد علي يمكن مراجعة: عماد هلال، الفلاح والسلطة والقانون: مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، سلسلة مصر النهضة؛ ع: 69، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، ط1، 2007.
51 عباس محمود العقاد، سعد زغلول.. سيرة وتحية، القاهرة، مطبعة حجازي، د.ت.، ص ص 191 – 192.
طارق البشري، الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 – 1970، بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية، ط1، 1987، ص ص 67 – 77.
53 الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
(المصدر: المعهد المصري للبحوث)