
بين الدين والعلمانية.. مَن المسؤول حقا عن أكبر جرائم الإبادة والعنف؟
بقلم سامح عودة
في ظهيرة الخامس من يونيو/حزيران عام 2020، هبطت طائرة “هرقل سي-130” بمطار الجزائر الدولي، قادمة من فرنسا، وعلى متنها سبع وعشرون جمجمة بشرية من رفات شهداء المقاومة الشعبية الجزائرية، كانوا قد قُتِلوا على يد القوات الفرنسية أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر، وقبع رفاتهم وجماجمهم بمتحف الإنسان بباريس لما يقارب القرنين من الزمان(1).
لكنّهم -رغم ذلك- كانوا محظوظين بما يكفي ليعود رفاتهم في حين بقيت اثنتا عشرة جمجمة أخرى قابعة في صالات العرض بباريس كي يطالعها الجمهور، في ذلك المتحف الذي أنشأه عالم الأعراق الفرنسي “بول ريفيه” عام 1937 ليكون مركزا بحثيا، فصار شاهدا على أكبر جريمة استعمارية في التاريخ الحديث.
في هذا المتحف، يمكنك أن ترى جمجمة “سليمان الحلبي” وقد كُتب تحت عظامه كلمة “مُجرِم”، لا لشيء إلا لأنه قتل “كليبر” خليفة “نابليون” على جيش الشرق في مصر، ذلك الجيش الذي أشعل النار في الغيطان، وأخرج الناس من ديارها، واستباح حُرمة مُقدَّساتهم، وفصل 2500 رأس عن أجساد أصحابها، وألقى بالجثث في قاع النيل، كما يصف “الجبرتي” في كتابه الشهير. بيد أن الوحيد الذي كُتِب تحت رأسه “مجرم” كان “سليمان”.
لوحة تخيلية للسوري (سليمان الحلبي) وهو يقتل (كليبر) قائد قوات الأحتلال الفرنسي في مصر عام 1800م . وعمره 24سنة ،
كان سليمان يدرس في جامع الأزهر فأقسم على المصحف أن يقتل كليبر فأوفى بقسمه، ولايزال خنجره وجمجمته محفوظة في علبة من البلور في متحف قصر شايو مكتوب تحتها جمجمة مجرم pic.twitter.com/jGfur1KKHR— عبدالكريم النغيمشي (@abdulkarim_900) February 7, 2020
إنها الأسطورة ذاتها التي تُحمِّل الضحية وزر الجاني، تلك التي جعلت من الأول قاتلا إرهابيا وجعلت من الثاني بطلا شهيدا، وهي نفسها التي جعلت جماجم المقاومين الجزائريين عقابا رادعا لكل مَن تُسوِّل له نفسه مقاومة المحتل، فهل حقا يصنع الدين العنف؟ أم أن دولة الاستعمار الغربية الحديثة تمسح التهمة في ثوب غيرها؟
أسطورة نافعة
“لا يمكن هزيمة الأسطورة عبر معارضتها بالمنطق والدقة أو بقوة الدليل.. إن الأسطورة بطبعها بلا أساس، وهذا ما يجعلها مستقرة وثابتة. ما يميز الأسطورة ليس فجاجتها أو سذاجتها، وإنما قدرتها على التملُّص من أدوات التحقيق”.
(ليندا زِريللي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة شيكاغو)(2)
بهذا الاستشهاد يفتتح “ويليام كافانو”،(3) أستاذ الدراسات الكاثوليكية في جامعة “دي بول”، حديثه عن أسطورة العنف الديني، التي ضمَّنها في كتاب تحت هذا العنوان، ليُخبرنا أن ثمة أسطورة تسيطر على التصور العام في الغرب وتؤثر في خطابه، وتقضي بأن الدين يحمل ميلا خطرا نحو العنف والإرهاب على مر العصور. ورغم افتقاد هذه الأسطورة لأي حقائق عملية أو علمية، حسب “كافانو”، واقتصارها على كونها بناءً أيديولوجيًّا محضًا، فإنها تكتسب كل صفات الأسطورة من الثبات والاستقرار والتعالي على المُساءلة.

يؤكِّد “نعوم تشومسكي” هذا الأمر(4) حين رأى أن المواطن الأوروبي لا يعرف شيئا عن جرائم بلاده في حقبة الاستعمار، لكنه يعلم تمام اليقين أن هؤلاء المُستَعمَرين كانوا ولا يزالون إرهابيين. والسبب وراء رواج هذه الأسطورة، كما يقول “كافانو”، هو خدمة أهداف محددة لمستهلكيها في الغرب؛ فهي تساعد في تهميش أي خطاب ديني يزعج علمانية الدولة محليا، وتُسوِّغ الإجراءات الغربية العنيفة تجاه العالم غير الغربي دوليا.
إنها صناعة الشرير الذي يجب قتله، أو العدو الذي يجعلنا نقتل بضمير مرتاح كما يقول “بيير كونيسا”،(5) وهي صناعة تساعد في خلق نقطة عمياء في التفكير الغربي حول مدى تورُّط الغربيين في العنف، لتصبح الأسطورة بمنزلة اتهام سابق متخيَّل لدفع الاتهام الحاضر الحقيقي.
في هذا السياق، يُخبرنا “كافانو” أن الأيديولوجيات والمؤسسات الموصوفة بالعلمانية يمكنها أن تكون على الدرجة ذاتها من الاستبدادية واللا عقلانية التي تصم بها المجتمعات المتدينة؛ فهي تناقض نفسها حين تتهم الدين بأنه يجعل العنف مُقدَّسا، ثم تجدها تنقل هذا المُقدَّس من الدين إلى الدولة لتكون هي المُقدَّس الجديد. وحينها يُصدِّر الخطاب القومي العلماني صورته الحصرية عن أسطورته، التي يُبرِّئ عبرها عنف الدولة العلمانية، لأن عنفها اضطراري؛ فـ”المجتمعات غير العلمانية لم تتعلَّم بعد ضرورة نزع الآثار الخطيرة للدين، ومن ثم فإن عنفهم غير عقلاني ومُتعصِّب، أما عنفنا العلماني فهو عنف عقلاني يسعى للسلام، وهو مع الأسف عنف ضروري لاحتواء عنفهم، إننا نجد أنفسنا مُجبرين على تفجيرهم ليصبحوا ديمقراطيين”(6).
لهذا السبب، يرى “كافانو” أن أسطورة العنف الديني هي أكثر الأساطير نفعا للدولة العلمانية؛ كونها تُشرعن كل ممارستها الاستعمارية تحت حجة “العنف اللازم لاحتواء العنف الديني”. لكن أن تضع المُبرر لقتل إنسان بريء شيء، وأن تجعل إنسانا آخر يُقدِم على قتله شيء آخر. إنك في الأولى تحتاج إلى سبب لقتله، وقد ينجح ذلك على المستوى النظري، لكنك في الثانية تحتاج إلى أن تجعله قابلا للقتل بالفعل، وأن تزيل عنه كل مانع معنوي وإنساني يمنع جنودك من إحراقه حتى الموت.
ناس و”لا ناس”
 في كتابه “تأثير الشيطان” يشرح لنا عالِم النفس الأميركي “فيليب زيمباردو” كيف يتحوَّل البشر العاديون إلى قتلة سفّاحين في غمضة عين.
في كتابه “تأثير الشيطان” يشرح لنا عالِم النفس الأميركي “فيليب زيمباردو” كيف يتحوَّل البشر العاديون إلى قتلة سفّاحين في غمضة عين.في واحدة من تجاربه النفسية، أحضر عالِم النفس الأميركي “ألبرت باندورا”(7) مجموعة من الأفراد، ثم قسَّمهم إلى ثلاث مجموعات؛ وُصِفَت الأولى بمجموعة الحيوانات، ووُصِفت الثانيةُ بمجموعة الأذكياء، بينما تُرِكت الثالثةُ بلا تصنيف. وكانت مهمة المتطوعين سماع نقاشات المجموعات الثلاث حول المشكلات المطروحة وتقييم حلولهم لها، على أن تُعاقَب المجموعات على حلولها الخاطئة بالصعق الكهربائي مُتدرِّج الشدة من 1 إلى 10.
كما كان متوقَّعا، لعبت التصنيفات دورا حاسما في مقدار الصدمات وتدرُّجها على مدار محاولات التجربة؛ لتتلقَّى مجموعة الحيوانات أكبر قدر من الصعق -كمًّا وكيفًا- مقارنة بالمجموعة المحايدة ومجموعة الأذكياء التي كانت أقل المجموعات الثلاثة تعرُّضا للعقاب من المشاركين، مما يعني أن نزع الأنسنة كفيل بتبرير أشد أنواع العقاب ظُلما وإجحافا.
وقد ضمَّن عالِم النفس الأميركي “فيليب زيمباردو” تلك التجربة في كتابه “تأثير الشيطان”؛ ليشرح لنا كيف يتحوَّل البشر العاديون إلى قتلة سفّاحين في غمضة عين. ففي محاكمات سفاحي الهوتو على جرائمهم الدموية ضد قبائل التوتسي إبان الحرب الأهلية في دولة رواندا، ذكر عدد من المتهمين أنهم لم يروا التوتسي بشرا من الأساس، وإنما محض حشرات، تماما كما أقنعهم قادتهم. الأمر الذي نجده في تصريح أحد القادة اليابانيين حول قتلهم البشع للصينيين أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ قال: “لقد كان قتلهم يسيرا على الجنود لأننا كنا ننظر إليهم على أنهم أشياء وليسوا بشرا مثلنا”(8).

تلك النظرة هي ذاتها التي يرى بها المستوطنون اليهود الفلسطينيين؛ فالحكومة الصهيونية بحسب “إيال وايزمان”(9) تجعل المستوطنات تحفة معمارية على أعلى طراز، في حين تجعل الوديان الفلسطينية المجاورة مكبا للنفايات ومياه الصرف. إنها تلك النظرة التي “تُشيِّئ” الآخر حتى يسهل تهميشه، أو بتعبير “جورج أورويل” تصنع ناسا و”لا ناس”، فالعالم عند الغرب -كما يقول “تشومسكي”(10)- مُقسَّم بين أناس من أمثالهم، وأولئك “اللا ناس” الذين لا يُحسَب لهم حساب.
ثم يردف في هذا السياق فيقول: “استمع مثلا إلى عويل العديد من الأوروبيين إثر الحرب العالمية الثانية حول محارق الألمان، وكيف أن الفلسفة العقلانية الألمانية كانت فلسفة مسالمة حتى تعرَّض الألمان للإهانة الاقتصادية عقب الحرب العالمية الأولى”، ويعجب “تشومسكي” من هذا التفسير، وكأن الألمان لم يُجرموا إلا عندما أحرقوا اليهود، وكأن إبادة سكان ساموا في المحيط الهادئ وهنود مپوچَت كان سلاما ألمانيا.
لقد قتلت القوات الألمانية في حرب الماجي ماجي بتنزانيا آلاف البشر من الجوع والعذاب عبر إستراتيجية الأرض المحروقة التي انتهجتها قبل الهولوكوست بأكثر من ثلاثين سنة، ناهيك بمجازر قبائل هِررو بنامبيا أوائل القرن الماضي؛ حين أجبر الضباط الألمان نساء القتلى على نزع اللحم عن الجماجم بشظايا الزجاج، ثم حملوا هذه الجماجم عبر البحر حتى يتمكَّن باحثو العِرق من دراستها! بل إن الألمان قد أحرقوا الغجر أيضا بجانب اليهود في الهولوكوست، لكن هذا لم يمنع فرنسا من اضطهاد الغجر وممارسة العنصرية تجاههم وترحيلهم من بلادها دون أي تعاطف مع مأساتهم كما جرى مع اليهود،(11) فقط لأنهم “لا ناس”.
 مجازر قبائل هِررو بنامبيا أوائل القرن الماضي؛ حين أجبر الضباط الألمان نساء القتلى على نزع اللحم عن الجماجم بشظايا الزجاج.
مجازر قبائل هِررو بنامبيا أوائل القرن الماضي؛ حين أجبر الضباط الألمان نساء القتلى على نزع اللحم عن الجماجم بشظايا الزجاج.ما لا نذكره
في حواره مع “تشومسكي” حول الاستعمار الغربي، يحكي الصحفي الأميركي “أندريه فلجِك”(12) عن عمله السابق مع وكالة خيرية متخصِّصة في إزالة الألغام والقنابل التي لم تنفجر أثناء الحروب، فيقول إن الوكالة الخيرية التي رعت هذا العمل قدَّمت شكوى لأن العديد من الشركات المصنِّعة لهذه المتفجرات ما زالت ترفض إطلاع الوكالة على المعلومات الفنية حول متفجراتها؛ الأمر الذي يُعقِّد من مهمة تفكيكها ويُعرِّض حياة الآلاف للخطر المُحدِق كل يوم، ما دفع “فلجك” ليقول إن “هذا الاحتقار وهذه الاستهانة بحياة الشعوب يُعبِّران عن نفسيهما، ويقودان إلى استمرار قتل الآلاف من الأبرياء”!
بهذه القصة يُصوِّر “فلجِك” أيديولوجية الاستعمار بوجهه العلماني الذي يحمي العالم من شرور الدين، وأباد -وفقا لما يذكره- ما يقارب 50 مليون إنسان حول العالم في عقود قليلة فحسب القرن الماضي، بل إنه تعدَّى ضِعْف ذلك بكثير في القرون الأربعة الأخيرة، وتحديدا منذ بدء الحركة الاستيطانية الأوروبية في الأميركتين.
في كتابه “أميركا والإبادات الجماعية”، يذكر “منير العكش”، أستاذ الإنسانيات ومدير الدراسات العربية في جامعة “سفك” ببوسطن، أن الاستعمار الأوروبي للأميركتين أباد ما يقارب 400 أمة من السكان الأصليين، ونحو 112 مليون إنسان، وأن ذلك لم يكن فقط عبر القتل المباشر بالبنادق والأنصال، بل يذكر المؤرخ “هنري دوبينز” في كتابه “أرقامهم التي هزُلت” أن الهنود تعرَّضوا في أربعة قرون فقط إلى 93 حرب جرثومية بشتى أنواع الأوبئة، حتى إن بعض الشعوب الهندية التقطت العدوى من جيرانها وأُفنيت قبائلهم عن آخرها دون أن يروا وجها أبيضَ واحدا.
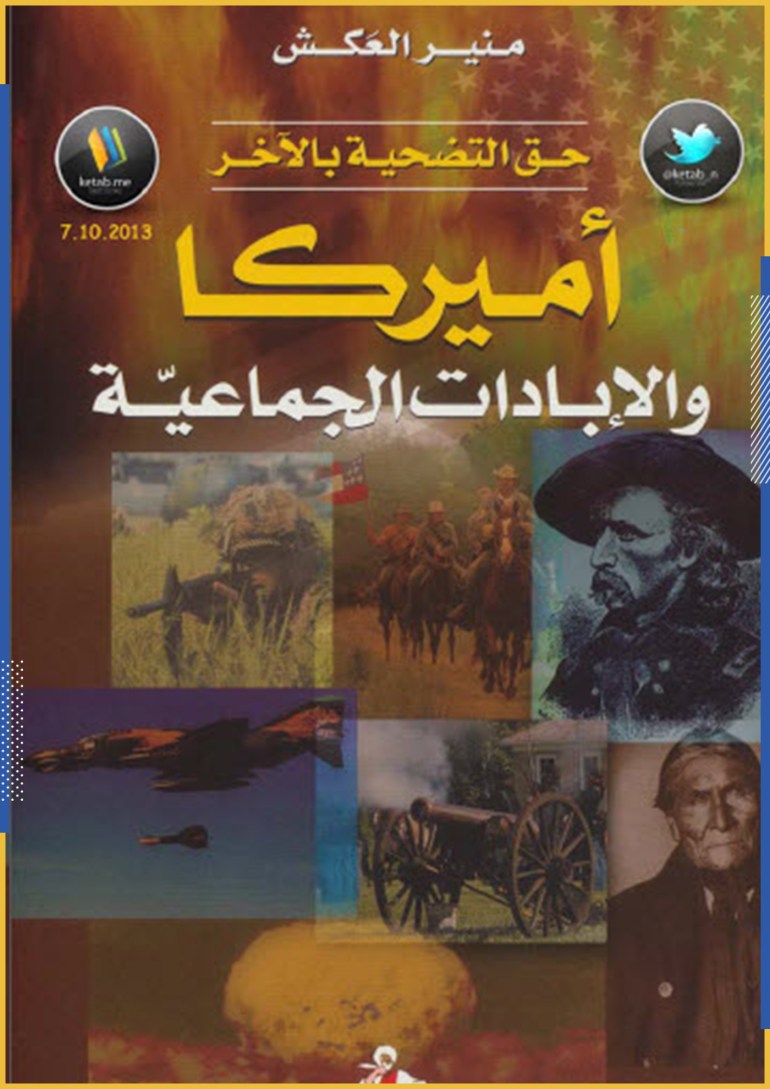
في إحدى رسائله المخطوطة بتاريخ 22 مايو/أيار 1634، كتب “جون وينثروب”، الحاكم الأول لمستعمرة “ماساتشوستس”، مادحا “العامل الطبيعي” الذي أباد الهنود وحدهم، قائلا: “بفضل الله ونعمته لم يمت من مستعمِرينا السنة الماضية سوى اثنين أو ثلاثة بالغين وبعض الأطفال، وكنا نادرا ما نسمع عن مرض الملاريا أو غيره من الأوبئة.. أما السكان الأصليون فماتوا كلهم تقريبا بالجدري، وبذلك أعطانا الله صك ملكية هذه الأراضي”.(13)
رغم استقبال الهنود الحفي للحجاج الإنجليز بعد هجرتهم من بريطانيا وانفصالهم عن الكنيسة الأنجليكانية، فإن هذا الود -كما يذكر “العكش”- لم يقابله إلا سيل من الإذلال والترويع لهؤلاء المُضيفين. فحسب ما يرويه “جون مَيسون”، مؤسِّس مستعمرة “كونتيكت”، فإن القتل المباشر كان السلاح المُفضَّل لدى الحجاج، بينما مَثَّل حرق الحقول والمزارع عاملا إضافيا للاستئصال. وجدير بالذكر أن “مَيسون” هو القائد الذي آمن بنبوءة “توماس هوكر” وظل يُردِّدها أثناء حروب إبادة البيكو: “يجب أن يكونوا خبزنا فنأكل حتى التخمة!”.(14، 15)
إلى جانب تلك التخمة، يروي كلٌّ من “روبرت فوجل” و”ستانلي إنجِرمان”، عضوَيْ الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم، أنه خلال أسابيع قليلة كان الهندي يموت من المرض والإجهاد وسوء التغذية، حيث عادلت كمية الطعام المُقدَّمة للعبد الأفريقي ثمانية أمثال الكمية المُقدَّمة للهنود، ولم يكن ذلك حبا في أفريقيا، بل لأن كلفة استبدال الهنود كانت أرخص من إطعامهم، أما استيراد العبد الأفريقي فدونه المحيط بأكمله.(16)
ذلك فضلا عن عمليات الترحيل القسري التي مات أثناءها الآلاف، فبعدما سن الكونغرس عام 1930 قانون ترحيل الهنود إلى غرب المسيسبي، صار من حق كل مستوطن طرد أي هندي أو قتله إذا لم يستجب،(17) ويكفينا ذكر رحلة واحدة هي رحلة الدموع التي رُحِّلت فيها خمسة شعوب هندية (الشيروكي والشوكتو والشيكاسو والكريك والسيمينول) سيقت فيها مئات الأميال، بعجزتها وأطفالها ونسائها، عبر مناطق موبوءة بالكوليرا وغيرها من الأمراض، وأُطعِموا من طحين فاسد ولحم منتن حتى حصدهم “العامل الطبيعي” على أكمل وجه.

لقي في هذه الرحلة 15% من شعبَيْ الشوكتو والشيكاساو حتفهم، بينما مات أكثر من نصف مهجري الشعوب الثلاثة الباقية. ولأن الأوبئة والاستعباد والترحيل لم تكن كافية، حصدت المشانق وطلقات الرصاص أضعاف ما فعلته الجرائم السابقة، فضلا عن إتلاف المحاصيل؛ فيروي “فيليب بروس” في كتابه “التاريخ الاقتصادي لفرجينيا” أن غارة واحدة فقط كانت تُتلف ثلاثة آلاف فدان من الحقول؛ أي طعام أربعة آلاف شخص لعام كامل.
ما لا ننساه
في ضفة أخرى من العالم، وهي الضفة الأكثر شهرة بجرائم الاستعمار والإبادة؛ إذ لم يُمحَ شعبها كما حدث للهنود، تجلس أفريقيا على عرش شهود العنف العلماني العقلاني. فعلى على مدار تسع سنوات، دأب الناشط الحقوقي “جاك مورال” على جمع الوثائق السرية لجرائم الاحتلال الفرنسي، ثم طاف بين مراكز المعلومات والإحصاء الحقوقية ليجمع ما تُدركه يداه؛ ليخرج لنا بكتابه الواقع في أكثر من مئتي صفحة: “روزنامة جرائم فرنسا في عالم ما وراء البحار”.
كما يتضح من اسمه، لم يجد الكاتب وسيلة لجمع جرائم فرنسا المئة بين دفتَيْ كتابه إلا بترتيبها تقويميا حسب الأيام، ففي كل شهر نجد عبارة “قُتِل في مثل هذا اليوم”. ولعل أبرز تلك الجرائم حادثة نهب مدينة “سانساني هاوسا” الواقعة بالنيجر. فعلى إثر الإخفاقات أمام إنجلترا في السيطرة على مصر والسودان، وجَّهت فرنسا أنظارها نحو تشاد، وأطلقت بعثتها الموكلة إلى القائدين “بولي فولي” و”جوليان شانوان” في يناير/كانون الثاني 1899، ومن أجل تأمين تموين البعثة، نهب القائدان وأحرق جيشهما واغتصب وقتل عددا كبيرا من سكان كل قرية قابلاها، إلى أن مروا بقرية “سانساني هاوسا”. وقد أكملا طريقهما في منطقة مقفرة حتى كاد جنودهما أن يهلكوا عطشا، فلم يجدا بُدا من العودة إلى القرية المشؤومة، كونها أقرب منطقة مأهولة، الأمر الذي يعني إحباط مهمتهما، ولكنه يعني أيضا أن أحدا يستوجب العقاب، وقد كان أهل “سانساني هاوسا”، الذين ذُبِحوا ذبح الماشية، هم وجيرانهم في القرى المجاورة هم مَن استحق العقاب على فشل الحملة، لتدور مذبحة دامية شملت طعن عشرين امرأة مع أطفالهن الرُّضَّع ليكونوا عبرة لبقية السكان.(18، 19، 20، 21)

في مقاله “غستابوكم الجزائري”، كتب الصحفي الفرنسي “كلود بوردي” عام 1955 شهادته على أبشع أنواع التعذيب التي لقيها الجزائريون على يد الاحتلال، فقال: “إن التعذيب بالمغطس والنفخ بالماء من الدُّبر والصعق بالكهرباء في الغشاء المخاطي أو الإبط أو العمود الفقري هي الأساليب المُفضَّلة، لأنها لما تُطبَّقُ بِحِرَفية لا تترك آثارا ظاهرة. والتعذيب بالجوع أيضا أسلوب دائم.. كل ذلك يُثبت أن الجلّادين لا يُقدِّمون الأسرى للمحاكمة إلا بعد خمسة أو عشرة أيام من توقيفهم.. وبعد أن يُملي رجال الغستابو على ضحاياهم شبه الأموات الاعتراف الذي يَروق لهم”.
ومن الجزائر إلى الدومينيكان بالبحر الكاريبي؛ إذ استعر الغضب من قرار المحتل الفرنسي إعادة نظام العبودية عام 1803، لتُقرِّر الحكومة الفرنسية إرسال التعزيزات لقمع التمرُّد بواسطة 150 رجلا من الحرس الوطني، معهم 28 كلبا من فصيلة “بولدوغ”، وقد جاء في الخطاب الموجَّه لقائد الحملة “راميل” أنه “لن يؤخذ بالاعتبار تخصيص أي حصص غذائية أو نفقات لإطعام هذه الكلاب، بل يجب إطعامها من لحم الزنوج”22.
على ذكر الإسبان والعبيد، تجدر الإشارة إلى أن الإسبان أول مَن حمل الأسرى من أفريقيا عام 1518 لاستعبادهم في عالمهم المُتحضِّر الجديد بأميركا الجنوبية، وقد صارت تجارة العبيد من حينها عملا أوروبيا مشروعا أثناء القرن السابع عشر، حتى إن ملكة كبرى مثل “إليزابيث الأولى”، كما يروي المؤرخ السياسي “وولتر رودني”،23 طلبت مشاركة التاجر “جون هوكنز” تجارته تلك لغزارة أرباحها، ومنحته شعار النبالة الذي طلب “هوكنز” نقشه على هيئة أفريقي مُقيَّد بالسلاسل.
في الأيام القليلة الماضية قام متظاهرون غاضبون في بلجيكا باستهداف كافة تماثيل الملك الأسبق ليوبولد الثاني، حيث حطموا بعضها وأضرموا النيران في البعض الآخر وخربوا بعضها بالطلاء الاحمر
من هذا الملك؟
ولماذا كل هذا العداء نحوه؟
وما هي قصة الأيادي المقطوعة؟ #حياكم_تحت 🌹 pic.twitter.com/Ev2l7N7SU1— ماجد الماجد (@majed_i) June 12, 2020
لا يفوتنا ذكر واحدة من أبشع جرائم الاستعمار الأوروبي لأفريقيا: جرائم الاستعمار البلجيكي في الكونغو، التي بدأها أحد أشهر مجرمي الحرب القرن الماضي الملك “ليوبولد الثاني”،24 إذ أسَّس فِرَقا من المرتزقة الكونغوليين تحت إمرة ضباط بلجيك لممارسة القتل والإرهاب والاعتقال ليُجبر السكان على استخراج المطاط.
تُشير الروايات إلى أن المطاط كان يُلصَق بأجساد العبيد من السكان حتى يجف، ثم يُنزَع بقوة قد تنزع معها لحم المسكين المُستعبَد، أما من رفض فلم يكن أمامه إلا القتل والتعذيب، والنتيجة واحدة في الحالتين، ناهيك باغتصاب الزوجات والبنات وقتلهن. وقد كان جزاء من يتكاسل في تسليم كميته المطلوبة تسليم يده أو يد ابنه عقابا على ذلك، حتى إن صحفيا ألمانيا يروي أنه حصر أكثر من 1300 يد مقطوعة في يوم واحد عام 189625.
على كل حال، اعتذر رئيس الوزراء البلجيكي “شارل ميشيل” عن ذلك بعد قرن من الزمان، لكن هل يكفي الاعتذار لمحو آثار 10 ملايين جثة أرداها الاحتلال البلجيكي في الكونغو وحدها، فضلا عن مستعمراتهم الأخرى في رواندا وبوروندي؟ لقد قتل البلجيكيون من الأفارقة، كما يقول “أندريه فلجِك”26، عددا يفوق عدد سكان بلدهم أجمعين. فمَن يُكفِّر عن كل هذا؟
مَن يعتذر عن 6 ملايين طفل يموتون سنويا بسبب انعدام الخدمات الطبية في بلادهم الأفريقية الفقيرة المنتهكة؟27 ومَن يعتذر عن 5 ملايين قتيل في شرق الكونغو سقطوا على يد ميلشيات تُموِّلها الشركات مُتعدِّدة الجنسيات من أجل استنزاف الموارد؟28 ومَن يعتذر لأجيال مُشوَّهة في فيتنام إثر الحرب الكيماوية التي دمَّرتهم بها الولايات المتحدة؟ ومَن يعتذر لملايين القتلى في كمبوديا ممَّن فتك بهم المعتدي نفسه؟ ومَن يعتذر لاثنتي عشرة جمجمة لا تزال أسيرة في متحف الإنسان بباريس تنتظر أن يواريها التراب رفقة أقرانها السابقين؟
_________________________________________________________________________
المصادر
- يحتفظ بـ 18 ألف جمجمة بشرية.. ما هو متحف الإنسان بباريس؟
- LINDA M. G. ZERILLI, Doing Without Knowing: Feminism’s Politics of the Ordinary
- ويليام كافانو، “أسطورة العنف الديني”.
- نعوم تشومسكي، أندريه فلجي، “عن الإرهاب الغربي من هيروشيما إلى حروب الطائرات المسيرة”.
- بيير كونيسا، “صنع العدو.. أو كيف تقتل بضمير مرتاح”.
- ويليام كافانو، “أسطورة العنف الديني”.
- A. Bandura, et al. Disinhibition of Aggression Through Diffusion of Responsibility and Dehumanization Victims.
- فيليب زيمباردو، “تأثير الشيطان.. كيف يتحول الأخيار إلى أشرار”.
- إيال وايزمان، “أرض جوفاء.. الهندسة المعمارية للاحتلال الإسرائيلي”.
- نعوم تشومسكي، أندريه فلجي، “عن الإرهاب الغربي من هيروشيما إلى حروب الطائرات المسيرة”.
- المصدر نفسه.
- المصدر نفسه.
- Edmund Morgan, Americsan Slavery – American Freedom.
- منير العكش، “أمريكا والإبادات الجماعية”.
- Richard Drinon, Facing West.
- Robert fogel and Stanley Engerman, Time on Indian Slavery in colonial times.
- منير العكش، “أمريكا والإبادات الجماعية”.
- P. Vigné d’Octon, La Gloire du sabre, Paris, Flammarion, 1900, p.40.
- cité, 41- par Jean Suret -Canale, Afrique Noire, Occidentale et Centrale,
- Éditions sociales, 1968, p. 299-300 ; Muriel Mathieu, la Mission Afrique.
- Centrale, L’Harmattan, 1995, p. 103-104.
- Schoelcher, Vie de Toussaint Louverture, Ollendorf, 1889, Karthala, page 373.
- والتر رودني، “أوروبا والتخلف في أفريقيا”.
- Georgina Rannard and Eve Webster, Leopold II: Belgium ‘wakes up’ to its bloody colonial past.
- Michele Goodwin, Can’t Blame Colonialism for Current Rapes in Congo.
- نعوم تشومسكي، أندريه فلجي، “عن الإرهاب الغربي من هيروشيما إلى حروب الطائرات المسيرة”.
- المصدر نفسه.
- المصدر نفسه.




