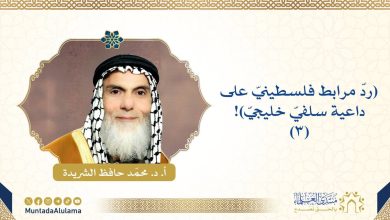بقلم د. وصفي عاشور أبو زيد
(كتبت هذه المقالة ونشرت عام 2006م بعد مرور مائة عام على ميلاد الشهيد سيد قطب، وقبل عشرة أعوام من اليوم، ويسرني أن أعيد نشرها كما هي اليوم؛ حيث يصادف مرور 110 أعوام على ميلاده 9 أكتوبر 1906م)
بعدما ثارت الضجة الكبيرة حول فكر سيد قطب (1906م- 1966م) ووصفتْه بأنه فكر تكفيري يُكفِّر المجتمع ومسلمي اليوم، تلك الضجة التي ظهرت إثر إشارة من شيخنا الإمام يوسف القرضاوي إلى ذلك أثناء حديثه عن مذكراته، ثم طُلب إليه أن يفصل هذا الأمر، ففصله- بناءً على عدم كتمانِ العلم ووجوب تبيينه- في مقالٍ مطول أورد فيه نصوصًا تؤكد أنه يحكم على المجتمع وربما مسلمي اليوم بالتكفير، وتقضي بوجوبِ مراجعتهم لدينهم، وثارت ضجة أخرى- في صفحة الإسلام وقضايا العصر بموقع إسلام أون لاين- ترد عليه كلامه بشهادات رجالٍ عايشوه وسمعوا منه ما ينفي تكفيره لأحد، ورد عليهم الشيخ في مقالةٍ بعنوان: “كلمة أخيرة حول سيد قطب”.
أقول بعدما ثارت هذه الضجة آن لنا- وقد مرَّ على ميلاده مائة عام، وعلى استشهاده أربعون عامًا- أن نقف إزاء آثاره وقفة، ونتساءل بعض التساؤلات المهمة في هذا الصدد، ولعل أهمها على الإطلاق: هل إذا وجدنا في بعض كتبه فكرًا يُخالف ما عليه الفكر الوسطي والصراط المستقيم أن نهدم باقي تراثه وأفكاره الأخرى التي تتبع الصراط المستقيم والمنهج القويم والفكر المتوازن أو نحكم عليه بالإعدام كما حُكِمَ على صاحبه من قبل، وهل تأثَّر قراؤه وكتبه جرَّاء هذه الضجة التي حدثت.
إن الحيدةَ والموضوعيةَ والإنصافَ يقضوا بأن نقبل الفكر الصحيح وإن صدر من غير أهله أو ممن نُخالفهم، ونرفض الفكر الخاطئ وإن صدر من أهله أو ممن نوافقهم، وما أشك ابتداءً في أنَّ فكره والرأي العام فيه تأثر- سواء كان التأثر سلبًا أو إيجابًا- بهذه الفتنة التي حدثت لا سيما وقد خرجت من رجلٍ في وزنِ ومكانةِ الشيخ يوسف القرضاوي، لكن لا يمنع هذا من بيان سلبية أو إيجابية هذا التأثر، وإيضاح ما تبقَّى من فكرِ الرجل.
الناقد الأدبي الأريب
من أهم ما تبقَّى من فكره بعد أربعين عامًا من استشهاده أنه أديبٌ ألمعي، وناقدٌ أدبي، وشاعرٌ حتى النخاع، ويكفينا في هذا الصدد كتبه التي صنَّفها في هذا المجال، منها: “مهمة الشاعر في الحياة”، وديوانه الشعري، وبعض الأعمال القصصية، وسيرته بعنوان: “طفل من القرية”، و”التصوير الفني في القرآن”، و”مشاهد القيامة في القرآن”، وإن كان الكتابان الأخيران محسوبَيْن على إسلاميته، غير أنهما يتماسان مع الأدب بقوةٍ واضحة، ولعل أهمها على الإطلاق كتابه البديع: “النقد الأدبي أصوله ومناهجه”.
وقد أودع في الأخير خلاصة فكره ونظريته عن أصول النقد الأدبي والمناهج التي ينبغي أن تتبع في هذا النقد؛ حيث بيَّن أنَّ وظيفةَ النقد الأدبي تقويم العمل الأدبي بكل أشكاله من الناحية الفنية، وبيان قيمته الموضوعية، وقيمه التعبيرية والشعورية، وتعيين مكانه في خط سير الأدب، وتحديد ما أضافه إلى التراث الأدبي في لغته، وفي العالم الأدبي كله، وقياس مدى تأثره بالمحيط وتأثيره فيه، وتصوير سمات صاحبه وخصائصه الشعورية والتعبيرية، وكشف العوامل النفسية والداخلية التي اشتركت في تكوينه والعوامل الخارجية كذلك.
ولقد شاء الأستاذ سيد قطب أن يتحدث عن العمل الأدبي أولاً، من قصة وأقصوصة، وشعر، وترجمة وسيرة، وخاطرة ومقالة وبحث قبل أن يتحدث عن النقد الأدبي نفسه وعن ماهيته وقيمه الشعورية والتعبيرية وطريقة نقده وتقويمه، في حين آخر الحديث عن المناهج- الفني والتاريخي والنفسي والمتكامل- في القسم الثاني من الكتاب، والسبب في ذلك عنده أن العمل الأدبي هو موضوع النقد الأدبي، فمن المنطقي الحديث عن الموضوع أولاً ثم إيراد طرق نقده ومناهجه.
كما استضاء بالنقد الغربي مع مراعاة فوارق الظروف التاريخية، وما يتناسب منها مع محيط النقد العربي وفي الحدود التي تقبلها طبيعته وتنتفع بها، وتنمو بها نموًا طبيعيًّا بعيدًا عن التكلف والافتعال،كما بيَّن أن المناهج إنما تصلح وتفيد حينما تُتخذ منارات ومعالم، ولكنها تفسد وتضر حينما تُجعل قيودًا وحدودًا، فيجب أن تكون مزاجًا من النظام والحرية، وخليطًا من الدقة والابتداع.
وقد جاء هذا الكتاب ليسد نقصًا غير قليل في النقد الأدبي، وهو أنه لم تكن هناك أصول مفهومة بدرجة كافية له، كما أنه لم تكن- قبل هذا الكتاب- مناهج كذلك تتبعها هذه الأصول، ومعظم ما كان يكتب كان اجتهادًا، وهذا طبيعي ما دامت الأصول لم توضع والمناهج لم تحدد بالدرجة الكافية، فالأصول والمناهج هي التي تضع للعمل الأدبي قواعده، وتقيم له المناهج، وتشرع له الطريق.
وحسبه هنا ما قاله عنه- وهو طالب في “دار العلوم”- أستاذه الدكتور مهدي علام سنة 1932م: “لو لم يكن لي تلميذ سواه لكفاني ذلك سرورًا وقناعةً واطمئنانًا إلى أنني سأحمِّل أمانةَ العلم والأدب مَن لا أشك في حُسن قيامه عليها.. إنني أعد سيد قطب مفخرةً من مفاخر دار العلوم, وإذا قلت “دار العلوم”, فقد عنيت دار الحكمة والأدب”.
مكتشف نجيب محفوظ
ومن الآثار التي تركها الأستاذ سيد قطب أنه كان المكتشف الأول للروائي الكبير نجيب محفوظ وتبناه وأخرجه للوجود مبكرًا، يقول الأستاذ نجيب محفوظ: “سيد قطب هو أول ناقد أدبي التفت إلى أعمالي وكتب عنها، وكان ذلك في الأربعينيات، وتعرفتُ عليه في ذلك الوقتِ حيث كان يجيء بانتظامٍ للجلوس معنا في كازينو “أوبرا”، وكانت العلاقة التي تربطنا أدبية أكثر منها إنسانية… وكنتُ أعتبره حتى اليوم الأخير من عمره صديقًا وناقدًا أدبيًّا كبيرًا كان له فضل السبق في الكتابةِ عني ولفت الأنظار إليَّ في وقتٍ تجاهلني فيه النقاد الآخرون، ولتأثري بشخصية سيد قطب وضعتها ضمن الشخصيات المحورية التي تدور حولها رواية “المرايا” مع إجراءِ بعض التعديلات البسيطة، والناقد المدقق يستطيع أن يُدرك أن تلك الشخصية فيها ملامح كثيرة من سيد قطب”.
وكتب سيد قطب في مجلة الرسالة التي كان يصدرها أحمد حسن الزيات مقالاً عن روايته: “كفاح طيبة”، ولم يكن أحد قبل سيد قطب كتب عن محفوظ رغم أنه كان قد أصدر روايتين قبل كفاح طيبة هما: “عبث الأقدار”، و”رادوبيس”، أشاد بها قائلاً في افتتاح مقاله: “أحاول أن أتحفظ في الثناءِ على هذه القصة، فتغلبني حماسة قاهرة لها، وفرحٌ جارفٌ بها، هذا هو الحق، أطالع به القارئ من أول سطرٍ لأستعين بكشفه على رد جماح هذه الحماسة، والعودة إلى هدوء الناقد واتزانه”، ويقول في ختام مقاله عن هذه الرواية: “لو كان لي من الأمر شيء لجعلت هذه القصة في يد كل فتى وكل فتاة، ولطبعتها ووزعتها على كل بيتٍ بالمجان، ولأقمتُ لصاحبها- الذي لا أعرفه- حفلةً من حفلاتِ التكريم التي لا عدادَ لها في مصر للمستحقين وغير المستحقين”، وكتب سيد قطب بعد ذلك عن “القاهرة الجديدة”، كما كتب كذلك عن “خان الخليلي”.
وما أحوجنا اليوم إلى أن يتبنى الأدباء والنقاد الكبار طليعة شباب الشعراء والنقاد والأدباء الموهوبين، كما حدث مع نجيب محفوظ؛ إذ كتب عنه سيد قطب، وأنور المعداوي، وطه حسين، وقد كانوا أعلامًا كبارًا، ولم يكن أحد يسمع حينئذٍ بنجيب محفوظ، في حين أن الساحة اليوم ملأى بالغثاء المنسوب للأدب والثقافة، وهناك العديد من الطاقات الأدبية الشابة والمبدعة ولا تجد مَن يتبناها ويشير إليها.
في ظلال القرآن
ومن أثمن ما تركه لنا الأستاذ سيد قطب تفسيره الممتع: “في ظلال القرآن” الذي يعتبر ثمرةً طبيعيةً لفكره اللغوي والنقدي والأدبي، والذي أرسى نظريته في كتابه الفريد: “التصوير الفني في القرآن”، ومن أبرز ما جاء فيه قوله: “التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المُحَسة المتخيَّلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني، والطبيعة البشرية، ثم يرتقى بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة، أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، فأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة فيها الحياة، وفيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار، فقد استوت لها كل عناصر التخييل، فما يكاد يبدأ العرض حتى يُحيل المستمعين نظَّارة، وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو سيقع، حيث تتوالى المناظر، وتتجدد الحركات، وينسى المستمع أنه كلام يُتلى، ومثل يضرب، ويتخيل أنه منظر يُعرض، وحادث يقع، فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو، وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات المنبعثة من المواقف المتساوقة مع الحوادث، وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة، فتنم عن الأحاسيس المضمرة، إنها الحياة هنا، وليست حكاية الحياة”. (التصوير الفني: 34- 35).. وكان التطبيق الموسع لهذه النظرية في هذا التفسير البديع غير المسبوق.
وقد انضم إلى عالم سيد قطب الأدبي في هذا التفسير تجربته الإيمانية التي برزت ونضحت بشكلٍ واضحٍ على هذا التفسير خاصةً بعد دخوله السجن، فلم يقرأ أحدٌ بعضًا من تفسيره إلا تأثر به، واستدعاه ذلك إلى قراءة المزيد منه، يستثنى من ذلك ما ضمنه كتابه من آراء حول الجاهلية والحاكمية التي ذهب الناس فيها كل مذهب واختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا.
أيًّا ما كان الأمر فإن تفسير سيد قطب تجربة متميزة في تاريخ التفسير القرآني، تستنزل هدايات القرآن ليعالج بها أمراض الواقع مما أبرز القرآن كتابًا حركيًّا يتماشى مع كل الأجيال، ويصلح لكل العصور.
وحسبنا أن نقرأ مقتطفاتٍ مما كتبه سيد قطب في بداية تفسيره لنرى أثر أدبه ولغته التي انضمَّ إليها تجربة إيمانية فكرية شعورية فريدة، أخرجت كلامًا كأنه تنزيلٌ من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم، يقول في مقدمته: “الحياة في ظلال القرآن نعمة.. نعمة لا يعرفها إلا مَن ذاقها، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه.. والحمد لله.. لقد منَّ الله عليَّ بالحياةِ في ظلال القرآن فترةً من الزمان، ذقتُ فيها من نعمته ما لم أذق قط في حياتي”.
“لقد عشتُ أسمع الله- تعالى- يتحدث إليَّ بهذا القرآن- أنا العبد القليل الصغير- أي تكريمٍ للإنسانِ هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعةٍ للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقامٍ كريمٍ يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم”.
“عشتُ أتملى- في ظلال القرآن- ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود.. لغاية الوجود كله، وغاية الوجود الإنساني.. وأقيس إليه تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية في المستنقع الآسن، وفي الدرك الهابط، وفي الظلام البهيم، وعندها ذلك المرتع الزكي، وذلك المرتقى العالي، وذلك النور الوضيء”.
وينتهي من العيش في ظلال القرآن إلى نتيجةٍ جازمةٍ حاسمةٍ هي أنه “لا صلاحَ لهذه الأرض، ولا راحةَ لهذه البشرية، ولا طمأنينةَ لهذا الإنسان، ولا رفعةَ ولا بركةَ ولا طهارةَ، ولا تناسقَ مع سنن الكون وفطرة الحياة.. إلا بالرجوع إلى الله..”.
الفكر الجديد الرصين
ومن أهم ما تبقَّى من الأستاذ سيد قطب فكره الجديد والرصين الذي دونه كثيرًا من كتبه مثل: “خصائص التصور الإسلامي ومقوماته”، و”هذا الدين”، و”المستقبل لهذا الدين” و”نحو مجتمعٍ إسلامي” و”دراسات إسلامية” و”الإسلام ومشكلات الحضارة” و”السلام العالمي والإسلام” و”في التاريخ فكرة ومنهاج” و”العدالة الاجتماعية في الإسلام”.
وبعيدًا عن فكرة الحاكمية أو الجاهلية التي تُثير الخلاف فقد ضمَّن مفكرنا الكبير مؤلفاته الفكرية أن الإسلامَ منهجٌ للبشر وليس لغيرهم؛ حيث يؤمن الإسلام بالأخذِ بالأسباب وأنه بقدر ما يتعامل البشر مع هذا المنهج يكون تفاعله معهم، وقرر الأستاذ سيد أنه منهج ميسر، ومنهج مؤثر، وأن رصيد الفطرة والتجربة مدة أربعة عشر قرنًا تجعل الناس أيسر في الدعوة وأقرب إلى الاستجابة، وأن الإسلام حركة إبداعية شاملة في الفن والحياة، ومنهج شامل للحياة لا يعرف الانفصام النكد عن الدنيا، وليس من طبيعته أن ينحصر في المشاعر الوجدانية، والأخلاقيات التهذيبية، والشعائر التعبدية، أو في ركن ضيق من أركان الحياة البشرية، ويتميز التصور الإسلامي بأنه رباني ووسطي وشامل ومتوازن وثابت وواقعي والإيجابية، وأن المستقبل لهذا الدين، وهو الطريق الوحيد المخلص لهذه البشرية من شقائها الذي تحيا فيه.
ولقد احتوت هذه الكتب الفكرية خطوطًا عامةً وأفكارًا جديدةً في الفكر الإسلامي أصبحت مادةً خصبةً ومرجعيةً ثابتةً أصيلةً لكل الكُتَّابِ والمفكرين الذين جاءوا بعده، وبخاصة كُتَّاب الحركة الإسلامية المعاصرة.
إنسانية سيد قطب
أعتقد اعتقادًا جازمًا أن كثيرًا مما كتبه سيد قطب ينضح بالإنسانية العالية والشفافية الكاملة التي يشعر الإنسان معها بالصدق والحق والخير والجمال، ويبين ذلك كلُّه ثقافتَه الإنسانية، وعمق معرفته بالنفس البشرية وما تمور به من مشاعر وأحاسيس، وقد أسعف سيد قطب في ذلك أنه ناقد أدبي، وشاعر عربي، وداعية رباني، وصاحب رصيد ضخم من الإيمان والقرب من الله تعالى، ومن أبرز ما يبين ذلك رسالته الصغيرة المختصرة بعنوان: “أفراح الروح”، التي تعد- في رأيي- أندى وأروع ما خط قلم سيد قطب يرحمه الله.
يتحدث عن “الغيرية” في مقابل “الأنانية”، وأننا لم نخلق لأنفسنا فحسب إنما لغيرنا كذلك، ويبرز مكاسبنا التي تعود علينا من خلال عملنا للغير فيقول: “عندما نعيش لذواتنا فحسب، تبدو لنا الحياة قصيرة ضئيلة، تبدأ من حيث بدأنا نعي، وتنتهي بانتهاء عمرنا المحدود، أما عندما نعيش لغيرنا، أي عندما نعيش لفكرة، فإن الحياة تبدو طويلة عميقة، تبدأ من حيث بدأت الإنسانية، وتمتد بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض، إننا نربح أضعاف عمرنا الفردي في هذه الحالة، نربحها حقيقة لا وهمًا، فتصور الحياة على هذا النحو، يضاعف شعورنا بأيامنا وساعاتنا ولحظاتنا، فليست الحياة بِعَدِّ السنين، ولكنها بعدادِ المشاعر”، “إننا نعيش لأنفسنا حياة مضاعفة، حينما نعيش للآخرين، وبقدر ما نضاعف إحساسنا بالآخرين، نضاعف إحساسنا بحياتنا، ونضاعف هذه الحياة ذاتها في النهاية”.
وفي نظرة تفاؤلية ملؤها العطف والشفقة والرحمة بالناس، يقول: “عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس، نجد أن هناك خيرًا كثيرًا، قد لا تراه العيون أول وهلة، لقد جربت ذلك، جربته مع الكثيرين، حتى الذين يبدو في أول الأمر أنهم شريرون، أو فقراء الشعور، شيء من العطف على أخطائهم وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العناية- غير المتصنعة- باهتماماتهم وهمومهم، ثم ينكشف لك النبع الخيّر في نفوسهم، حين يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم، في مقابل القليل الذي أعطيتهم إياه من نفسك، متى أعطيتهم إياه في صدق وصفاء وإخلاص”.
وفي إشارةٍ تُبين إدراكه لطبيعة النفس البشرية وفهمه لسراديبها ودخائلها يقول: “إن الشر ليس عميقًا في النفس الإنسانية إلى الحدِّ الذي نتصوره أحيانًا، إنه في تلك القشرة الصلبة، التي يواجهون بها كفاح الحياة للبقاء، فإذا أَمِنُوا تكشَّفت تلك القشرة الصلبة عن ثمرةٍ حلوةٍ شهية، هذه الثمرة الحلوة، إنما تتكشف لمَن يستطيع أن يشعر الناس بالأمن من جانبه، بالثقة في مودته، بالعطف الحقيقي على كفاحهم وآلامهم، وعلى أخطائهم، وعلى حماقاتهم كذلك، وشيء من سعة الصدر في أول الأمر، كفيل بتحقيق ذلك كله، أقرب مما يتوقع الكثيرون”. “حين نعتزل الناس؛ لأننا نحس أننا أطهر منهم روحًا، أو أطيب منهم قلبًا، أو أرحب منهم نفسًا، أو أذكى منهم عقلاً، لا نكون قد صنعنا شيئًا كبيرًا، لقد اخترنا لأنفسنا أيسر السبل، وأقلها مؤونة، إنَّ العظمةَ الحقيقية: أن نُخالط هؤلاء الناس، مُشْبَعين بروح السماحة، والعطف على ضعفهم ونقصهم وخطئهم، وروح الرغبة الحقيقية في تطهيرهم وتثقيفهم، ورفعهم إلى مستوانا بقدر ما نستطيع”.
هذه هي إنسانية سيد قطب، ونفسه الشفافة النيرة المضيئة الخيرة التي تُحب الخيرَ للناس وتحيا من أجلهم، ولا تتمنى العثار والأخطاء لهم، بل ترجو لهم الخير وتسعى من أجل تحقيق سعادتهم عاجلاً وآجلاً، وقد أحسنت باحثة أمريكية، هي الدكتورة إيفون حداد “الأستاذة بجامعة جورج تون” الأمريكية؛ إذ تتناول بحثًا بهذا العنوان: “إنسانية سيد قطب”، فسوف تجد المادة ثرية وعظيمة لدرجة تقع معها في حيرة عند اختيار النصوص؛ لأن كلها معبر، وكلها نافع وأخَّاذ.
وهو في النهاية بشر غير معصوم، يصيب ويخطئ، ويؤخذ من كلامه ويُترك، ولم يدَّع لنفسه العصمة، ولا ادعاها له غيره، وإن كان قد أخطأ في شيء، فأخطاؤه مغمورة في محيطِ ميزاته وحسناته، وجهاده وثباته وشهادته أحيت كثيرًا من القلوب، وربت أجيالاً بعد أجيال، فرحم الله سيد قطب، وجعله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.