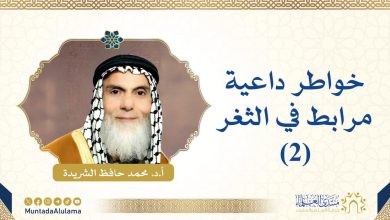الفقيه والسلطان: قراءة في جدلية الاستبداد باسم الدين (1-2)
بقلم أمين طاهر
الاستبداد مفهوم مركب يعرف في الأدبيات السياسية باستفراد الفرد أو جماعة بالقرار السياسي، دون محاسبة ومساءلة، وإذا أسقطنا هذا المفهوم على الوضع السياسي بالعالم العربي سنجده معضلة وسمة للحياة السياسية العربية، وإن اختلفت حدته بين قطر وآخر.
ولكونه ظاهرة سياسية مركبة لم تولد من فراغ فقد تحكمت في تراكمه مجموعة من العوامل والظروف قادت إلى ترسيخه كثقافة في العقل السياسي العربي ومن أهمها الاستقواء بالدين، فمنذ أواخر القرن 19 كتب المصلح الإسلامي عبد الرحمن الكواكبي كتابه الشهير طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد مشخصًا فيه جذور وبنية الاستبداد، وأسسه التي يستند إليها محملًا إياه مسؤولية الفوات الحضاري والتراجع الذي أصاب الأمة الإسلامية.
وكان من أبرز ما توصل إليه في إحدى مباحثه هو اتهام صنف من علماء الدين في ترسيخ الاستبداد والتسلط وبمولاة الطغاة بتقاعسهم عن القيام بواجبهم السامي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الكواكبي في نفس السياق من أين جاء فقهاء الاستبداد بتقديس الحكام عن المسؤولية حتى أوجبوا لهم الحمد إذا عدلوا وأوجبوا الصبر عليهم إذا ظلموا وعدوا كل معارضة لهم بغيًا يبيح دماء المعارضين؟… إن هذا التساؤل الاساس الذي يطرحه هو أصل المعضلة، وكثيرًا ما يثار النقاش حول طبيعة العلاقة الملتبسة بين المؤسسة الدينية وممثليها من فقهاء وعلماء والمؤسسة الحاكمة، سواء كانت دولة سلطانية تراثية أو دولة مدنية بالمفهوم المعاصر.
وعليه يصير لزامًا علينا في أفق تحليل بنية الاستبداد وتفكيكها ان نبين طبيعة العلاقة بين المؤسسة الدينية والسلطة بالرجوع إلى جذورها التاريخية.
في البدء كانت الشورى
شكلت الخلافة الراشدة نموذجًا للحكم المثالي كمنظومة دولة حققت مقاصد الدين بالتماهي مع التراث النبوي الإسلامي من عدل ومساواة بين الرعية على أساس تعاقد صريح بين الحاكم والمحكوم وبيعة مشروطة بالتزام مبدأ الشورى وإنفاذ أحكام الشرع.
وبالرغم من قصر أمدها فقد ظلت هذه التجربة السياسية راسخة في الوجدان الإسلامي بتفردها من حيث الممارسات السياسية والتزامها العميق بمبادئ الاسلام، إلا أن الحتمية التاريخية قادت إلى زوالها لأسباب متعددة منها الصراع على الحكم وتغيير الظروف الاجتماعية والسياسية وصولًا إلى الانقلاب الخطير الذي مس شكل نظام الحكم بتحوله إلى ملك وراثي استبدادي دشنه معاوية بن أبي سفيان كطور ثاني للدولة الإسلامية.
ولأن الذهنية العامة لجماعة المسلمين لم تستسغ تقبل الاتجاه الجديد لسلطة الوراثية المستندة على الحكم المطلق للفرد واغتصاب السلطة بالقوة، فقد ظلت تحن إلى ذلك النموذج السامي للسلطة المتمثل في الخلافة راشدة متمنية بعثها من جديد، فكان من الطبيعي أن تنشأ الفجوة النفسية بين المحكوم والحاكم لاختلاف المطامح والغايات بين الطرفين ولرأب الصدع عملت السلطة على كسب الشرعية لإنجاح هذا الانتقال السياسي بكل الوسائل المتاحة بالترهيب بهدف إرساء الملك الوراثي الاستبدادي بالغلبة والقهر أو بفرض سلطة الدولة بالاصطلاح الحديث والترغيب من جهة اخرى باستقطاب العلماء وتوظيف نفوذهم الروحي والديني.
وإزاء هذا الوضع تباينت مواقف العلماء بين من فضل التقارب من السلطة لاحتواء الفتنة وحقن دماء المسلمين من منطلق أن الحفاظ على الدولة هو ضمانة للحفاظ على وحدة الأمة وعدم تشرذمها، ومن جهة أخرى دفع السلطة لتحقيق مقاصد الشرع عن طريق الانخراط في أجهزتها والاشراف على بعض وظائفها كالقضاء والتعليم والحسبة.
وفي مقابلها برزت فئة أخرى من العلماء شكلت طليعة قادة الحركات الاحتجاجية المناوئة للسياسات الرسمية ويذكر التاريخ الإسلامي في هذا الصدد نماذج للعديد ممن فضلوا المواجهة على المهادنة والجهر بالحق عوض ضمان السلامة الشخصية منهم ثورة القراء أو الفقهاء سنة (81 هـ) التي شارك فيها التابعي سعيد بن الجبير ضد سياسات الحجاج بن يوسف الثقفي والي الأمويين على العراق ومحنة الامام مالك بعد اتهامه بالتحريض على الثورة ضد الدولة العباسية.
وبالرغم من الدور المحوري الذي لعبه بعض الفقهاء في التصدي لسياسات وممارسات السلطة باعتبارهم حراس الدين، فقد عانى هذا التيار المناوئ للسلطة من ضعف من حيث الامتداد والتأثير في مقابل تيار فقهاء السلطة الرسميين الذي استفاد من الدعم المالي والمعنوي مما مكنهم من الاستئثار بالمجال الديني وتصدره خاصة خلال العهد العباسي مروجين بذلك لفقه الغلبة والتمكين وهو ما سيشكل الزواج الرسمي للسلطتين الدينية والزمنية الممثلة في الدولة السلطانية.
طبيعة العلاقة بين الفقيه والسلطان
تميزت الدولة السلطانية بمجوعة من السمات طبعت شكل هياكلها وإدارتها للشأن العام وفي غالبها شكلت محاكاة للتقاليد السياسية القيصرية والكسروية كنتيجة للتلاقح الحضاري الذي حصل بعد الفتوحات الواسعة، حيث ثم اقتباس نظرية الحق الإلهي في الحكم وأسلمتها عبر صياغة خطاب ديني يضفي عليه الشرعية وهالة من القداسة.
وبفعل غياب غياب إطار محدد لشكل الدولة وهياكلها السياسية، روج الفقهاء من منطلق دورهم التشريعي والوعظي لفقه جبري قائم على إضفاء الشرعية على احتكار السلطة وإلغاء أي دور للأمة في صنع القرار أو مشاركة في الشأن العام، كما عهد سابقا في الخلافة الراشدة حينما كان للعامة الحق في الاعتراض على القرارت الصادرة عن الخليفة وحصر دورهم في تقديم النصيحة للحاكم وتذكيره بالشروط الأخلاقية أو كما عرفت في الأدبيات التاريخية بالآداب السلطانية، وهي مجموع ما كتبه الوعاظ والكتاب المسلمون في السياسات السلطانية.
ويكفي أن نشير لبعض الآراء الفقهية لنرى الغلو الذي ميز هذا الخطاب الديني والسياسي في إضفاء صفة إلهية على السلطان وتبرير استبداده عبر استجماع آيات واحاديث في صفات الله والملك والمماثلة بينهما، يقول الماوردي في كتابه نصيحة الملوك وهو أشهر فقهاء السلاطين أن الله جل وعز أكرمهم بالصفة التي وصف بها نفسه، فسماهم ملوكًا وسمى نفسه ملكًا.
ولذلك فليس من الغريب أن يصل السلطان إلى ذروة طغيانه واستبداده بعد أن ينال هذه المباركة والقداسة الدينية، ولنتمعن في مقولة أبي جعفر المنصور في خطبة يوم عرفات، ففيها ما يؤكد طابع جنون العظمة الذي ترسخ في عقله الباطن، إذ يقول: أيها الناس إنما أنا سلطان الله على أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده، وأنا خازنه على فيئه أعمل بمشيئته وأقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه.
ولعل البعض قد يتساءل عن أسباب هذا الاستتباع الذي ميز علاقة العلماء بالسلطة الحاكمة وتحول الدين إلى جهاز رسمي يقصد به تبرير الممارسات السياسية وآلية لهندسة الذهنية العامة يرجع بالتأكيد إلى عقدة الخوف من الفتن التي ظلت مترسخة في الذهنية العامة للمسلمين، خاصة بعد الفتنة الكبرى ومارافقها من أهوال حروب وثورات.
ولا يمكن إغفال أهمية توظيف الحوافز المادية من عطاء واقطاعات سخية في كسب ولاء الفقهاء، خاصة أن العديد منهم شكلوا نخبة اجتماعية راقية، لذلك فمن المنطقي أن تدافع عن أجهزة الدولة وممارستها ما دامت مستفيدة من الأوضاع السياسية والاقتصادية وبناها الاجتماعية.
شكل الملك العضوض أو الاستبدادي في العرف الفقهي ضمانة ضد الفوضى ووسيلة لتحقيق السلم الاجتماعي، حتى وإن استند إلى التعسف، وفي هذا الصدد يمكن استحضار العديد من الآراء الفقهية معبرة عن هذا التوجه، يقول القرطبي ظلم السلطان عام أقل أذى من فوضى الناس لحظة واحدة، وفي نفس السياق يقول كذلك ابن تيمية ظلم سنة خير من فوضى ساعة.
وهكذا أدى تضخيم الحاجة إلى السلطة والتخويف من الاعتراض عليها إلى تبلور فقه الاستبداد منتجًا بذلك نمطًا سياسيًا على رأسه حاكم فوق المحاسبة والنقاش وتسويغه دينيًا من منطلق ولاية الأمر الذي لا يجوز الخروج عليه وضرورة طاعته أيًا كانت وسيلة وصوله للحكم، سواء بالوراثة أو التغلب على حاكم آخر أو باختيار أهل الحل والعقد.
وكان لتبلور هذا الاتجاه الفقهي وشيوعه عواقب عميقة على نظام الحكم بالتغاضي عن مساوئه خاصة تعطيل مبدأ الشورى كآلية لتقاسم السلطة بين الحاكم والرعية أو الأمة وإلغاء حقهم في المحاسبة والمساءلة مكرسًا بذلك علاقة عمودية فوقية قائمة على القمع والتسلط ومن جهة أخرى أعاق هذا الفقه الجبري تطور الحياة الفكرية والاجتماعية ومانعًا إياه عن تشكيل نظريات سياسية تعيد الاعتبارات الأخلاقية في الحياة السياسية وتحقق مقاصد الاسلام، مما شكل كذلك من جملة الأسباب المسؤولة عن التراجع الحضاري والضعف الذي عانت منه الأمة الإسلامية بعد قرون عديدة من حكم الدول السلطانية من الأمويين ابتداء إلى العثمانيين انتهاء.
وبعد أن تتبعنا الجذور التاريخية للاستبداد في التاريخ الإسلامي الذي قادنا إلى لحظة وصول الأمويين إلى السلطة، وما رافق ذلك من انقلاب في فلسفة الحكم ومبادئه بعد تحول الدولة الاسلامية إلى دولة سلطانية وراثية، وبيننا الدور الخطير الذي لعبه الفقهاء في التمكين، لذلك سنتعرف في الجزء الثاني من المقال على الآثار العميقة للاستبداد على الأوضاع السياسية والاجتماعية في عصرنا الراهن.
هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست
علامات
الاحتجاجات وحدها لا تكفي للإطاحة بديكتاتور: ماذا عن موقف الجيش؟
حازم حميد
قراءة في كتاب «التراث والمعاصرة»
عماد الدين محمود
بوتفليقة يترشح ببرنامجه!
سليمان شويحة
الربيع العربي المنتظر
هيثم ناصر
المصادر
هل يعيد التاريخ نفسه؟