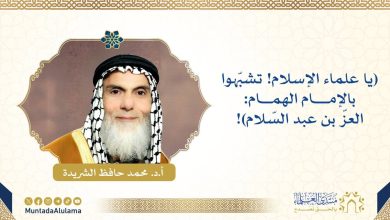العلم أم الدين.. كيف يتخلص الباحث المسلم من هذه الأزمة؟
بقلم محمد عبد النور
إن كلا من العلم والدين ناشئ عن حاجة معرفية، والمشتغلون بهما أصحاب وظيفة رمزية، وأن الفارق هو كون الدين يقدّم التفسير الغيبي الذي يتجاوز المدارك، والعلم يقدّم التفسير السببي الذي تصل إليه المدارك، منهج الأول يقوم على الإطار الغيبي وبيان أبعاده استنادا إلى مخاطبة الإله للبشر، ومنهج الثاني يقوم على الإطار الطبيعي وبيان الأسباب استنادا إلى القوانين التي تحكم البشر، لذلك كان السؤال هو عن علاقة المعرفتين ببعضهما ومنهج كل منهما، فقد تقدّم بيان اختلاف وظيفتهما وطبيعتها؟
الجواب على ذلك يقتضي معرفة ما صبغ ذروة كليهما: فذروة الأديان الإسلام تاريخيا ويفترض أن يكون أرقى ما وصل إليه الفكر الديني، وذروة المعرفة العلم الحديث ويفترض أن يكون أرقى ما بلغه الفكر البشري، أو على الأقل كافتراضين يُتحقق منهما، وذلك يعني أنه علينا تمحيص طبيعة كليهما كما يلي:
لتجاوز الحيثيات التاريخية من المهم التوقف رأسا عند تمحيص علاقة الغيب بالأسباب، فالعلم السببي يستند إلى مكاشفة المجهول، ومن ثم فإنه يقوم على حقيقة الكشف المستمر للمستور في إطار الطبيعة، وأما الدين الغيبي فيستند إلى حقيقة أن الإنسان دائما وأبدا يبقى رهين المجهولات، ومن ثم فإنه يستحيل على العلم مهما تقدّم ووسع من اكتشافاته فإنه لن ينهي المجهولات، لكنه مقابل ذلك يعظّم من قدرات الإنسان في التحكم في الطبيعة والكون، ويعلي من شأنه وسيادته على الكون. والواضح أن ما يسعى العلم إلى كشفه من أسباب كان في حكم الغيب، أو على الأقل يفسر تفسيرا غيبيا، فكان تصور الإنسان أول الأمر أن أرواحا تسكن تحت الأرض تتولى مهمة إنبات النبات مثلا، فلما جاء العلم كشف الطريقة التي بها تنمو النباتات، لكن هل نفى العلم أن توجد أرواح فعلا تحت التربة؟!
هنا نكتشف أن العلم الذي يساعد على التحكم في الطبيعة ليس بوسعه إثبات أو نفي وجود إله أو آلهة، كما أن الدّين والغيب لا يكون موضوعا للإثبات العقلي أو نفيه، وهذا طبيعي لاختلاف طبيعة كل منهما. ولعل أهم فكرة ميزت الإسلام أنه استند إلى حقيقة الإله الواحد المحيط المنزّه عن كل تجسيد، فكان أن ابتعد الدين كفكرة عن كل منافسة للعلم البشري بما هو علم سببي بالمادة، وذلك يعني أنه مهما تضاعف التحكم البشري في الطبيعة عن طريق العلم، فإنه يبقى ضمن إطاره الذي يختص به. ولئن كانت العلاقة بين الدين والعلم إذن تتحدد في الأسباب وارتباطها بهما، فإن صفة المؤمن أنه يبقى دائما مسلّما بوجود ما يتجاوز الإنسان، ولكن هل يعني ذلك أنه سيقف ضد تقدّم العلم حفاظا على مجال الإيمان؟
إن العقل والمنطق لا يمكنه أن يسلّم بذلك، إن الخرف أو الزهايمر مثلا يكشف عن أن عقل الإنسان مات دون جسده! فالعقل إذن هو مادة طبيعية تتعرض بالضرورة للتلف ضمن مدّة معينة، وبالتالي فإن معنى ذلك أن الإنسان فان، وحتى لو تصورنا أن الإنسان طوّر آليات ووسائل بها يمد من عمره العقلي والجسدي معا فهل ذلك سيكون طبيعيا؟ حتما لا، والواقع أن الرؤية التطورية تكشف أن عمر الإنسان آيل إلى النقصان!
ومن ثم فلا إمكان للتدخل في الطبيعة وغاية ما هنالك أن يستقصي الإنسان تاريخه التطوري ليكتشف طبيعته ويتنبأ بتحولاتها المستقبلية على المديات الطويلة جدا. أما بخصوص الدين فالسؤال الحارق فيه هو هل أن الفكر الديني “عقيدة وشريعة” يتحرّك على غرار الفكر العلمي، فما دام العلم يتحرّك في مجال الدين بفضل التمدّد في الكشف السببي، فإن الدين لا يعاكس العلم بالتحرك في مجاله إنما الدين يهيئ المناخ المرجعي لتحرّك العلم لتحقيق أهداف الدين التي تتمثل في الاستخلاف في العمران، وهذا الافتراض تؤكده مقولة أن لا نهوض أو دوافع حضارية إلا بالفكرة الدينية.
والإشكالية تطرح حول كيفية استعادة الدين الذي يمكّن من ذلك، حيث الواضح أن الأمر اجتهادي صِرف، يصل في مدياته القصوى إلى البحث عن “روح الدين” في عملية النهوض دون التعلّق بظرفيات محدّدة، وعلى ذلك يجد البعض وجاهة في القول بأن “إغفال الدين” هو أسهل الطرق التي تمكن من اللحاق بركب الحضارة البشرية؟
إن المتديّن يتكلم عن روح الدين بمنهج اختزالي، وغير المتدين يتحدّث عن إغفال الدين بمعنى الثقة في قدرة الإنسان، فما دام الدين حقيقة فطرية فإنه سيتواجد بالضرورة في كل التفاصيل، وعلى ذلك فإن الحاجة إلى مرجعية ثابتة ولو لاستخلاص روحها أو إغفالها تسليما بوجودها الضمني، هو الذي يجعل المسلم يتعلّق دائما بلحظةٍ تاريخيةٍ ما يسعى لاستحضارها بأية طريقة، باعتبارها اللحظة المؤسسّة، فتبقى كيفية الارتباط بتلك اللحظة المعيار لكل التوجهات في درجته وكيفيته.
وتلك هي الميزة والخصوصية التي تشكل قطب الرحى في كل المخاض الفكري للباحث المسلم، ميزة انشداده إلى الماضي التي لا تمنعه من الإبداع، ذلك أن دعوى معاداة الدين إنما تنشأ عن اعتقاد فاسد بأن الإيمان الديني والالتزام بشرائعه يتسبب بالضرورة في الجمود العقلي الذي يتعذر معه تقدّم العلم، سواء بكونه يقف حجر عثرة أمام العلم، أو أنه ارتباط غير وظيفي بالماضي، فكيف يمكن أن يكون الإيمان الديني دافعا للإبداع؟
بداية، لما كان الإيمان الديني بعامة موضوعيا كانت كونيته تحصيل حاصل، من خلال فكرة الإله الواحد والمحيط وغير المتجسد، والإحاطة هنا هي بالأسباب التي يسعى العلم لاستكشافها، فلو نظرنا إلى الشريعة في الإسلام وجدناها تحيط إنسانها بقيود كثيرة من الناحية السلوكية، أما لو نظرنا إلى الاعتقاد لوجدناها جملة من المبادئ المحررة للفكر، فيصف نفسه بأن جاء ليضع الإصر والاغلال، ولا إكراه في الدين، وما أنت عليهم بمسيطر، الأمر بالتفكر وبالنظر في الكون والطبيعة والنفس؛ فالإسلام إذن قد هيأ المناخ الفكري لتحقيق النهوض العلمي والسياسي بأوسع المعاني.
وذلك معنى محورية مفهوم الفطرة في الدين الخاتم، فالفطرة لا تدل على ثبات في الخلق بقدر ما تعني مناقضة التدخّل في الطبيعة وإفساد الخلق، كما أن الفطرة تحمل دلالة على التفكير السليم الذي يسعى لتسخير أقصى قدرات العقل في ذات الوقت الذي يسلّم فيه بحاجته إلى بيان خارجي يقدّم الملامح العامة للتفكير وكيفية التصرف في الكون كسيّد عليه. وذلك ما يشكل جوهر الأزمة الإنسانية الراهنة وهي:
1- التدخّل الإنساني في الطبيعة والتصرف بغير ما تقتديه الطبائع. إطلاق الإرادة دون تحفظ.
2- الثقة المطلقة في العقل البشري واستغنائه عن موجه خارجي. إطلاق العقل دون تحفظ.
فإطلاق الإرادة دون تحفظ تحدده التشريعات، فعلى ما في التربية من إمكانية لبناء الضمير الإنساني إلا أن الضمير الديني المرتبط بحساب بعدي يعدّ الحصانة الأضمن من انحرافات الإرادة البشرية، أما إطلاق العقل دون تحفظ تحدده الاعتقادات، فعلى ما في التكوين العقلي من إمكانية لبناء الفكر الإنساني إلا أن التفكير الديني المرتبط بحدس العواقب يعد الحصانة الأضمن من انحرافات العقل البشري.
وذلك يعني ارتباط المسلم دائما بوازع ذاتي من رغم كونه على ما يبدو توجيه خارجي هو النص الديني إلا أنه نداء متلاحم مع جوهر الخلق الإنساني يجد فيه الإنسان طبيعته الذاتية التي خلق منها، وذلك معنى أن العبادة إراحة للإنسان من قيود الدنيا ومصالحها التي كثيرا ما تخالف الأصالة الوجودية للإنسان على غرار الراحة في الصلاة والصوم مثلا؛ فالارتباط بالنص الديني هو تعلّق دائم بمرحلة الفعل المؤسس للحضارة الإسلامية وذلك ما يميز شكليا الباحث المسلم، والمفارقة أن هذا التعلّق هو الذي يعطي لمبدأ التقدّم التسديد المطلوب ويعطي الإحداثيات المطلوبة لتحقيق الأمن الوجودي للأفراد والغايات المرجوة للجماعات.
وأخيرا فإن منطلق الباحث المسلم استعادة الفطرة إلى التطور البشري، بتأطير الإرادة بالقواعد السلوكية الضابطة وتأطير العقل بالحرية المسؤولة، والتعاون في ذلك مع كل من يدرك جوهر الأزمة الإنسانية الراهنة ويعمل صادقا على إيجاد حل لها، وأن ميزة الحل الإسلامي للأزمة الإنسانية هو حل جمعي وليس فردي، فالعاملون من أجل الحق والحقيقة موجودون في كل مكان لكن حلولهم سوف لن تتجاوز فرديتهم حتى إذا ما اعتنقوا الإسلام مثلا، وسوف لن تتجاوز التصورات إذا أسلموا تصوريا وبحثوا عن الفطرة، أما الحلول التي تأتي من صلب الجماعة المسلمة فيكون لها تأثير جمعي فعّال تصوريا وسلوكيا. والمحصّلة هي أن أزمة المسلمين الحضارية هي تجل موضوعي للأزمة الإنسانية، وأن شروط الخروج بالمجتمع العالمي إلى بر الأمان هي ذات خروج المسلمين من تخلّفهم واستئناف حضارتهم.
(المصدر: مدونات الجزيرة)