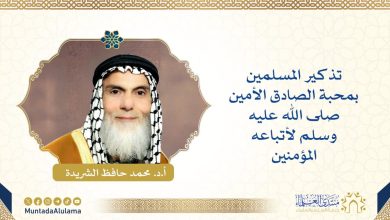الثنائيات الجدلية وأزمتنا الحضارية
بقلم محمود المنير
لقد تمّ تقسيم الأمّة الإسلامية إلى ثنائيات قابلة للاحتراب الداخلي ومؤججة للصدام الديني، والصراع المذهبي، ومن هذه الثنائيات المتعددة: “السني-الشيعي، السلفي-الصوفي، العقلاني-العرفاني – البدو – الحضري”، إلى غير ذلك من الثنائيات الجدلية التي تحمل فيروس التعصب الأعمى والمفضية للتلاشي الحضاري الذي تشهده أمتنا العربية والإسلامية منذ عدة قرون، وهي تمثل انعكاساً واضحاً لغياب فقه الاجتهاد والقدرة عليه لإعادة بناء وصياغة العقلية الإسلامية بناءً حضارياً يؤصِّل لمنهجية وسطية حضارية تفهم هذا الدين وتساهم في التعاطي مع آفاقه الرحبة في صناعة الحضارة والرقي بالإنسانية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من بناء المشروع الحضاري، والإنساني، والكوني، للأمّة الإسلامية.
والمتتبع لتاريخ الفكر الإسلامي يجد أن جدلية هذه الثنائيات قد ظهرت مبكراً في أواخر الخلافة الراشدة إبان الفتنة بين سيدنا علي، ومعاوية، رضي الله عنهما، ثم تجلت مع ظهور المذاهب الفكرية، التي أفرزت ثنائيات جديدة مثل ثنائية، وظلت مؤثرة في ثقافتنا وأمتنا حتى الآن مثل العقل والنقل، أو الرأي والحديث، غير أن هذه الثنائيات قد تميزت بأنها كانت تعبيراً عن اتجاهات فكرية وفقهية متكاملة، ولم تُفض إلى صراع أو صدام كما هو حاصل الآن، ولم تكن مصدرًا مفضيًا إلى التيه، بل كانت مصدراً ثرياً للتلاقح والتمايز والتنافس الفكري الذي حرص عليه أئمة هذه المذاهب الفكرية في رحاب ميادين واسعة من المودة والأخوة والاجتهاد، ولا سيما وقد كان ظهورها مصاحبًا لريادة نهضوية شاملة للحضارة الإسلامية.
لكن أصبح الأمر مغايراً في العصر الحديث، حيث ظهرت ثنائيات ذات طبيعة مختلفة تماماً، أسس لها وأشعل نيرانها المضطرمة الاستعمار الذي اجتاح الدول العربية والإسلامية في نهاية القرن الثامن عشر، التي مثلت مرحلة انتقالية كشفت عن انحدار حضاري في الشرق قابله صعود حضاري للغرب!
هذه الثنائيات تمثل انعكاساً واضحاً لغياب فقه الاجتهاد والقدرة عليه لإعادة بناء العقلية الإسلامية
ثنائية الإسلام أو العلمانية
وكانت أولى هذه الثنائيات في هذه المرحلة “الإسلام أو العلمانية”، تلك الفكرة المسمومة والإجابة المضللة عن التساؤل الكبير الذي فرضته مرحلة الاستعمار؛ لماذا تخلفنا؟ وكيف نهضوا؟ حيث بث الاستعمار ثنائية جدلية ما زالت مستمرة حتى الآن، وهي أنهم تقدموا لما تركوا الدين جانباً، وثاروا على تعاليم الكنيسة؛ فانطلقت الثورة الصناعية ونهضت أوروبا، ونحن تخلفنا لأننا متمسكون بالدين، وعلينا أن نتخلى عن ديننا إذا أردنا أن نلحق بهم، وكان الخيار المضلل والمطروح على الأمة هو إما أن تظل تحت الجمود الذي أصاب الخلافة العثمانية، أو تتحرر منها وتلحق بركب الحضارة الغربية، وأخفوا عن عمد الخيار الثالث؛ وهو أن تعود الأمة إلى الإسلام من جديد حيث نبعه الصافي وقيمه السامية وروحه الحضارية المتجددة، كما كان “النموذج الأول” على عهد الخلافة الراشدة.
الصراع المفتعل
فإذا بقادة الفكر والثقافة والسياسة والنخب في تلك المرحلة ينقسمون وتنشب بينهم معارك كلامية وفكرية زادت من الحيرة، وخيّم التيه على الأمة بفعل هذه الثنائيات المضللة التي تدور معظمها حول دور الدين والموروث الثقافي في عملية النهوض المنشود، وذلك تحت عناوين مفرقة كثيرة تطرح معظمها أسئلة خارج مقرر مسارات النهوض التي تناسب مرجعية الأمة وهويتها وعقيدتها، وتقيم صراعاً مفتعلاً بين أسئلة النهضة والهوية والعمل والأخلاق، بدلاً من أن يتركز النقاش حول كيفية الالتفاف حول سبيل واحد يرتكز على قيم جامعة ومجمعة مثل الاستقلال والتميز الحضاري، والحرية، والعدل، والمساواة، والشورى، والعمران.. باعتبارها المبادئ المؤطرة للاستخلاف الرشيد الذي كلف الله به الإنسان منذ هبوطه على الأرض، والمنبثقة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
مسار الانحدار الحضاري
والمتتبع لمسار الانحدار الحضاري يجد أن هناك نماذج متعددة ومتتابعة لثنائيات التيه أفضت إلى التلاشي الحضاري، وشكلت معوقاً كبيراً أمام جهود العلماء والقادة والمفكرين لاستعادة الأمة لريادتها وعصفت بكل الجهود الرامية لاستئناف مسيرة الشهود الحضاري من جديد، بل وأطاحت بعملية الإصلاح الحضاري برمتها، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ثنائيات: العقل والنقل، الدين والعلم، الإسلام والعلمانية، القديم والحديث، الديني والسياسي، الشريعة والقانون، الديمقراطية والشورى، الخصوصية والعالمية، الإسلام والحكم، الأصالة والمعاصرة، الإسلام والقومية العربية، الدولة الدينية (الإسلامية) والدولة المدنية.. إلخ.
الفروق بين الشريعة الإسلامية والقانون ليست بالضخامة التي كان يصورها المتصارعون
ثنائية الشريعة والقانون الوضعي
وإذا ما أردنا أن نأخذ مثالاً على أبرز هذه الثنائيات التي شغلت الأمة، نجد ثنائية الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي –كنموذج- كانت من أبرز الثنائيات الصراعية التي ثارت حولها نزاعات مفتعلة، وكانت محلاً للمزايدة فيما بين الحركات السياسية الساعية إلى السلطة، التي استغلها كثير من الأنظمة العربية الحاكمة في الإلهاء عن استبدادها وتغولها وتبعيتها المشينة للقوى الاستعمارية الكبرى.
والمدهش أن الفروق بين الشريعة الإسلامية والقانون ليست بالضخامة التي كان يصورها المتصارعون أو يتصورونها، وأحكامهما الفرعية لا تتناقض تناقضًا صريحًا إلا في مسائل محدودة (رغم أهميتها بالطبع)، ولذلك حين جلس الشرعيون والقانونيون (ومن ضمنهم مسيحيون!) لسنّ قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية -أو على الأقل غير مناقضة لها- في لجان شكَّلها البرلمان المصري لهذا الغرض في الفترة من عام 1978-1982م، لم يوجد أثر يذكر في الواقع العملي لهذا الصراع المفترض بين الشريعة والقانون، ولم يثر خلاف واحد (معلن على الأقل) بين المجتمعين استنادًا للهوية الدينية أو الثقافية، بل انتهت اللجان من عملها كاملاً دون ضوضاء أو ضجيج!
هذه الحالة النموذجية تبين إلى أي مدى يمكن أن تؤسس الثنائية المفرقة على معطيات غير واقعية، وأنها من الممكن أن تكون محلاً للنقاش لا للسجال المبني على وضع كل منها في مقابل الأخرى غفلة عن إمكانية الجمع بينهما، وهو أمر يرجع في ظني إلى تسييس النقاش حول قضايا ثقافية بطبيعتها، كان الأجدر أن يتولاها المتخصصون لا الإعلاميون والسياسيون.
تجاوز الثنائيات هو الحل
نعم، الحل هو الهجر والإعراض؛ أي تجاوز هذه الثنائيات إلى غير رجعة وتجاهلها، والتركيز -بدلاً من الوقوع في فخاخها- على المشكلة الأساسية التي يعاني منها العرب والمسلمون منذ قرون، وهي تقهقرهم إلى ذيل الأمم حتى أوشكوا على الخروج من التاريخ، بل ومن الجغرافيا كذلك!
الحل هو الإعراض وتجاوز هذه الثنائيات بدلاً من الوقوع في فخاخها
وهذا الحل نادى به ضمنيًا من قبل المفكر الجزائري مالك بن نبي الذي ركز على المشكلات الكبرى التي يتعين على المسلمون أن ينتبهوا إليها، ولا يلههم عنها أحد، وجمعها كلها تحت عنوان واحد؛ وهو “مشكلات الحضارة”، وهو العنوان الذي ألف تحته كل كتبه القيمة، التي سبرت أغوار التخلف في العالم الإسلامي وكشفت كيف يستغله الآخرون للهيمنة عليه، أو بمعنى آخر، وعلى حد تعبيره: “القابلية للاستعمار والاستعمار” (انظر على سبيل المثال كتبه: “شروط النهضة”، و”وجهة العالم الإسلامي”، و”مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي”.. وغيرها).
وعلى الرغم من أن “المنظور الحضاري” لمشكلات العرب والمسلمين لم يقتصر على مالك بن نبي وحده، بل هناك آخرون نبهوا إليها، مثل: علي عزت بيجوفيتش، وعلي شريعتي، والشيخ محمد الغزالي، ود. عبدالوهاب المسيري، ود. منى أبو الفضل، فإننا نلحظ أن هذا الفكر العميق الشامل لم تكن له الريادة ولم يُلتفت إليه إلا قليلاً، حتى إننا نستطيع أن نطلق عليه مسمى “الفكر المهجور”، وعلى المنادين به “المفكرين المنبوذين” الذين نبذهم التخلف ومن يرسخونه معًا عن وعي وقصد أو بدونهما، بل وحورب معظمهم من المعرقلين للفكر الحضاري في الداخل والخارج، وانظر إلى ما رواه كل من مالك بن نبي، وعلي شريعتي، عما تعرضا له من إهمال وتضييق ومكر سيئ في كثير من كتاباتهما للتحقق من ذلك!
على أي حال، فإن هجر ثنائيات التيه سيحدث تلقائيًا عند تحديد قيمنا وأهدافنا الكبرى والتوحد خلفها، مما سيدفعنا إلى التركيز على تحقيقها عوضًا عن الالتفات إلى تلك الثنائيات؛ فمثلاً: حين يثير أحد ثنائية الشريعة والقانون علينا أن نتحدث بدلاً من ذلك عن سيادة القانون (سواء كان مستمدًا من الشريعة الإسلامية من عدمه، فالتفكير في هذا الأمر مرحل إلى حين استعادة الأمة لسيادتها)، وإذا أثار البعض ثنائية الدولة الدينية والدولة المدنية فعلينا أن نقول: بل “الدولة العادلة” التي لا تظلم أحدًا، مسلماً كان أو غير مسلم، وإذا حدثنا أحدهم عن القديم والحديث، سنرد بأن ما يحقق نهضتنا سنأخذ به قديمًا كان أو حديثًا أو خليطًا بينهما!
وعلى المنوال المتقدم سوف نتخلص تدريجيًا من سجالية تلك الثنائيات لمصلحة أهدافنا الحضارية الكبرى، وهي أهداف لا يختلف عليها اثنان بشرط رشدهما وفقههما للأولويات الحضارية وترتيبها.
(المصدر: مجلة المجتمع)