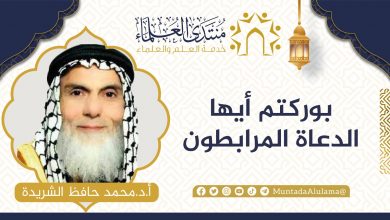بقلم أحمد التلاوي
من ضمن أبرز ما طالته عمليات الهدم المُنظَّمة التي تتم في الوقت الراهن لكل ما هو يحمل صبغة “مسلم” أو “إسلامي”، قضية المشروع الإسلامي، ليس لجهة صفته فحسب، ولكن لجهة متطلباته أيضًا.
ولعلها هي النقطة المهمة، نقطة المتطلبات هذه؛ ذلك أن الأمر لا يقف عند مستوى قضية الصورة الذهنية أو صفة المشروع الإسلامي وكل ما يتصل بذلك.
فقضية المتطلبات هذه ترتبط بالطرف الأهم عند الحديث عن المشروع الإسلامي ومشكلاته وصيروراته وما يعترضه من عوائق، وهو الطرف الذي يتبنى المشروع الإسلامي كمساق وهدف له.
فالأطراف المعادية للمشروع الإسلامي، وتتصدى له معروف أمرها، وواضحٌ مكرها، وإن مكرهم لتزول منه الجبال! وتصديهم للمشروع الإسلامي، سواء مَن هم بين ظهراني الأمة، أو على مستوى العالم، بادٍ وواضح منذ حديث البعثة النبوية العظيم، سواء من المنافقين أو يهود المدينة، أو منذ أن بدأت الدولة الرومانية في التحرش بحدود الدولة الإسلامية الوليدة في شبه الجزيرة العربية.
المشكلة الأكبر تكون في أصحاب الشأن أنفسهم، فأنا كمسلم متحمس للمشروع الحضاري الإسلامي، ومؤمن أن الإسلام إنما نزل لخير الإنسانية والعالم -أفهم جيدًا ما يسعى إليه خصومه، وأتحرك فيما يجب ذلك، ويساعد على تقدم المشروع، وتنبيه العالم إلى أن ما يدعيه خصومه إنما هو باطل.
أما لو جاءت المشكلات من الداخل، فإن ذلك يعني التخريب الكامل لأية جهود في الاتجاه الإيجابي، ويمس نشر الدعوة نفسها .
وربما يكون هذا الكلام، ومثل هذه التحذيرات، من مكرور القول، وردده علماء ومفكرون كبار في العقود الأخيرة، عندما انساحت الدعوة في أرجاء العالم، وبدأ يدخلها منتفعون أو متحمسون، قادوا بسلوكهم إلى تشويه الصورة من الداخل.
إلا أن هذه المشكلات التي نتكلم عليها، زادت بشكل بشع في السنوات الأخيرة، بعد نجاح مخطط أعداء الأمة في الترويج لنماذج مشوهة ومشبوهة مثل تنظيم الدولة “داعش”، على أنه صنو المشروع الإسلامي، وأن هذا النموذج هو الذي يقدمه المسلمون إلى العالم، وأن هذا هو “الجهاد” وفق المفهوم الإسلامي.
والمدهش في الأمر أن المسلمين الذين قدموا للعالم، طيلة أربعة عشر قرنًا من الزمان، كل ما هو حضاري من قوانين وسياسات، وقدموا حضارات راسخة إلى الآن، في بلاد الغرب ذاته –الإسبان يعتبرون الحضارة الأندلسية من مكوناتهم التاريخية على المستوى الإنساني– قد تم تشويههم بشكل مروع في بضعة عقود أو بضع سنين، بصورة قضت على هذا التاريخ العميق!
ويعود ذلك إلى أن الإعلام في وقتنا الراهن، قد تطور وتطورت آلياته، وما كان يستغرق سنوات لكي يصل إلى الناس في الماضي صار فقط يتطلب الوقت الذي تستغرقه “ضغطة” زر، أو حركة إلكترون يساوي في سرعته سرعة الضوء! أي أنه قادر على لف الكرة الأرضية ثماني مرات تقريبًا في الثانية الواحدة!!
إن الإعلام في وقتنا الراهن، قد تطور وتطورت آلياته، وما كان يستغرق سنوات لكي يصل إلى الناس في الماضي صار فقط يتطلب الوقت الذي تستغرقه “ضغطة” زر، أو حركة إلكترون يساوي في سرعته سرعة الضوء
وعلاج هذه المشكلة أمر شديد الصعوبة في الوقت الراهن، بسبب فقدان الحركة الإسلامية لإطار شامل جامع بسبب منظومة من المشكلات الداخلية، والتي لو لم تكن موجودة، ما نجحت مشروعات التشويه والتشتيت الخارجية.
وربما يكون الحديث التالي مرسلاً، إلا أنه في طياته يحمل الكثير من الأمور ذات الطابع التفصيلي المحدد.
فالمشروع الذي يستحق أن يحمل صفة “الإسلامي” ينبغي أن يتصف بالطابع الشمولي العام للإسلام، وما دون ذلك؛ فهو ليس بمشروع إسلامي ، ويصلح فقط كنظرية متممة، أو جانب مكمِّل، أو ليس من المشروع أصلاً.
أي أن يعكس في أدبياته وحراكه العام كل ما أتى به الدين في أصوله الصحيحة، وهي القرآن الكريم وصحيح السُّنَّة النبوية، وكما جسدته الممارسة الفعلية في عهد النبوة وفي عهد الخلافة الراشدة.
وهذا الأمر ليس مجرَّد شعارات أو حديث عام؛ ذلك أن عليه أدلة شرعية.
الدليل الأول، أن الله تعالى أتم الدين في عهد النبي “صلَّى الله عليه وسلَّم”. يقول تعالى في القرآن الكريم: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [سُورة “المائدة”– من الآية:3]، وهي الآية المدنية الوحيدة في هذه السُّورة الكريمة.
ومن ذلك وفق اعتقاد خاص أن حكمة الله عز وجل شاءت أن تكون السيرة النبوية، قبل وبعد البعثة، فيها كل ما يمكن أن يُعرَض على الأمة من صروف وأحداث، بحيث يجد المسلمون في السُّنَّة النبوية ومدوَّنة السلوك النبوي فيها ما يغنيهم عن أي شيء.
حكمة الله عز وجل شاءت أن تكون السيرة النبوية، قبل وبعد البعثة، فيها كل ما يمكن أن يُعرَض على الأمة من صروف وأحداث، بحيث يجد المسلمون في السُّنَّة النبوية ومدوَّنة السلوك النبوي فيها ما يغنيهم عن أي شيء
وأهمية ذلك أن فترة البعثة كان الرسول الكريم “صلَّى الله عليه وسلَّم”، مُؤيَّدًا بالوحي، وكان القرآن الكريم ينزل بالتصحيح في حال اجتهاده من دون وحي، والقرآن الكريم يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سُورة “الحشر”-من الآية:7]، والآية الكريمة ربط الله عز وجل فيها، طاعة الرسول “صلَّى الله عليه وسلَّم” بالتقوى، وتعهد بالعقاب الشديد لمن خالَف.
أما فترة الخلافة الراشدة فهي كذلك مؤيَّدة بالدليل الشرعي.
فحديث النعمان بن اليمان “رضي اللهُ عنه”، الذي حسَّنه الترمذي، قال الرسول الكريم “صلَّى الله عليه وسلَّم” في بدايته، إن الفترة التي سوف تليه؛ سوف تكون خلافةً على منهاج النبوة، أي كأننا في عهد البعثة النبوية، ثم ختم النبي “صلَّى الله عليه وسلَّم”، بالحديث عن أنها سوف تعود “خلافة على منهاج النبوة” في آخر الزمان.
أي أن الرسول الكريم “صلَّى الله عليه وسلَّم”، أكد لنا أن المشروع الإسلامي سوف يعود وينتصر عندما تكون الأمور على منهاج النبوة .
وأكبر الأخطاء التي وقع فيها المسلمون والطليعة الحركية منهم في القرون المتأخرة على وجه الخصوص، ويرتبط بمخالفة هذا التصور الإلهي النبوي المُحْكَم، هو فرض حكم الاستثناء في الإطار العام الطبيعي، فتحولت حياة المسلمين أمام العالم بأسره إلى مجرد أنها حياة قتال وتشرُّد وبدائية، بينما الإسلام فيه القتال والجهاد، وفيه –أيضًا– المدنية والمدينية ومختلف مفردات الحضارة.
من الخطأ فرض حكم الاستثناء في الإطار العام الطبيعي، فتحولت حياة المسلمين أمام العالم بأسره إلى مجرد أنها حياة قتال وتشرُّد وبدائية، بينما الإسلام فيه القتال والجهاد، وفيه –أيضًا– المدنية والمدينية ومختلف مفردات الحضارة
وهذا جزء من مفهوم الوسطية الذي تحدث عنه القرآن الكريم عن الأمة الإسلامية، وكذلك ضمن مفهوم الشمولية الذي يميز الإسلام.
ولقد وضع الله تعالى دينه الحنيف للناس في إطار كونه كلاًّ متكاملاً، ولا يمكن تجزئته وإلا اختلت الأمور.
وهو ما فعله أهل الكتاب في السابق، وبالذات بنو إسرائيل.
وفي القرآن الكريم آية شديدة الوضوح في هذا الإطار، يقول الله تعالى في سُورة “البقرة”: {ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)}.
وللأسف الشديد نجد أن بعض من يضعون أنفسهم أسفل راية المشروع الإسلامي يجتزئون، مثل بني إسرائيل، وكأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وما الكفر في صورة من صوره، إلا الترك. فترك بعض تعاليم الدين وأحكام الشريعة وتصورات الإسلام وهم يعلمون، في هذا شيء من الكفر .
ثم إنهم يقتلون أنفسهم. فالمسلم عندنا يقتل مسلمًا بأي زعم باطل، إنما يقتل نفسه؛ لأن المؤمنين إخوة، وأكبر الروابط، هي أواصر الدين.
وبالتالي فإن الاجتزاء من الدين، وتعميم الاستثناء الذي نقضه العلماء الذين أقروه في أوقات بعينها، وقالوا إنه لا يصلح إلا في وقت الاستثناء؛ مثل غزو أو ما شابه؛ إنما هو أحد أسوأ العوائق التي تصدِّر صورة ذهنية سلبية عن الإسلام والمشروع الإسلامي، إلى العالم، وبالتالي فإن صيرورت الدين ذاته تواجه مصاعب جمة.
فعلى سبيل المثال فإن علماءَ ثقاتٍ محدثينَ أبطلوا العمل بثُلُث فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ لأنه وضعها في وقت استثناء، وهو وقت الغزو المغولي.
والمسلمون الآن ليسوا في كل مكان في موضع قتال، بينما مئات الملايين منهم في بلاد غير مسلمة، وبالتالي فالأولى هو البحث في فقه الأقليات المسلمة، وليس الجهاد أو القتال، فهي في النهاية ديار استضعاف، وهكذا.
وبطبيعة الحال فإن هناك الكثير من المشكلات الأخرى، مثل انفلات بعض المفاهيم الشرعية في العمل السياسي، وعدم ضبطها، مثل حدود التعاون مع القوى الأخرى، والأخذ بقوة ضد مفهوم الوطنية والقومية لصالح الأممية الإسلامية، بشكل غير منضبط وفق قوانين العمران، والتي تتفق معها قوانين الشريعة الإسلامية، ولكن هذا سوف يكون في موضع آخر من الحديث.
(المصدر: موقع بصائر)