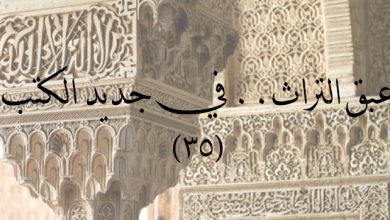“أهل السنة” في لعبة المصطلحات وتديين السياسة!
إعداد معاذ السرّاج
في سياق حديثنا عن “الأقليات” سبق أن ذكرنا أن هذا التعبير حديث العهد ودخيل على ثقافة المنطقة،ابتدعته القوى الدولية المتنفذة منذ أواسط القرن التاسع عشر كذريعة للتدخل في شؤون الدول والمجتمعات باسم حماية الأقليات والمطالبة بحقوقها. وعلى الرغم من الاهتمام الشكلي بهذه المسألة والمكانة التي باتت تحظى بها في الشرعة الدولية من حيث التأصيل القانوني والمتابعة الدبلوماسية والإعلامية الحثيثة، إلا أن الوقائع تؤكد أنها لاتزال تُستخدم إلى اليوم كورقة ضغط سياسية وإعلامية، وأن أثرها محدود جدا في التخفيف من المآسي الإنسانية فضلا عن وضع حد لها، كتلك التي تحيق بشعوب كثيرة كمسلمي الروهينغا، والأيغور الصينيين.
وهذا يقودنا إلى فكرة التوظيف السياسي للمصطلحات واستعمالها في خدمة مصالح الدول والترويج لأفكارها وأيديولوجياتها. ولدينا على سبيل المثال مصطلح “السنة” أو “أهل السنة”، الذي يُروج له في الفترة الأخيرة، في إطار لعبة المصطلحات الطائفية إلى جانب الدروز والعلويين والمسيحيين والشيعة، بعيدًا عن مفهومه الديني وسياقه التاريخي، وفي ظل بيئة طائفية عدائية تعمل جهات عديدة على ترسيخها في المنطقة خلال العقود الأخيرة.
في الحالة السورية كمثال، استخدم مصطلح “السنة” للدلالة على فئات وأفراد متحالفين مع السلطة، يؤيدون سياساتها ويشاركونها فيما ترتكبه من جرائم, بهدف الإيحاء بحرص السلطة على إيجاد نوع من التوازن الاجتماعي والسياسي، الأمر الذي تتداوله كذلك بعض مراكز البحث في ذات السياق، وبذريعة الحيادية والموضوعية.
في هذه المقالة سنحاول إلقاء الضوء على مفهوم أهل السنة, وما أحاط به من إشكالات وخاصة ما يتعلق بالتوظيف السياسي والأيديولوجي.
- مفهوم أهل السنة:
يعرف العلماء “أهل السنة والجماعة” بأنهم “من كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وعبادة وقولًا وعملًا”. ومدار هذا الوصف على اتباع السنة وموافقة ما جاء فيها من الاعتقاد والعبادة والهدي والسلوك والأخلاق، وملازمة جماعة المسلمين. وينطبق هذا التوصيف على أجيال من المسلمين من لدن الصحابة رضي الله عنهم، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم حتى يومنا هذا. وفي مقدمة هؤلاء العلماء والفقهاء والصلحاء الذين اتبعوا منهج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضوان الله عليهم, دون تحريف أو ابتداع، وكلّ من اقتدى بهم من عوام الناس.
من الناحية التاريخية, ظهر مصطلح أهل السنة في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم, وأخذ بالتبلور منذ بداية القرن الثاني من الهجرة, وبالتحديد أيام الدولة العباسية, وفي سياق الرد على محاولة السلطة السياسية, المتمثلة بالخليفة المأمون, التدخل في شؤون الدين والعقيدة, وقسر العلماء والعامة على رأي أو مذهب معين, وكان حينها مذهب المعتزلة. وقد باءت تلك المحاولة بالفشل بعد أن واجهت معارضة شديدة من كبار علماء وفقهاء تلك الفترة, وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل صاحب المحنة الشهيرة, والذين تحملوا في سبيل ذلك الكثير من الأذى والسجن والتعذيب كما هو معلوم.
ينبغي أن نذكر هنا أن رفض العلماء لمحاولة الخليفة المأمون تلك, لا يتعلق بالجانب العلمي وحده, وإنما كان أيضا رعايةً لاستقلالية الشريعة وعلمائها وفقهائها, ومنع السلطة السياسية من التدخل في شؤونها وفرض آرائها عليها. وقد ساهم ثبات العلماء والفقهاء على مواقفهم, في ترسيخ هذا المبدأ طيلة القرون التالية. ويعبر عنه في وقتنا الراهن بمرجعية الشريعة واستقلالها وسيادتها. وقد أشار إلى هذا المعنى كثير من أساتذة القانون والمؤرخين أمثال الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه “تطور نظام الخلافة”, والدكتور فاروق عمر فوزي في كتابه “تاريخ النظام الإسلامية”, وغيرهم.
وبمرور الزمن استقر مصطلح أهل السنة على المفهوم الذي أشرنا إليه, وتوسع نفوذه المعنوي ليصبح مبدأ شاملا ويغطي أكثر بلاد العالم الإسلامي, مواكبا لحركة انتشار الإسلام وانفتاحه على الأقوام والملل والحضارات المختلفة, واستيعابه لثقافات الشعوب التي انضوت تحت رايته وفي ظل شريعته.
من الناحية السياسية، وفي ظل منهج أهل السنة كانت أقوام كثيرة وفي شتى بقاع العالم الإسلامي تتداول على الملك والخلافة والإمارة، بما فيها بلاد العرب، ونبغت من هذه الأقوام شخصيات لا تُحصى في العلم والفقه والأدب واللغة وغيرها. والمسلمون على مر العصور، يدينون بالفضل والاحترام والولاء، لشخصيات تاريخية كثيرة من العرب والبربر والفرس والترك والكرد والصقالبة والمغول وغيرهم، تركت آثارًا محمودة في العلم والسياسة والحروب وما إلى ذلك.
كما أن الحضارة والمدنية التي تكونت في ظل العالم السني، إذا جاز التعبير، حفظت لكل من ساهم فيها مكانته ودوره، دون أن تستثني أحدا لدين أو مذهب أو عرق، ونقلت نتاج هؤلاء كلهم كما هو ودون تغيير أو إغفال أو تجاهل، حتى أولئك الذي عُرفوا بالزندقة والخلاعة والمجون، تاركة الحكم في النهاية للتاريخ وللأجيال.
من هذه المنطلقات كلها يصح أن يُقال إن العالم السني اكتسب سمة حضارية شاملة مكنته من استيعاب هذا التنوع الفريد والتعامل معه بالأريحية والمرونة المطلوبة، مع محافظته الصارمة على نقاء العقيدة وصفائها ورسوخها وثباتها.
ولعل هذا يفسر إلى حد كبير فشل المحاولات الرامية إلى اختزال مفهوم أهل السنة، واستدراجه إلى حلبة الجدالات الطائفية والمذهبية،واستخدامه في لعبة المصطلحات والتحايل على المفاهيم والأفكار.
– أسطورة البناء الوطني:
هذا التعبير استعمله ميشيل سورا في تحليله لأسلوب السلطة ومنهجها في توظيف الشعارات الوطنية والقومية. وفي إطار هذه المنهجية رأى سورا أن إنكار الطائفية وتجريم الحديث عنها، لا يقتصر على خطاب السلطة وحدها، بل يُعتبر في مقدمة خطاب الطبقة السياسية السورية كلها وبجميع اتجاهاتها. وأن إنكار الطائفية لا يتأتّى من وجهة نظر الأخلاق السياسية وحسب, وإنما من وجهة نظر الواقع الاجتماعي كذلك. والسبب في ذلك أن نموذج “البناء الوطني” و”التحديث” الذي بدأ منذ القرن التاسع عشر، يضع تخلي الجميع عن انتماءاتهم الطائفية شرطًا لوحدة الكل، ومساواتهم داخل المجتمع المدني. وفي هذه الحالة وبينما تعمل الطائفة الدينية لدى الأقليات دائما عمل الحزب السياسي كأداة للاستيلاء على السلطة, فإن الأكثرية هي الخاسرة دومًا في لعبة البناء الوطني هذه، لأنه يتوجب عليها أن تقدم نفسها على أنها لا تحتوي على عصبية دينية أو قومية أو ما شابه.
ويعمل الخطاب الوطني في هذه الحالة على حجب الحيز الاجتماعي واستبعاد منظومة القيم والأخلاقي والأعراف التي يرتكز عليها، والاستعاضة عنها بمنظومة بديلة بقيمها ومصطلحاتها وتعابيرها. إلا أن هذه المنظومة البديلة لاتزال تثبت عجزها باستمرار عن ملء الفراغ الذي أحدثته تلك السياسات. وفي تحليله لهذا الفشل والعجز، يرى د. برهان غليون “أن الثقافة عندما تتحول إلى قضية قومية فإنها لا تهدد فقط الاستقرار السياسي القائم على نكران متبادل للذاتية، ولكنها تهدد أكثر من ذلك وجود الجماعة ذاته كمجتمع سياسي موحد وقومي. وأن الوحدة هنا تبقى شكلية مادامت تقوم على اتفاق باطل مضمونه تخلي الجماعة عن كل هوية قومية تجاه الجماعات القومية الخارجية الأخرى، الأمر الذي يعني في العصر الراهن الاستلاب للغرب وتقديس ثقافته”.
وفي سياق هذا التحليل, يستحضر الباحث ميشيل سورا المحاولة التي قام نابليون بونابرت بعد احتلاله لمصر في الأول من تموز 1798، للترويج لمبادئ الثورة الفرنسية في الحرية والمساواة، وصياغة “مفردات بارعة لجأ إليها المستشرقون كي يترجموا إلى اللغة العربية مثل تلك المفاهيم الغريبة كلية عن الإطار الثقافي للبلاد”. يقول ميشيل سورا: “وبعد ذلك الحدث بقرنين من الزمان لا تزال المفردات في اللغة العربية تعاني من عدم الدقة فيما يتعلق بمفهوم الأمة، (فهل نقول الوطن، أم الأمة، أم القومية) بشكل محير، بينما مجال النظام السياسي “التقليدي” القائم على روابط الدم والولاء والتحالفات والجيرة… إلخ “مغطى” لغويا تغطية محكمة، ومفرداته وافرة لم تتقادم بمرور الوقت، كما لايزال لنظريات مثل نظرية ابن خلدون أو نظيره ابن الأزرق مدٌّ في العصر الحديث، مما يدفع للتفكر مليا في واقع السياسة في الشرق العربي المعاصر”. انتهى كلام سورا
وفي هذه النقطة أيضًا؛ ينبغي الإشارة إلى العلمانية العربية والتيارات الحداثية كفاعل رئيسي في ترويج مثل هذه السياسات ومحاولة تقويض القيم الاجتماعية والمفاهيم الثقافية وتعريض هوية المجتمع للفوضى والضياع. وهي بهذا الفعل تُسدي خدمة جليلة للاستبداد العصري، وللأنظمة السياسية المهيمنة على المنطقة، بحسب رأي د. برهان غليون.
وتكمن أهمية هذا التحليل في أنه يلقي الضوء أيضا على العوامل المؤثرة فعليًا في صياغة تاريخنا المعاصر، ويساعد على تشخيص الفروق الجوهرية بين البدائل الفاشلة التي مررنا عليها، ومنهج الإسلام وقواعده الشرعية والأخلاقية في تكوين المجتمعات وبث روح التفاهم والتعايش فيما بينها. ويرى ميشيل سورا أن هذا التحليل “صحيح وحق”، من وجهة النظر النقدية، وأنه “أدق بكثير من التحليلات الأخرى التي تتبنى المناهج الغربية”.
وفي الاتجاه ذاته يقول د. برهان غليون: “إن الأديان بفضل ما تنطوي عليه من مفهوم شمولي للإنسانية أي من تقديس للإنسان كإنسان دون النظر إلى أصله ونوعه مازالت تشكل حتى الآن المرجع الاحتياطي الاستراتيجي للنزعة الإنسانية والأخلاقية”. – الإسلام وأزمة علاقات السلطة الاجتماعية – ورقة مقدمة لكتاب “الدين في المجتمع العربي” – 1990.
– خداع التكتلات السنة:
كثيرا ما يُقال عن السياسيين والعسكريين الذين يعملون مع السلطة إنهم أيضا من “السنة”, في إشارة إلى التوازنات الطائفية والسياسية حتى لو كانت شكلية, وذلك على الرغم من القناعة السائدة بأن أيا من هؤلاء لا يملك نفوذا حقيقيا مهما بلغت رتبته, وسواء كان ضابطا أو وزيرا أو عضو برلمان أو غير ذلك, بل إن هؤلاء كثيرا ما يُنظر إليهم باستخفاف وازدراء ولا يُقام لهم أي وزن أو اعتبار.
وبصرف النظر عن الجانب الشخصي في هذه المسألة, إلا أنها وفي كل الأحوال تثير تساؤلات عديدة حول ما تعنيه كلمة “السنة” أو “أهل السنة” بالنسبة لهؤلاء أو لمن يُطلق عليهم هذه الصفة؟ خاصة وأن الذين يعملون مع السلطة بعيدون كل البعد عن الدين واعتباراته القيمية والأخلاقية، وأكثرهم يُكنّون عداء صريحًا للدين ولا يرونه صالحًا لأن يكون له أي دور في الدولة والمجتمع.
في كتابه “الدولة المتوحشة” ناقش ميشيل سورا هذا الموضوع، وجزم بأن هناك خداعًا وتلاعبًا بالألفاظ والمفردات على حساب المبادئ والقيم الاجتماعية. وساق على ذلك عددًا من الأمثلة، من بينها ما حدث عند تشكيل اللجنة المركزية لحزب البعث في بداية عام 1980، والذي تم بإشراف رفعت أسد وإدارة المخابرات، إذ استحوذ العلويون على 30 مقعدًا من أصل 75،وشغل قسمًا كبيرًا من مقاعد العلويين ضباط يقودون فرقًا عسكرية وميليشيات طائفية وأجهزة مخابرات ،ومن بينهم على سبيل المثال رفعت أسد قائد سرايا الدفاع، وعلى رأسهم أيضًا حافظ أسد قائد الجيش والحزب ورئيس السلطة.
وتساءل ميشيل سورا عن جدوى وجود شخصيات محسوبة على السنة أمثال زهير مشارقة وجابر بجبوج ومصطفى طلاس ومحمود الأيوبي وحكمت الشهابي وغيرهم, وسط هذه التركيبة الطائفية التي تمسك بزمام السلطة وتستحوذ على كل شيء، خاصة وأن الضابط “السني” مهما علت رتبته، والكلام لسورا، فهو يخضع لضابط علوي أقل منه ربما بدرجات كما هو معروف لدى جميع السوريين. وإذا كان حافظ أسد كان يولي ثقته فقط للضباط العلويين المقربين منه أمثال: علي دوبا وعلي أصلان وعلي الصالح وعلي حيدر وعلي المدني، و شفيق فياض وعزت جديد وحكمت ابراهيم، إلى جانب أشقائه وأقربائه مثل رفعت أسد ومحمد مخلوف ومحمد ناصيف وغيرهم، فما الذي يعنيه وجود مصطفى طلاس أو يوسف شكور أو ناجي جميل أو حكمت الشهابي في مناصب أصبحت شكلية بمعنى الكلمة حتى لو كانت وزارة الدفاع أو رئاسة الأركان أو غيرها.
يعزو بعض المراقبين لأوضاع سورية بقاء أصحاب المناصب كالمذكورين آنفًا، إلى كونه مكافأة لهم على ولائهم المطلق لحافظ أسد، ولقاء وشاياتهم بزملائهم من الضباط الذين حاولوا الانقلاب على حافظ أسد وقادوا تحركات عسكرية ضده.
بقي أن نشير إلى مفارقة أخرى في مسألة المصطلحات، وهي ما حدث من استهداف واسع النطاق لأعداد هائلة من السوريين تحت مسمى “السنة”،سواء في الثورة السورية الراهنة، أو في تلك التي حدثت أيام الثمانينات من القرن الماضي، حيث كان الأهالي الأبرياء يُقتلون ويُذبحون ويُشردون ويُنَكّلُ بهم, لا لشيء إلا لأنهم من “السنة”، ولا فرق أن يكون بينهم بعثيون وعسكريون يخدمون في الجيش، وموظفون لدى السلطة، لأن الاعتبار الأول في هذه الحالة كونهم “سنيون” وحسب.
وللاستزادة حول هذا الموضوع يمكن العودة إلى كتاب “استهداف أهل السنة” للدكتور نبيل خليفة، وكتاب “أفول أهل السنة: التهجير الطائفي وميليشيات الموت وحياة المنفى بعد الغزو الأمريكي للعراق” لـ ديبورا آموس
- خاتمة في تديين المصطلحات:
يدرج بعض الباحثين توظيف مصطلح “السنة” في سياق ما يمكن تسميته “تديين” السياسة، الذي دأبت السلطات المستبدة باللجوء إليه في مواجهة خصومها والمعارضين لسياستها، ولاسيما الإسلاميين، فتصفهم ب”بالعملاء” تارة، و”الرجعيين”، و”المنحرفين”، و”المتخلفين” وهكذا.. وتشن الحملات السياسية والإعلامية والفكرية، التي تنتقص من مرجعيتهم الدينية وآرائهم وحتى أشخاصهم.
وبمقابل ذلك تُبيح السلطة لنفسها، أن تنفرد بالتكوين الفكري والأخلاقي للأجيال الصاعدة، يشاركها في ذلك حلفاؤها من الحداثيين واليساريين، الذين احتكر مفكروهم وكُتّابهم ثقافة السورييين وانفردوا بوضع المناهج الدراسية والتربوية والثقافية،التي فُرضت بقوة السلطة،على مختلف المراحل بدءا مما سمي بالطلائع وحتى المدارس والجامعات. ولم ينس هؤلاء أن يسخروا الدستور لتحقيق غاياتهم, كما فعل واضعوا دستور عام 1973، حين خوّلوا السلطة وحلفاءها بنص الدستور مهمة إنشاء “جيل ثوري” على مبادئ البعث وأفكاره وأخلاقياته، وجعلوا منه قائدًا للمجتمع والدولة. وصل بهم الأمر إلى إطلاق يد حافظ أسد في كل شيء، وتلقين الناشئة تقديسه وعبادته.
في تحليله لهذه المنهجية؛ يرى د. غليون أن ما تفعله السلطة هو بمثابة “تديين لسياستها”، وجعل أفكارها في موضع البديل الكامل للدين والشريعة، ويدخل في ذلك إسباغها رمزية وقداسة خاصة على شخص حافظ أسد بما يجاوز مقامات الرسل والأنبياء، وبما يضاهي صفات الألوهية، دون مواربة ولا مجاملة، والوقائع والشعارات الكثيرة التي أطلقها مؤيدو حافظ أسد وابنه بشار تؤكد هذا المنحى، الذي بات معروفًا لدى السوريين، ولا تخفى مشاهد الموالين وهم يسجدون لرئيسهم ويرفعون الحذاء العسكري على رؤوسهم، كما لا تخفى أيضًا صور المعتقلين والمعارضين وهم يُرغمون على السجود لصور حافظ وبشار، وترديد العبارات التي تقدسه وتبجله وترفعه إلى مقام الربوبية.
وإذا ما انتقلنا من هذا المشهد إلى مشهد آخر يتمثل بانتقاص الدين والتهجم على مبادئه وتاريخه ورموزه وشعائره، وعلى نحو غير لائق في كثير من الأحيان, فإن جوانب المفارقة في هذه السياسات ستتضح أكثر فأكثر، وسنجد أنفسنا في نهاية المطاف أمام محاولات جادة وصارمة لإحلال دين مكان دين، وشرعة مكان شرعة، وثقافة مكان ثقافة، وتربية مكان تربية. وأن ما يجري الترويج له من أفكار وشعارات وتعابير ومصطلحات, بما في ذلك الشعارات الوطنية والقومية ومفردات الحرية والوحدة وما إلى ذلك، لا يعدو أن يكون وسيلة في هذا المسعى، وغطاء زائفا لتمرير تلك الأفكار والمعتقدات.
وفي ضوء ما سبق؛ يمكن فهم وتفسير حالة الفوضى والفراغ التي يعيشها السوريون، منذ اندلاع ثورة 2011، وبعد أن انهارت جدر الأوهام والمغالطات التي تراكمت في أذهان جيلين أو ثلاثة أجيال من السوريين، بفضل فكر مزعوم وثقافة ملفقة، زُرعت في أذهان الناس وحُشيت في عقولهم بسطوة أجهزة الرعب وفرق الموت التي هيمنت على السوريين طيلة ستة عقود. وسيحتاج الأمر لجهود كثيرة مخلصة، وزمن غير قليل قبل أن يستعيد الناس وعيهم السليم وتوازنهم الثقافي والمعرفي والأخلاقي, ويسدوا هذا الفراغ القاتل.
(المصدر: رسالة بوست)