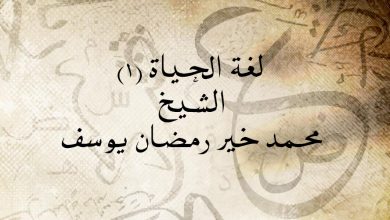أصول حُكم الشُّعوب المسلمة ومقاييس تطبيق العدالة 3من 9
إعداد د. محمد عبد المحسن مصطفى عبد الرحمن
مصدر الشَّرعيَّة في فترات الحُكم السَّابقة على المُلك الجبري
يشرح الأمير تطوُّر مفهوم الحاكم المتغلِّب، منذ بدايَّة عصر الخلافة، بعد أن لقي نبيُّنا الكريم (ﷺ) ربَّه عام 632م، وحتَّى نهايَّة حُكم الدَّولة العثمانيَّة، رسميًّا عام 1924م، وفعليًّا عام 1909م، بعد خلْع السُّلطان عبد الحميد الثَّاني. لم يكن الحاكم المتغلِّب طوال تلك الفترة متغلِّبًا إلَّا على خصومه ومنافسيه على الاستئثار بالسُّلطة، وليس على الشَّعب الأعزل. لم يترفَّع حاكم طوال تلك القرون الطَّويلة عن الاستناد إلى شريعة الله تعالى المنظِّمة لشؤون عباده، على عكس ما حدث في زمن سيطرة عبدة الشَّيطان على العالم، وفق خطَّة مفصَّلة لإغواء عباد الله ونشر الكُفر في صورة التحرر من ربقة الدِّين وفصله عن شؤون الحياة البشريَّة. ويوضح الأمير بالبراهين أنَّ مفهوم التغلُّب بالسَّيف لم يكن إلَّا على أساس إزاحة حاكم وحلول آخر محلَّه، مستشهدًا على ذلك بقول الفقيه الحنفي ابن عابدين الدَّمشقي، الَّذي عاش في القرن الثَّامن عشر، أي في آخر قرون المُلك العاض، كما ورد في كتاب رد المحتار على الدُّر المختار تنويرًا للأبصار (جـ6، صـ414)، “إذا تغلَّب آخر على المتغلب وقعد مكانه، انعزل الأول وصار الثَّاني إمامًا، وتجب طاعة الإمام عادلًا كان أو جائرًا إذا لم يخالف الشَّرع…وقد يكون إمامًا بالتغلب مـع المبايعة، وهو الواقع في سلاطين الزمان نصرهم الرحمن”.
يثير الأمير مسألة في غايَّة الحساسيَّة، وهي حصر الإمامة في رجل من قريس، من نسل النَّبي(ﷺ) أو من الأقربين من أهله. طُرحت هذه المسألة باستفاضة في استعراض أهم محتوى كتاب تطوُّر الفكر السِّياسي الشِّيعي (1998م) لأحمد الكاتب، وثبت عدم وجود نصٍّ صريح من الكتاب والسُّنَّة النَّبوية يأمر بأن يكون خليفة النَّبي من بني هاشم، وتحديدًا من نسله، وأنَّ بني العبَّاس استخدموا مسألة أولويَّة نسل عليٍّ بن أبي طالب (كرَّم الله وجهه) في حربهم ضدَّ الأمويين، وأنَّهم سرعان ما انسلخوا عن وعدهم بمبايعة أحد المنحدرين من نسل عليٍّ، وأنَّ أبا العبَّاس السفَّاح قد تبرَّأ من جماعة عبد الله بن سبأ، وعمَّا زعمته عن أحقيَّة تولِّي أحد أبناء عليٍّ الخلافة. بويع أبو العبَّاس عام 132ه في الكوفة، وكانت الحجَّة على أحقيّته بني العبَّاس في الإمامة مستمدَّة من قول الله تعالى ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [سورة الأنفال: 75]. ما ثبت من خلال الدِّراسة هو أنَّ الانتماء إلى قريش كان أيديولوجيَّة سُيِّرت بها الجماهير للإقرار لبني العبَّاس بالبيعة، وقد حَكَم هؤلاء في البدايَّة وفق الشَّريعة المنزَّلة من السماء، ولم يُعرف عنهم الانحراف إلَّا في أواخر حُكهم. ما أراد الأمير قوله هو أنَّ الحاكم المتغلِّب في مختلف أمصار دولة الخلافة كان خاضعًا بدوره لمتغلِّب آخر، هو خليفة المسلمين، المنحدر من قريش، والحاكم وفق صحيح الدِّين.
يضرب الأمير المثل في ذلك بحرص صلاح الدِّين الأيُّوبي، على الإقرار بطاعته تجاه الخليفة العبَّاسي، المستضيء بالله، برغم تمزُّق الدَّولة في عهده على يد الصليبيين؛ لأنَّ صلاح الدِّين كان يعلم أنَّ “ولايته لن تكون شرعيَّة ولا مقبولة، إلَّا إذا أقرَّها الخليفة” (صـ55). ويضيف الباحث التَّاريخي المجتهد مثالًا آخر يوضح مدى حرْص الحاكمين وفق شريعة الله تعالى على اكتساب الشَّرعيَّة من مصدرها البشري، وهو خليفة المسلمين، الجامع لأمرهم تحت لواء دولة مسلمة موحَّدة، وهو بحث الظَّاهر بيبرس عن الأحق بالخلافة من بني العبَّاس لمنحه الشَّرعيَّة في حُكمه مصرَ، والمفارقة أنَّ يتم ذلك بعد مبايعة حفيد العبَّاس، عم النَّبي الكريم، خليفةً أوَّلًا، وذلك عام 1261م، وتحديدًا في شهر رجب من العام 659ه، أي في سادس قرون الدَّولة العبَّاسيَّة. يرجع ذلك إلى خلو كرسي الخلافة في بغداد، بعد أن هاجمها المغول وقتلوا الخليفة المستعصم بالله، وما كان من الظَّاهر بيبرس، الشريك الأكبر في هزيمة المغول، إلَّا أن استجلب أحقَّ أمراء بني العبَّاس بالخلافة، وهو الأمير أحمد بن الظَّاهر، ليبايعه؛ فأصبح الخليفة المستنصر بالله، وفق ما يروي الأمير، نقلًا عن المؤرخ ابن تغري الأتابكي في كتابه النجوم الزَّاهرة في ملوك مصر والقاهرة (جـ7، صـ113). كان بيبرس متغلِّبًا عندما أقدم على قتل السُّلطان قطز، بسبب المنافسة على السُّلطة. غير أنَّه بعد أن ورث مُلكه، لم يُعرف عنه إنكاره للشريعة، أو خروجه عن رأي فقهاء الإسلام، وفي ذلك يشير الأمير إلى قصَّة رواها الإمام السيوطي في كتاب حُسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (جـ2، صــ95)، عن مواجهة الشَّيخ محيي الدِّين النَّووي في الشام لبيبرس باتِّباعه الهوى في الحُكم، وسماعه لفقهاء السُّوء ممَّن زيَّنوا له عمله، وما كان من بيبرس إلَّا أن التزم بفتاوى الشَّيخ العزِّ بن عبد السَّلام، دون أن يسعى للخروج عن أمره. ومن ذلك يستنتج الأمير ما يلي (صـ58):
فوليُّ الأمر المتغلِّب هو المتغلِّب على مَن في طبقته من الخصوم والمنافسين وأصحاب الشَّوكة، وليس المتغلِّب على الأمَّة ويفعل بها وفيها ما يشاء دون قيد ولا شرط، كما يَفْهم أصحاب العقول السَّقيمة من حَفَظة الأكلشيهات، وتغلُّبه يعطيه شرعيَّة ولاية الأمر وطاعة الرِّضا والقبول داخل الشَّرعيَّة العامَّة وليس خارجها.
ويقارن الأمير بين موقف الحاكم المتغلِّب الظَّاهر بيبرس وموقف حُكام المُلك الجبري المتغلِّبين من الشَّرعيَّة (صـ60-61):
أمَّا الآتون من الخلْف فأوَّل شيء يفعلونه بعد أن يصلوا إلى السُّلطة هو توظيف دولتهم وإعلامهم في تذويب العقائد والإطاحة بالشَّرائع، ويحرَّشون بالعلماء، ويطلقون الفسَقة والزَّنادقة والمنحلِّين ويبسطون الحمايَّة عليهم، ويتواطؤون مع أعداء الأمَّة عليها، ويواكب ذلك إعلانهم الدُّخول في طاعة الغرب، وطلَب رضاه واعتراف منظَّماته، وتلفيق دستور مستمَدٍّ من قيمه وقوانينه، وتصعيد مَن يستلهمونه ويدورون حوله.
مصدر شرعيَّة الحاكم المتغلِّب في المُلك الجبري
يفترض الأمير أنَّ الصِّراع الجدلي المتفجِّر، في وسائل الإعلام المرئيَّة، بين مؤيِّدي عزل محمَّد مرسي في 3 يوليو من عام 2013م، ممَّن يسمَّون ذلك ثورة، ومعارضي العزل، ممَّن يعتبرون أنفسهم المدافعين عن الشَّرعيَّة ويسمَّون الإطاحة بمرسي انقلابًا، هو محاولة من مؤيدي العزل لإرضاء الغرب الَّذي لا يعترف بالانقلابات العسكريَّة، يسعى معارضوه لإحباطها؛ لمعرفتهم بهذه الحقيقة. غير أنَّ هناك تفسيرًا آخر يبدو منطقيًّا، وأقرب إلى تفكير اليهود، وهو تقسيم النَّاس إلى فريقين متناحرين، فيلتهون بذلك عن عدوِّهم الأصلي، الَّذي ينتفع من هذه الحرب الكلاميَّة بطريقة أخرى، وهي تهيئة الأوضاع لحرب يفتت بها المنطقة، يسوِّق فيها أهم منتجات الحداثة الغربيَّة، السِّلاح التدميري بكافَّة أنواعه. عودةً إلى ما يثيره الباحث عن استمداد الحاكم المتغلِّب في ظلِّ المُلك الجبري للشرعيَّة من مصدر خارجي، هو أعداء الإسلام، يشير الواقع المرير الَّذي نعيشه هذه الآونة، إلى أنَّ مساعي تمزيق كافَّة الروابط العقائديَّة لأمة خير البريَّة وصلت إلى ثوابت الدِّين، وتصفيَّة القضيَّة الفلسطينيَّة، وما يتبع ذلك من تنازُل عن المسجد الأقصى، لبناء ما يُسمَّى ‘‘هيكل سليمان’’. تذكيرًا بما سبق شرح بالتفصيل في دراسة سابقة، فإنَّ هذا الهيكل، الواردة مواصفاته في سفر الملوك الأوَّل، لا يُنسب أبدًا لنبيِّ الله سليمان، وفق ما أخبرنا القرآن الكريم عن سيرته؛ باختصار لأنَّه كان هيكلًا لعبادة الثُّنائي الإلهي البابلي، الرامز لإله النُّور، لتقل لوسيفر، أو بمعنى أوضح، إبليس.
يثير الأمير مسألة أخرى في السياق ذاته، تتعلَّق بحدود سُلطة الحاكم المتغلِّب، وهو يقصد بذلك تدخُّله في تشكيل الوعي الجماعي وغرس فِكر يخدم مشاريع غير معلنة، هدفها تدمير الإسلام لإفساح المجال لعبادة إله التَّنوير. يضرب الأمير المثل في ذلك بقصَّة عن الإمام العزِّ بن عبد السَّلام، في زمن السُّلطان الصَّالح نَجم الدِّين أيُّوب، لمَّا أوقف الشَّيخ السُّلطان وهو يسير في موكبه يوم العيد، لينكر عليه إباحته بيع الخمور في مصر. يقول نصُّ القصَّة الوارد في كتاب طبقات الشَّافيَّة الكبرى (جـ8، صــ211-212) ” التفـت الشَّيخ إلـى السُّلطان ونـاداه: يا أيُّوب، مـا حُجَّتـك عنـد الله إذا قـال لـك: ألـم أُبَـوِّئ لـك ملـك مصـر ثـم تُبيح الخمـور؟ فقـال السُّلطان: هـل جـرى ذلـك؟ فقال: نعم، الحانـة الفلانيَّة تُبـاع فيها الخمـور وغيرها مـن المنكـرات وأنـت تتقلـب فـي نعمة هذه المملكـة…”، وما كان من الصَّالح أيُّوب إلَّا أن أمر بإغلاق الحانة. ويتساءل الأمير في تعجُّب عن موقف ولي الأمير المتغلِّب في زمن المُلك الجبري، الَّذي أصبح نشْر المنكرات فيه لزامًا لإعداد العالم لعبادة إله النُّور، إذا أوقف لسبب مثل هذا وهو “فـي زينته فـي عـرض عسـكري وسـط قـادة جيشه وجنــوده” (صـ70).
التَّحالف مع الغرب ضدَّ دولة الإسلام في تاريخ المُلك العاضِّ ونتائجه
ينقلنا الدُّكتور بهاء الأمير بعد ذلك إلى استعراض نموذج من تاريخ مصر، زمن الدَّولة العثمانيَّة، عن موالاة القوى الغربيَّة، المعادية للإسلام، لضرب الدَّولة الجامعة لصفوف المسلمين في ظهرها، وفصل مصرَ عنها، وهو لاستيلاء عليِّ بك الكبير على الحُكم في مصرَ من الوالي العثماني. كان عليُّ بك الكبير سنجق القاهرة، ما يوازي شيخ البلد، في زمن المماليك، وقد سوَّلت له نفسه أن يتعدَّى على شرعيَّة الوالي المعيَّن من قِبل السُّلطان العثماني، أثناء انشغال الأخير في حربه مع روسيا، عام 1768م. ويبدو أنَّ الغرب كان يخطط آنذاك لتحرف العالم الإسلامي عن عقيدته، لإحكام السَّيطرة عليه، كما فعل لاحقًا، وكان تمزيق الدَّولة العثمانيَّة شرطًا أساسيًّا لذلك. تلقَّى عليُّ بك الكبير دعمًا من الأسطول الرُّوسي في البحر المتوسِّط، لمواجهة السَّخط العثماني وإعلانه وزمرته خارجين على الدَّولة. المفارقة أنَّ عليَّ بك قد أُزيح عن الحُكم بنفس طريقة وصوله إليه، وعلى يد معاونه وصهره، الَّذي أعاد ولاية مصر للدَّولة العثمانيَّة. بذلك، يُعتبر عليُّ بك الكبير “أوَّل مــن وضــع فــي مصــر جرثومــة مــوالاة الغــرب والــدخول فــي طاعتـه، فـي غـلاف اسـتقلالها عـن الدَّولة العثمانيَّة” (صـ73).
يثبت الأمير في دراسته أنَّ عليَّ بك الكبير تربَّى في كَنَف اليهود في الإسكندريَّة، قبل أن ينضم إلى مماليك أحد الأمراء. نقلًا عن كتاب Travels in Syria and Egypt، أو رحلاتفي مصر وسوريا، للمستشرق الفرنسي الكونت دي فولني، فعليُّ بك الكبير هو في الأصل من جورجيا، الواقعة شرق الدَّولة العثمانيَّة، والمتاخمة لروسيا القيصريَّة، واسمه الحقيقي جوزيف ديفيد، وقد أتى به إلى مصر، وهو دون العاشرة من عمره، تاجر من الإسكندريَّة، باعه لاحقًا لاثنين من التجَّار اليهود، وهم اللذان باعاه إلى أمير مملوكي. جدير بالذكر أنَّ جورجيا خضعت لحُكم روسيا القيصريَّة، حاضنة الكنيسة الأرثوذكسيَّة بعد دخول القسطنطينيَّة عباءة الإسلام عام 1453م، أواخر القرن الثَّامن عشر، تزامنًا مع بدايَّة حربها مع الدَّولة العثمانيَّة، الَّتي استغلَّها عليُّ بك الكبير للسيطرة على مصر. لم يكن فشل هذه التَّجربة ليُشعر القوَّة الخفيَّة باليأس من تأسيس دولة المخلِّص العالميَّة، فأعادوا محاولة إخضاع العالم الإسلامي لسُلطان الغرب من خلال الحملة الفرنسيَّة مصرَ والشَّام، كما سبقت الإشارة بالتفصيل في الدِّراسة السَّابقة. من هنا، كان البديل الأنسب هو زرع عميل للغرب، صـحيح هو في الأصل الوالي العثماني، إنَّما سياسته هي تنفيذ لمخطط القوَّة الخفيَّة لإفساد المسلمين وتحريفهم عن صحيح دينهم، ووقع الاختيار على محمَّد عليِّ باشا، ألباني الأصل، الَّذي وُلد ونشأ في مدينة سالونيك، أهم معقل ليهود الدونمة بعد إزمير.
المصدر: رسالة بوست