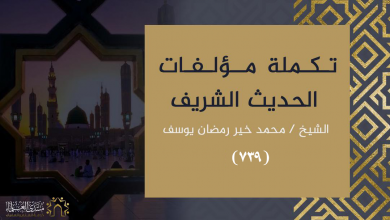شبهات تتجدد حول تحريم فوائد البنوك
بقلم د. عطية عدلان
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ..
من جديد تعود دار الإفتاء لفتح ملف فوائد البنوك؛ لتؤكد على ما سبق أن قررته دار الإفتاء في عهد سيد طنطاوي ثم في عهد علي جمعة، ولكونها لم تأت بجديد سوى التكرار لما أشاعته دار الإفتاء سابقا من شبهات حول فوائد البنوك؛ فقد قررت أن أتجاهل كلام شوقي علام ومن حوله من المفتين، وأقوم بالرد على جميع الشبهات التي أثيرت سواء منها ما ذكره هؤلاء أو ما لم يذكروه.
وأودّ في البداية أن أنوه سريعا إلى أنّ القول بتحريم فوائد البنوك هو قول المجامع الفقهية كافّة، بما فيها مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، الذي أصدر في مؤتمره الثاني بالقاهرة شهر المحرم 1385هـ الموافق مايو 1965م، قرارا بشأن المعاملات المصرفية، جاء فيه ما يلي:
1- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة على تحريم النوعين.
2- كثير الربا وقليلة حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران 130).
3- الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرر، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
4- أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل: كل هذا من المعاملات المصرفية جائزة, وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.
5- الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة, وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة”([1]).
كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 16:10 ربيع الثاني 1406هـ ، وجاء فيه ما يلي:
أولاً: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد:هاتان الصورتان ربا محرم شرعياً.
ثانياً: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هي التعامل وفقاً للأحكام الشرعية -ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي.
ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطى حاجة المسلمين، كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعة ومقتضيات عقيدته”([2]).
وكذلك صدر قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406هـ إلى يوم السبت 16 رجب 1406هـ. وجاء فيه ما يلي:
أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهي الله عنه من التعامل بالربا أخذاً أو اعطاءاً والمعاونة عليه بأي صورة من الصور, حتى لا يحل بهم عذاب الله, ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله.
ثانياً: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعنى بالمصارف الإسلامية: كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويلزم إدارته وجوب وجود رقابة شرعية ملزمة، ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها, وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها وتشويه صورتها بغير حق. ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام, وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره, حتى تتكون من هذه المصارف شكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل.
ثالثاً: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج,إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البدل الإسلامي ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب, ويستغني بالحلال عن الحرام.
رابعا: يدعو المجلس المسئولين في البلاد الإسلامية, والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا؛ استجابة لنداء ربـهم في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة 278)؛ وبذلك يسهمون في تحرير مجتمعاتنا من أثار الاستعمار القانونية والاقتصادية.
خامسا: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً, لا يجوز أن ينتفع به المسلم -مودع المال- لنفسه، أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شئونه. ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين, من مدارس ومستشفيات وغيرها. وليس هذا من باب الصدقة, وإنما هو من باب تطهير المال.
ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية لتقوى بها, ويزداد الآثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج, فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية, وبهذا تعدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين, وإضلال أبنائهم في عقيدتهم علناً بأنه لا يجوز أن يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة.
كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر المسلمة الصالحة وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه حتى تكون معاملتهم وتصرفاتهم موافقة لها. والله ولى التوفيق, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العاملين”([3]).
وجاء في توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية بالكويت”
1- يؤكد المؤتمر أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو من الربا المحرم شرعاً”([4])
الشبهات المثارة وجوابها
بعد اتفاق المجامع الفقهية الكبرى في العالم الأسلامى على تحريم فوائد البنوك الربوية, ما كان ينبـغى لأحـد أن يشغب على هذا الحـكم, ولا أن يثير حوله الشبهات؛ لأن الحرمة واضحة, والقرارات جاءت بناءً على اجتهاد جماعى يشبه الإجماع. إلا أن الفتنة أبت إلا أن تطل برأسها لتنفث الدخان الذي يحجب الحقائق الراسية. فأثيرت الشبهات من جديد ووجدنا أقلاماً وأبواقاً تحاول التبرير لهذه البنوك الربوية، واختلفت التبريرات, وتباينت الشبهات, ووصلت من الاختلاف والتباين إلى حد التناقض الذي يدل على فسادها جميعاً ويغنى عن الرد عليها. ولكننا -إتماماً للبيان- سنرد عليها بإذن الله تعالى شبهة شبهة, بحسب الإمكان, والله المستعان.
الشبهة الأولى: أن الربا مُبهم قد اختلف الفقهاء في تحديده, وهذا الإبهام في معنى الربا يجعلنا نتردد عند الحكم على فوائد البنوك بأنها من الربا الحرام، قال فضيلة الشيخ طنطاوى: “والخلاصة أن المتتبع لأقوال العلماء يراهم قد اعترفوا بأن مسألة تحديد الربا المحرم شرعاً تُعَدُّ من أعقد المسائل ومن أكثرها اختلافاً بين الفقهاء”([5])، واستدل على ذلك ببعض الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب كقوله: “ثلاثة وددت لو أن رسول الله عهد إلينا فيهن عهداً: الجدة والكلالة وأبواب من أبواب الربا”.
وجواب هذه الشبهة أن الأبواب التي تمنى عمر أن لو كان الرسول عهد إليهم فيها عهداً، والتي اختلف فيها العلماء هي أبواب في فروع من ربا البيوع، أما ربا الديون الذي هو ربا الجاهلية فلم يكن غامضاً ولا مجهولاً، فإن “كلمة الربا لها مدلول لغوى عند العرب، وكانوا يتعاملون به ويعرفونه، وأن هذا المدلول هو زيادة الدين نظير الأجل، وإن النص القرآني كان واضحاً في تحريم هذا النوع، وقد فسره النبي بأنه الربا الجاهلية، فليس لأي إنسان – فقيه أو غير فقيه – أن يـدعى إبهـاماً في هذا المـعنى اللغوى أو عدم تعيين المعنى تعينناً صادقاً، فإن اللغة عيَّنته، والنص القرآنى عيَّنه بقول الله تعالى: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (البقرة 279)”([6]).
ومن تأمل الروايات الواردة عن عمر لتبين له أنه يقصد الفروع الخافية من ربا البيوع، بدليل أنه كان من أعلم وأفقه الناس بالربا وخفاياه، يدل على ذلك قوله: “إن من الربا أبوابا تخفي، منها: السَّلَمُ في السِّنِّ” “ولو كان الربا في القرآن غامضًا لبينه رسول الله؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز”([7])، ومن العجب أن يتصوروا “أن يحرم الله تعالى شيئاً وينزل فيه من الوعيد الهائل ما لم ينزل في غيره”([8])، ثم لا يبين لعباده ما هو بالتحديد هذا الشيء المحرم.
الشبهة الثانية: هي حصر الربا المحرم في صورة واحدة وهي التي يتجلى فيها الاستغلال لحاجة المدين، وهو ما يسمونه بالربا الاستهلاكى، ونفيه عن الربا الإنتاجي، والحقيقة أن الربا الذي كان متفشياً في الجاهلية كان أغلبه من نوع القروض الإنتاجية التجارية.
إن النصوص الواردة في تحريم الربا ” لم تفرق بين ربا في قرض استهلاكي وربا في قرض إنتاجي”([9]) فالآيات عامة، ولم يقم دليل على تخصيصها، “ولو كان الربا الذي حرمه الله تعالى هو ربا الاستهلاك… ما كان هناك وجه لأن يلعن رسول الله مؤكل الربا الذي يعطى الفائدة… إذ كيف يلعن من يقترض ليأكل، وقد أباح الله ورسوله أكل الميتة والدم لضرورة المخمصة”([10]) ولو كان الربا مرتبطا بالحاجة والاستغلال “فكيف سوى رسول الله بين الاثنين حيث قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء”([11]).
الشبهة الثالثة: قالوا بأن هذه التي تطلقون عليها قروضاً ليست قروضا، وإنما هي ودائع، وجواب هذه الشبهة من وجوه:
الأول: إذا كان يطلق على الأموال التي يأخذها البنك من المودعين ودائع؛ فماذا يطلق على الأموال التي يعطيها البنك للمقترضين, إنها تسمى في عرف البنوك قروضاً، فكيف فرقوا بين متماثلين في الحقيقة لمجرد اختلاف الاسم ؟!
الثاني: أن هذه الودائع خرجت عن حكم الوديعة في الشريعة ودخلت في حكم القرض؛ لأن هذه الوديعة التي يودعها العميل في البنك “وديعة مضمونة، ومضمونة مع اشتراط فائدة للمودع، فهي لا محالة قرض، وهو القرض غير الحسن”([12]).
الثالث: أن هذا المصطلح (وديعة) “مصطلح بنكي وضعي لا مصطلح شرعي فقهي”([13]) فلا يفرض على الصورة الشرعية صور وضعية لمجرد اصطلاح يغير الأسماء، ويضع للمحرمات أسماء تغطى قبحها وشناعتها، كما تسمى الخمر “ويسكى” وتسمى الشبهات المعارضة للعقيدة “فلسفة”.
وإن من أبلغ الردود على ذلك رد من يبررون الفوائد الربوية أنفسهم، مثل قول الشيخ طنطاوى: “وأما ما يسميه البعض بالوديعة… فهذا اصطلاح شائع وعرف مستحدث، ليس له سند من أصول اللغة العربية، ولا من القواعد الشرعية”([14]) إلا أن فضيلة الشيخ رفض تسمية ودائع, واعتبرها عرف مستحدث ووضع تسمية أحدث وهي الاستثمار، وهي الشبهة التي سنجيب أيضا.
الشبهة الرابعة: يقول سيد طنطاوى “كما يتبين بوضوح أن ما تعطيه البنوك من أموال لرجال الأعمال ولأصحاب المشروعات التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو غيرهم من الأغنياء لا يسمى قرضاً، وإنما يسمى استثماراً لهذه الأموال، في مقابل أن تأخذ البنوك منهم جزءاً من أرباحهم نظير استثمارهم لهذه الأموال في مشروعاتهم الإنتاجية المتنوعة “فالقروض التي تمارسها البنوك -بناء على قول الشيخ- ليست قروضاً، ولا حتى ودائع، وإنما هي استثمار، هذا هو التكييف الجديد الذي توصل إليه فضيلة الشيخ سيد طنطاوي، ولا ندرى كيف يمكن أن يُسْتَصْدَرَ حكم شرعي على هذا الوصف المجمل الفضفاض.
إن مصطلح الاستثمار مصطلح عامٌ مجمل يندرج تحته ما لا يحصى من المعاملات التي يمكن أن تكون حراماً ويمكن أن تكون حلالاً، فهو أوسع من مصطلح التجارة، الذي يطلق على الاتجار في الحلال والاتجار في الحرام، إن الذين يعصرون العنب ويصنعون منه خمرا، ويبيعونها في أسواق أوربا يسمون عملهم هذا استثماراً، والذين يربون الخنازير في مزارع خاصة ويبيعونها ويربحون منها يسمون عملهم هذا استثماراً، وهي تسمية مطابقة للواقع؛ لأن الاستثمار هو تثمير المال وتنميته، وهذا قد يكون بالطرق المحرمة كما يكون بالطرق الحلال الجائزة.
ووسائل الاستثمار في الشريعة الإسلامية كثيرة: منها المزارعة والمساقاة والمضاربة والمشاركة والبيع والشراء وغير ذلك, وكل وسيلة لها أحكامها، وكما أن الوديعة لها أحكامها والقرض له أحكامه، فلابد من تحديد وصف منضبط حتى يتنزل الحكم الشرعي عليه، أما أن نقول إنه استثمار فهو مثل قولنا عن جماعة يشربون الحشيشة ويلعبون القمار ليلاً: إنهم قوم ” يسمرون”، ومعلوم أن السمر قد يكون في الطاعة وقد يكون في المعصية، وقد يكون في دائرة المباح.
وقريب من هذا الزعم زعم على جمعة أنها (تمويل) وحسب الشيخ أن هذا التكييف يخرجها عن كونها قروضا، وقال في برنامج تلفزيونى بقناة دريم الفضائية: إن تكييف ودائع البنوك على أنها قروض قد تغير لأن البنوك تطورت، وصار التكييف المعاصر لها هو أنها (تمويل) واستدل على ذلك بأن البنوك لم تعد تطلق لفظ القروض في نشراتها,وإنما سارت تطلق لفظ التمويل؛ والواقع أن الحكم الشرعى لا يتبع المسميات وإنما يتبع الحقائق الواقعة, فتغير الاسم لا يستلزم تغير الحكم الشرعى، وإنما الذي يستلزمة هو تغير واقع المعاملة وهي لم تتغير؛ فلا تزال موصوفة بالضمان واشتراط الفائدة؛ وهذان هما مناط الحكم.
الشبهة الخامسة: أن تحديد نسبة الربح مقدماً لا علاقة لها بالحل والحرمة، وليس مع من قال بذلك دليل؛ وعليه فيمكن تخريج هذه المعاملة على أساس المضاربة الشرعية أو الاستثمار كما يقول الشيخ طنطاوى” وتحديد نسبة الربح مقدماً لا علاقة لها بالحل أو الحرمة، ما دام الطرفان قد رضيا عن طواعية واختيار بهذا التحديد الذي لم يتم في العادة إلا بعد ما يسمى بدراسة جدوى”([15]) ومن قبل قال الشيخ عبد الوهاب خلاف؛ بصدد تبريره لأرباح صندوق التوفير: “وكل ما يعترض به على هذا أن المضاربة يشترط لصحتها أن يكون الربح نسبياً لا قدراً معيناً، وأرد هذا الاعتراض بوجوه أولها: أن هذا الاشتراط لا دليل عليه من القرآن أو السنة”([16]).
نقول في جواب هذه الشبهة الزائفة: إن “حقيقة المضاربة تخالف تمام المخالفة حقيقة القرض بفائدة؛ إذ المضاربة من معناها الشرعي ومن حكمها الفقهي أن الخسارة تكون دائما على صاحب رأس المال، لا يتحمل العامل خسارة مالية … وحسبه من الخسارة أنه أضاع جهده، بينما القرض … تكون الخسارة كلها على المقترض ولا يتحمل صاحب المال منها شيئا ثم هو فوق ذلك سيأخذ ما يسميه الإسلام ربا ويسـميه الذين يحاولون تذليل الشريعة ربحاً”([17]).
والمضاربة شرطها ألا يحدد العائد مقدماً، وإنما يكون جزءاً شائعاً من الربح لا من رأس المال، كالنصف مثلا “وهذا الشرط قد اتفق عليه الأئمة الأربعة والظاهرية واستدلوا عليه بالسنة والإجماع والقياس وبالقواعد الفقهية والمعقول”([18])، فربح المضاربة نسبة مئوية من الربح لا من رأس المال، أمّا في القرض البنكي وكذلك في الودائع المصرفية هو نسبة من رأس المال تشترط مقدما.
الشبهة السادسة: أنها معاملة قائمة على التراضى وقد أحل الله تعالى المعاملة التي تقوم على تراضى الطرفين, فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (النساء 29)، والجواب أن التراضى بين طرفي المعاملة -وإن كان شرطا للعقد- لا يحل ما حرم الله من العقود, فإن الرضا شرط للعقد وليس سبباً للحل والإباحة, وهي قاعدة من القواعد العامة في الفقه الإسلامي، ولو كان التراضي سبباً لحل العقد لصار عقد المحلل حلالاً لمجرد رضا الطرفين به، ولصار العقد على واحدة من المحرمات حلالاً لكونه بنى على تراضى الطرفين، إن التراضي لا يحل ما حرم الله تعالى من العقود والتصرفات؛ وإنما هو فقط ركن في العقد الذي أحله الله تعالى وشرط لصحته.
الشبهة السابعة: أنها معاملة خالية من الغش والكذب والخداع والاستغلال, يقول الشيخ الدكتور سيد طنطاوي: “ورأيى بعد كل ذلك أن كل معاملة تتم بالتراضي المشروع بين الطرفين وخالية من الغش والكذب والخداع والاستغلال ومن كل ما حرمه الله تعالى فهي حلال”([19]) والجواب أن معاملة البنوك لو فرضنا جدلاً أنها خالية من الغش والكذب والخداع والاستغلال -وهذا غير صحيح- فهي قائمة على ما هو أعظم وأضخم وهو ربا الجاهلية الذي غلظ القرآن تحريمه, وأعلن رب العالمين الحرب على المصرين عليه, ولعن رسول الله r كل الأطراف المساهمة فيه مساهمة مباشرة، وحرمة الربا ليست معلقة على شرط وجود الكذب والخداع والغش, ولم يقل أحد من العلماء إن الربا إذا وقع بالتراضى بين الطرفين دون أن يغش أحدهما الآخر أو يخدعه أو يكذب عليه فإنه يحل بذلك.
الشبهة الثامنة: تعليق الأمر على النية, فمن نوى الربا فهو ربا, ومن نوى أن يكون البنك وكيلا عنه لاستثمار أمواله فليس ربا, يقول الدكتور طنطاوى: “وأن كل ما يقدمه أي إنسان من أموال لأي بنك من البنوك ونيته وقصده أن يكون البنك وكيلاً عنه وكالة مطلقة في استثماره لأمواله, وأنه راض كل الرضا بما يعطيه له البنك من أرباح سواءً أحددها له البنك مقدماً أم لم يحددها فهذه المعاملة والأرباح التي تترتب عيها حلال”.
والجواب: أن النية وحدها لا تكفي لتمييز التصرفات التي هي من نوع العقود؛ لأن العقود لا تقوم على النية وحدها ولا على التراضي وحده، ولا على الأعمال القلبية وحدها, وإلا لما كانت عقوداً، إن للعقود جانب بارز تناط به الأحكام, وهو الإيجاب والقبول, ولم يقل أحد من العلماء البتة بأن الإيجاب والقبول الذي هو ركن العقد شئ معنوي يتمثل في الرضا أو النية أو القصد أو شيئاً من ذلك, وإنما الذي قرره العلماء بأجمعهم ومعهم رجال القانون بأجمعهم أن الإيجاب والقبول صورة عملية بارزة وليس مشاعر قلبية مطوية، وهذه الصورة العملية البارزة قد تتمثل في قول يقوله الطرفان وهو الغالب, وقد تتمثل في عمل كالكتابة, بحسب العرف الذي جرى عليه التعاقد, وحسبما تقرره قاعدة ” العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو عمل”، أما أن تتفرد النية بحسم عقد أو نقل معاملة من عقد إلى عقد ومن صورة لها أحكامها إلى صورة أخرى لها أحكام مختلفة فهذا ما لا يمكن أن يقوله عالم في عهد من عهود الإسلام.
وهل يمكن أن تحل المرأة للرجل بمجرد رضاه أن تكون له زوجة ورضاها أن يكون لها زوجاً، وبمجرد نيته أن يتزوجها وتكون أماً لأولاده وراعية لأسرته وحافظة لعفته ؟! إن للعقد صورة تناط بها الأحكام وتتميز بها حدود الله تعالى، هذه الحدود هي التي تفصل بين الحلال والحرام, ولقد ” ضرب بعض العلماء المثل لهذا بالرجل تعجبه المرأة الأجنبية, ويحرص على أن يستمتع بها, فإذا هو تولى ذلك وقضى وطره بالنكاح الشرعى كان ذلك حِلاً وبِلاً, وان هو عدا النكاح الشرعى وتولاه بصورة أخرى كان من الآثمين”([20]).
إن الشريعة قد وضعت لكل معاملة ولكل عقد صورة تناط بها الأحكام ويتميز بها الحلال من الحرام، فمن رام المعاملات المشروعة فليسلك إليها سبلها, أما أن يسلك سبل الحرام وهو ينوى الحلال فهذا لا يسوغ في عقل ولا شرع.
الشبهة التاسعة: قالوا إنها معاملة جديدة، ليس لها مثال سابق، ويا له من قول عجيب ! لنفترض أنها معاملة جديدة، ولنغض الطرف عن المطابقة الكاملة بين الربا الجاهلي الذي نزل القرآن بتحريمه وبين الربا الجاهلي الذي تمارسه البنوك، ولندر ظهرنا لكل الفتاوى والقرارات التي صدرت عن المجامع الفقهية الكبرى في العالم الإسلامي؛ فهل كونها معاملة جديدة يرفع يد الشريعة عنها فلا تملك أن تصدر عليها حكماً بالحل أو الحرمة؟! أم إن الشريعة أعطت صكاً بالجواز لكل جديد يبتكره البشر تشجيعاً لهم على التجديد والتحديث ؟
ما هذا الدجل الذي يصب خلاصة الفكر العلماني في قوالب شرعية وصفائح فقهية، أيريد هؤلاء أن يقولوا إن الشريعة تعجز عن ملاحقة الجديد في حياة البشرية وإصدار حكمها عليه, أم يريدون أن يقولوا إن سلطان الشريعة كان على ما كان سابقاً في حياة الناس, وأما الجديد في عصر النضج البشرى فلا وصاية للسماء عليه ؟
إن شريعة الله تعالى نزلت لتكون الحاكمة المهيمنة على البشرية كلها إلى يوم الدين, ولا تخرج كبيرة ولا صغيرة في حياة الناس عن سلطان هذه الشريعة, ولا يمكن أن يستجد شئ على هذا الكوكب دون أن يكون لها فيه حكم واضح بين، وكل معاملة من المعاملات تستجد في حياة الناس ترد إلى القواعد المقررة, وإلى الصور التي نص على أحكامها, فتلحق بها عن طريق القياس أو عن طريق دلالة النص وفحوى الخطاب.
والمعاملة البنكية لم يعجز العلماء عن توصيفها وتحديد شكلها الذي يتنزل عليه الحكم المناسب, بل إن القانون المدني نفسه الذي هو من إفراز العصر الذي أفرز البنوك نص على أن هذه المعاملة تعد من قبيل القرض, فتنص المادة 726مدنى على أنه “إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شئ آخر مما يهلك بالاستعمال, وكان المودع عنده مأذوناً له باستعماله اعتبر العقد قرضاً “([21])؛ فالودائع المصرفية التي يضعها العملاء في البنوك وقد أذنوا في استعمالها جاء توصيف القانون المدني لها على أنها قرض، وبالتالي هذا التوصيف سيسحب عليها أحكام القرض من ضمان المقترض للوديعة وغير ذلك.
ويقول العلامة عبد الرزاق السنهوري: “وقد اتخذ القرض صوراً مختلفة أخرى غير الصور المألوفة … من ذلك إيداع نقود في مصرف, فالعميل الذي أودع النقود هو المقرض، والمصرف هو المقترض، وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة, وتعتبر قرضاً”([22])، فإذا كان رجال القانون -الذي تدخل البنوك تحت سلطانه وحكمه- قد كيفوا هذه المعاملة على أنها قرض, وهو نفس التكييف الذي قال به علماء الشريعة في هذا العصر، فهل يبقى شك في أنها محددة المعالم ؟, وهل يمكن أن يقال بعد كل هذا إنها معاملة جديدة على غير مثال سابق ؟!
الشبهة العاشرة: أن الربا المحرم هو الربا المضاعف لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران 130)، وجواب هذه الشبهة من وجهين:
الأول: أن “التقييد بالأضعاف المضاعفة ليس للتخصيص والاحتراز عما عداه, وإنما لمراعاة الغالب فيهم, مثل التقييد في قول الله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) (النساء 23)، فقوله تعالى في حجوركم ليس للاحتراز… وإنما هو لمراعاة الواقع الغالب([23]).
الثاني: أن تحريم الربا مر بمراحل انتهت بتحريم الربا: قليلة وكثيرة, وجملة القول في هذه المراحل” أن آيتى الروم والنساء إنما كان الغرض منهما تهيئة النفوس لتلقى تحريم الربا بالرضا والقبول, فلما تهيأت لذلك نهوا عن الربا المضاعف فقط بمقتضى آية آل عمران, أما غير المضاعف فبقى مسكوتاً عنه حتى نزلت آيات البقرة, فبين الله فيها أنه أصدر أمره بتحريم الربا إطلاقا, قليلا كان أو كثيراً “([24]) وجاء اللفظ حاسماً قاطعاً نافياً للقليل والكثير: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)) (البقرة 278-279).
الشبهة الحادية عشر: زعموا أن حكم الربا لا ينسحب على الأوراق النقدية؛ لأن الربا حرم في ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح, كما هو في حديث عبادة بن الصامت, وإذا قلنا بالقياس على هذه الأصناف فإن العملة الورقية لا تقاس على الذهب والفضة وإنما تقاس على الفلوس التي منع العلماء قياسها على الذهب والفضة.
ونقول في جواب هذه الشبهة الخطيرة: إن قياس العملة الورقية على الفلوس وعدم قياسها على الذهب والفضة؛ لإخراجها من دائرة الأموال الربوية قول مرفوض منقوض, مخالف للحق الذي يقضى به القياس الصحيح والنظر السليم, ومخالف لما قررته المجامع الفقهية، وسوف أبين هذه المسألة الخطيرة في الموضع الخاص بربا البيوع.
أما الذي أريد أن أحسمه الآن فهو أن الأموال الربوية التي جاء بها حديث عبادة, والتي اختلف العلماء في إلحاق غيرها بها لا مدخل لها هنا؛ لأن مجال عملها وتأثيرها هناك في ربا البيوع, أما ربا الديون أو ربا الجاهلية فلا علاقة له بمسألة حصر الربا في أموال معينة هي الأموال الربوية، فالربا المنحصر في الربويات هو ربا البيوع, أما الربا الذي يكون في القروض والديون فلا علاقة له البتة بهذه المسألة, وإنما يكون في جميع الأموال بلا استثناء وهذا بإجماع العلماء.
فمن أقرض مالاً أيا كان نوع هذا المال فليس له إلا ما أقرض ” وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء”([25]) فالعلماء الذين اختلفوا في أصناف الأموال التي تدخل في ربا البيوع لم يختلفوا في أن ربا الديون والقروض يقع في جميع الأموال, وحتى ” أهل الظاهر الذين خالفوا الجمهور فوقفوا عند الأصناف الستة في البيع لم يخرجوا عن الإجماع في القرض”([26]) بل إن زعيمهم صاحب المحلى نص على هذا الإجماع فقال: “الربا لا يجوز في البيع والسلم, في ستة أشياء فقط: في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة, وهو في القرض في كل شئ… وهذا إجماع مقطوع به”([27]) وروى وهب عن مالك قوله: ” كل شئ أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا”([28]).
الشبهة الثانية عشر: أن هذه المعاملات تدخل في مجال المصالح المرسلة، التي تتمثل في توظيف هذه الأموال في المشاريع الإنتاجية النافعة للأمة.
وجواب هذه الشبهة: أن المصالح المرسلة هي المصالح التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء، والمصالح التي تجتنى من المعاملات الربوية مصالح ملغاة شرعاً، ولا اعتبار لها، شأنها في هذا شأن كل مصلحة ترجى من وراء المحرم، ومجال العمل بالمصلحة المرسلة لا يكون إلا عند عدم الدليل من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، ثم إن “مفاسد القروض الإنتاجية أكثر وأخطر من المصالح المتوهمة المشار إليها؛ لأن المنتج يضيف مقدار الفائدة على تكاليف الإنتاج التي يتحملها المستهلك في نهاية الأمر، ولأن ارتفاع سعر السلع فيه مضرة بمجموع الناس، ولأن الفائدة تسخر العمل لخدمة رأس المال دائما”، ولأن إقراض الموسرين يحصر الثروة في أيديهم، ويؤدى إلى التضخم النقدي، والتفاوت الصارخ بين الأغنياء والفقراء”([29])
الشبهة الثالثة عشرة: أن الفائدة الربوية في مقابل فارق التضخم، وهذا تبرير غريب يتولاه -نيابة عن البنوك- الذين يحاولون بشتى الحيل تسويغ معاملاتها الربوية، في الوقت الذي لم تزعم فيه البنوك هذا الزعم ولم تدَّع هذا الادعاء. ومن المعلوم للقاصى والدانى أن الفائدة التي تضعها البنوك تشتمل على شرائح عدة: شريحة منها لتعويض التضخم، وشريحة لمواجهة المخاطر المحتملة، وأما الشريحة الكبرى فهي الربحية المحتسبة بناء على دراسة الأحوال الاقتصادية.
ومن أكبر الأدلة على أن مسألة تعويض فارق التضخم مسألة ثانوية: “أن البنك يفعل هذا مع من يتعامل معه بعملة لا تتناقص قدرتها مثل العملات الصعبة… فهو يعطى عليها فائدة ثابتة باستمرار سواء ظلت على قيمتها أو ارتفعت”([30])، وإذا صلح هذا التبرير في حال إقراض البنك للعملاء، فهل يمكن أن يصلح في حال إيداع العملاء في البنك فليطالبوا البنك أن يدفع فرق التضخم إذا كان أكبر من الفائدة المقررة”([31]).
الشبهة الرابعة عشرة: الادعاء بأن عمدة القائلين بحرمة فوائد البنوك في فهم الربا المحرم هو حديث “كل قرض جر منفعة فهو ربا” وهو حديت لا يصح. وهي شبهة ساقطة لسببين:
الأول: أن قاعدة ” كل قرض جر نفعأ فهو ربا ” قاعدة مقررة بإجماع العلماء؛ فلا يضرها ضعف الحديث، وقد سبق ايراد أقوال العلماء الذين نقلوا الإجماع.
الثاني: أن المعتمد على فهم الربا وتحديده هو القرآن نفسه فقد قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)) (البقرة 278-279)، والآية واضحة الدلالة على أن ما زاد على رأس المال هو الربا الذي نهت عنه الآيات السابقة لها، وأن الخلاص منه يكون بالاكتفاء بأخذ رأس المال بلا زيادة.
الشبهة الخامسة عشرة: أن هذه المعاملة انتفاع مشترك بين الدائن والمدين، وهي شبهة لا تقوم على ساق؛ لأن “اشتراك الدائن والمدين في الانتفاع بالمعاملة الربوية، وإن كل واحد منهما يحصل منها على فائدة لا ينقل المعاملة من التحريم إلى الحل؛ لأن الشارع الحكيم لم يلتفت إلى ذلك، ولو كان الانتفاع يحلها لبينه الشارع في كتابه أو على لسان نبيه”([32])
الشبهة السادسة عشرة: قالوا إن الحكمة من تحريم الربا ليست موجودة في الواقع الذي تمارس فيه البنوك عملها؛ لأن الربا إنما حرم دفعًا لاستغلال الغنى حاجة الفقير، أما البنوك فلا تستغل أحدًا بل تحقق إنتاجاً واستثماراً.
وهي شبهة مبنية على فهم خاطئ، وعلى قصور وعجلة، فأما الفهم الخاطئ الذي بنيت عليه هذه الشبهة فهو حصرهم للربا الذي وقع في الجاهلية في صورة الربا الاستهلاكي الذي يستغل فيه الغنى حاجة الفقير، وقد سبق أن بينا أن الربا الجاهلي لم يكن محصوراً ولا غالبًا في هذه الصورة، بل إن الغالب عليه هو الربا الإنتاجي القائم على القروض الإنتاجية، أما القصور والعجلة فيتمثلان في محاولة حصر الحكمة الإلهية في زاوية ضيقة، ووقفها على ما وصل إليه الفهم القاصر المتعجل.
إن الحكمة الإلهية لا يستطيع أحد كائناُ من كان أن يحيط بها، والواجب على العبد أن يستجيب لأمر الله تعالى سواء علم الحكمة أم جهلها، وهذا شرط العبودية في القيام بالتكاليف الشرعية، فإذا علمنا جانبًا من الحكمة في حكم معين من أحكام الشرع وجب علينا -تأدبا مع الله- ألا نحصر الحكمة فيما وصل إليه فهمنا، وألا نجزم بأنها هي الحكمة إلا أن ينص عليها نص صريح من كتاب أو سنة.
إن الربا حرم في الشرائع كلها لحكم كثيرة، لعل منها “أن المال لا يلد المال لذاته وإنما ينمو المال بالعمل وبذل الجهد”([33]) فإذا لم يشارك المال مع العمل في المغرم والمغنم، ولم يتحمل في الخسارة كما يناله من الربح، وشرط لنفسه الغنم دائما والربح أبداً فهذه هي: “روح الربا الذي أشاعه اليهود: أن يلد المال المال وحده، دون أن يبذل صاحبه جهدًا، أو يخاطر في مشاركة يتحمل فيه المسئولية مع الطرف العامل فيتقاسمان المغرم والمغنم جميعًا”([34]) إن العدل يقتضي تحريم الربا لأجل ” تحقيق الاشتراك العادل بين المال والعمل، وتحمل المخاطرة ونتائجها بشجاعة ومسئولية، وهذا هو عدل الإسلام فلم يتحيز إلى العمل ضد رأس المال، ولا إلى رأس المال ضد العمل”([35]).
ولعل من الحكمة أيضًا: الحيلولة دون الوقوع في المفاسد الهائلة التي حذر منها خبراء الاقتصاد في العالم، وهي أن الربا يؤدى -بمرور الزمن- إلى التباين الشديد والهوة الواسعة بين طبقة الأغنياء وطبقة العاملين الكادحين، وأنه يؤدى إلى زيادة التضخم النقدي الذي ينشأ عنه كثير من ألوان الخلل والاضطراب في الحقوق والالتزامات المؤجلة.
هذا بالإضافة إلى الأمراض النفسية والاجتماعية التي تستشري في البيئة الربوية: من الأثرة، والأنانية، وتعظيم المال، وتقلص الفضائل المتعلقة بالمال كالزهد والكرم والإيثار وغير ذلك.
هذه هي أكبر وأغلب الشبهات التي تكتنف الحكم على فوائد البنوك بالتحريم، ويبقى هناك بعض الشبهات السخيفة، التي وصلت من السماجة إلى حد لا يجعلها تستحق الذكر أو الالتفات. كمن يقول إن البنك ليس مكلفا حتى يحكم على أعماله بالحل والحرمة، ومن يقول إن البنك ليس فقيرًا حتى نقرضه، ومن يقول إن هذه القروض تأخذ حكم السلم، أو أنها ضرورة اقتصادية، إلى غير ذلك من الأقوال الساقطة المتهافتة.
وأخيرًا نقول إن هذه الشبهات ما كانت تستحق الرد – لولا الحرص على إتمام البيان – لأنها بلغت من التباين والاختلاف وعدم التجانس – على كثرتها – مبلغأ يؤكد تهافتها وتساقطها، ومما يلفت النظر ويسترعى الانتباه أن كل جيل من أجيال المسوغين للربا يبنى شبهاته على أنقاض شبهات أسلافه؛ وهذا من أوضح الادلة على بطلان الجميع، والله تعالى أعلم
([1]) قرارمجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني بالقاهرة 1385هـ/1965م.
([2]) قرار مجمع لفقه الإسلامي في مؤتمره الثاني بجدة 1406هـ/1985م.
([3]) القرار السادس لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة من 12 رجب 1406 هـ إلى 16 رجب 1406هـ.
([4]) التوصية الأولى من توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية بالكويت 1403 هـ.
([5]) المعاملات في الإسلام لفضيلة الدكتور سيد طنطاوى ص26.
([6]) بحوث في الربا للشيخ محمد أبو زهرة ص 29/30.
([7]) فوائد البنوك هي الربا المحرم – د/ يوسف القرضاوي ط مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر – القاهرة – ص 55.
([8]) فوائد البنوك هي الربا المحرم ص 10.
([9]) ما لا يسع التاجر جهله د. صلاح الصاوي وزميله – ص 341.
([10]) فوائد البنوك هي الربا الحرام ص 45-46.
([11]) حكم ودائع البنوك ص 64.
([12]) مقال: حكم الربا في الشريعة الإسلامية, للدكتور عبد الرحمن تاج نقلا عن كتاب الربا والقضايا المعاصرة ص 48.
([13]) فوائد البنوك هي الربا الحرام ص 56.
([14]) المعاملات في الإسلام ص 44.
([15]) المعاملات الإسلامية د محمد سيد طنطاوي ص 45.
([16]) الربا: للشيخ عبد الوهاب خلاف, لواء الإسلام السنة الرابعة رجب 1370هـ إبريل 1951م
([17]) شريعة الله حاكمة لا محكومة، مقال لمجلة لواء الإسلام شوال 370 هـ يوليو1951 م فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة.
([18]) بيان علماء الأزهر في مكة, نقلا عن كتاب الدكتور محمد أبو شهبة (حلول لمشكلة الربا ص6).
([19]) المعاملات في الإسلام ص 78.
([20]) مقال (حول بحث الربا) للشيخ محمد على النجار, مجلة لواء الإسلام يوليو 1951، نقلا عن كتاب الربا والقضايا المعاصرة ص 103.
([21]) المادة (726) من القانون المدني.
([22]) الوسيط في شرح القانون المدني 5/435.
([23]) مقال الربا، للشيخ عبد الوهاب خلاف، مجلة لواء الإسلام عدد رجب 1370هـ أبريل 1951.
([24]) مقال (الربا للأستاذ عبد الله السليمان- مجلة لواء الإسلام عدد شوال 1370هـ ي- نقلاً عن كتاب الربا والقضايا المعاصرة ص 94.
([25]) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/473.
([26]) السابق 29/535.
([27]) المحلى لابن حزم 8/467.
([28]) المدونة الكبرى 9/25.
([29]) الفقه الإسلامي وأدلته 5/3751.
([30]) فوائد النبوك هي الربا المحرم ص 96.
([31]) فوائد النبوك هي الربا المحرم ص 69.
([32]) مقال: الرد على من أباح الفوائد الربوية، لابن باز – مجلة البيان عدد 14.
([33]) فوائد البنوك هي الربا الحرام ص 47.
([34]) السابق ص 47.
([35]) السابق ص 49.