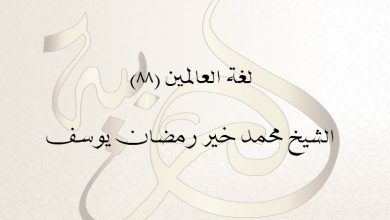دعوة إلى المشاركة في الملف البحثي «الشريعة والعلمانية والدولة: نحو آفاق جديدة»
الورقة المرجعية
منذ البعثة المحمَّدية وحتى التحوُّل الحداثي الكبير، كانت الشريعة الإسلامية هي الإطار المرجعي العام للحياة القانونية والاجتماعية في البلدان ذات الغالبية المسلمة، وكان للشريعة بمنظوماتها وعلومها ومؤسساتها موقعٌ مركزيٌّ في صياغة حياة المسلمين في المجتمع والدولة. وغنيٌّ عن القول أن الشريعة تاريخيًّا، منذ تقعيدها وحتى تقنينها، لم تكن على صورةٍ واحدةٍ، بل إنها مرَّت بعدَّة أطوار متعاقبة واتخذت عدَّة صيغٍ متجاورة، وقد أسهم في حركتها التفاعلية هذه العديدُ من العوامل والمعطيات الذاتية النظرية والخارجية الواقعية. ولم يكن يُنظر إلى هذا التجدُّد والتنوُّع بوصفه انحرافًا عن الأصل -إلَّا إذا تجاوز حدودًا معلومةً- بل بوصفه علامةً صحيَّةً ودليلًا على الصلاحية والقدرة على الاستجابة للنوازل، وبوصفه مرادًا من الشارع الحكيم الرحيم.
ظلَّت الشريعة -بوصفها بيانًا وتنزيلًا لأحكام الشارع- هي السلطة المرجعية التي تمنح الشرعيةَ لمؤسسات المجتمع، بما في ذلك الدولة. ولمَّا كان العلماء -المستقلون بوصفهم جسمًا اجتماعيًّا تدعمه شبكات الأوقاف والمجتمع- هم الممثلين المؤهَّلين المعترف بهم للاجتهاد في تفسير الوحي، فإنَّ سلطتهم كانت تمثِّل سلطةً دستوريةً موازيةً لسلطة الحاكم، لها الحقُّ والقدرة -ولو نظريًّا- على تقويم سياساته وقراراته (أو على الأقل -عمليًّا- فرض نوعٍ من الرقابة الأخلاقية-المجتمعية عليها).
مع بواكير العصر الحديث، تأثَّرت دول المسلمين -العثمانية والصفوية والتيمورية الهندية- بدرجاتٍ متفاوتةٍ بالتطوُّرات القانونية والمؤسَّسية والعسكرية الحديثة، وشهدت بعضها صراعاتٍ داخلية بين نُخب تقليدية وأخرى إصلاحية “حداثية” تسعى إلى تفعيل المنظومة البرلمانية والدستورية والقانونية الأوروبية. ثمَّ كان لدخول الاستعمار إلى بلادنا العربية أشدُّ الأثر في تفكيك مؤسسات الشريعة التقليدية وإحلال منظومة الدولة الحديثة محلَّها. لم ينبع هذا التحوُّل من الديناميكيات الداخلية للمجتمع، ولم يُنجز في الغالب عبر حوار داخليٍّ صحيٍّ مع المنظومة المرجعية القائمة (من الأسفل إلى الأعلى)، بل كثيرًا ما تمَّ قهرًا وإخضاعًا (من الأعلى إلى الأسفل)، الأمر الذي أدَّى إلى خلق تشوُّهاتٍ بنيويَّة في المجتمع والفكر ما تزال تعمل عملها المُعيق في وجه كلِّ خطوة إلى الأمام، وما تزال تسبِّب انقسامًا عميقًا يعيق أيَّ “إجماع حول الدولة”.
اقترنت عملية “تحديث” المجتمعات والدولة العربية بـ “العلمانية” بوصفها فلسفةً نظريةً وإجراءً عمليًّا لتنظيم الحيِّز السياسي وعَقْلنته (ترشيده) وتخليصه مما عُدَّ آفاتٍ للتعصُّب الديني والجمود التقليدي. وعلى الرغم من أن الانتقادات الغربية (أدبيات ما بعد العلمانية) التي توجَّهت إلى إبراز “تاريخية” مفهوم العلمانية، وتنوُّع تطبيقاته في الفضاء الغربي، وإلى التأكيد على التداخل بين “المقدَّس” و”العلماني”، فإنَّ العلمانية ظلَّت -في نظر التيار السائد من المُنظِّرين السياسيين- هي الفلسفة السياسية التي تنهض عليها تصوُّرات “الدولة الحديثة” وجهازها القانوني، وظلَّت هي الشرط الضروري للتحوُّل الديمقراطي.
على المستوى القانوني والدستوري، تبنَّت الدول العربية ما بعد الاستعمارية منظومةَ الدولة الحديثة وأنظمتَها القانونية والدستورية، ولكنها حافظت على حضورٍ للشريعة، يمكن وصفُه بأنه شكليٌّ وهامشيٌّ؛ إذ أقرَّت معظم الدساتير العربية بالإسلام دينًا رسميًّا للدولة، واستبقت الشريعة في مجال الأحوال الشخصية. ومع تأميم الأوقاف وتنظيم مؤسسات الإسلام الرسمي التابعة للدولة، فَقَدت منظومة الشريعة استقلاليتَها وفاعليتَها، وأصبحت وظيفتها مقتصرةً على تزويد المنظومة القانونية الحديثة بالمادَّة الخام في مجال “الأحوال الشخصية”، وعلى إسباغ الشرعية الدينية على أنظمة الحكم.
ارتبطت “العلمانية” في الفضاء العربي الإسلامي بالاستعمار الغربي والإمبريالية الثقافية، وشهد العالم العربي إبَّان حقبة الأنظمة القومية والاشتراكية تجاربَ “علمانية” مارست نوعًا من الإقصاء لـ “الدين” والقدح بـ “الشريعة”، الأمر الذي خلَّف ذاكرة مريرة، نتج عنها جيلٌ من المفكِّرين الإسلاميين والقوميين الذين سَعوا إلى استبعاد مفهوم العلمانية من النقاش والتركيز على الديمقراطية بوصفها المقصدَ المنشود، الذي يُمكن أن يُجمع عليه الفرقاء الأيديولوجيون لمناهضة الاستبداد. لم تُرض هذه الصيغة جميعَ الأطراف، ولم توقف الاستقطاب الإسلامي-العلماني، ثمَّ جاءت النقاشات التي أسفر عنها ما عُرف بـ “الربيع العربي”، فأبرزت عمق هوَّة الخلاف الديني العلماني بين النخبة السياسية؛ إذ برز هذا الجدل في العديد من المحطات والمواقف السياسية بشأن الدستور، والأقليات، وموقع الشريعة من المنظومة القانونية، ودور الهُويَّة الدينية في صياغة الهُويَّة القومية للدولة. وقد أُعيد إحياء مفهوم “الدولة المدنية” بوصفه خيارًا ثالثًا، دون تحديدٍ مفهوميّ واضح، ليتحوَّل إلى حقلِ صراعٍ دلاليّ يجمع الإسلاميون والعلمانيون على عنوانه ثمَّ يختلفون في تعيين مضامينه وتطبيقاته.
استمرّ الصراع على المستويين الفكري والسياسي قائماً، بين فريق يرى في العلمانية إطاراً تنظيمياً ضرورياً للإصلاح السياسي، ويرى بأنّ حشر “العلمانية” في خانة “التغريب” ينطوي على موقف هوياتي متصلب، إذ إنّ التمييز بين الشؤون “الدينية” و”الدنيوية” كان حاضراً في النظر الفقهي والممارسة السياسية التاريخية للمسلمين. ويرى أصحاب هذا الفريق أنّ الواقع السياسي الذي أفرزته الدولة الحديثة يحتم الفصل المؤسساتي والخطابي بين الأجسام الدينية والسياسية، حماية لمبدأ المواطنة ولمبادئ الحريات الدينية والتعدّد الثقافي. وقد تضاعف إيمان هذا الفريق بموقفه نتيجة ما رآه خطراً تمثّله أحزاب الإسلام السياسي وخطابها التقليدي على منظومة الحريات والمواطنة. في المقابل، وخاصّة بعد موجة الثورات المضادة، نظرت شرائح واسعة من الإسلاميين إلى “العلمانية” بمزيد من الريبة والقلق، فقد أثبتت مسارات ما بعد الثورات -وفق وجهة نظرهم- أنّ العلمانية موقف إيديولوجي معادٍ للشريعة وحضور الهوية الإسلامية في الدولة، وأنّ كثيراً من العلمانيون مستعدّون للتحالف مع الاستبداد إن كان في ذلك ضمانة تحميهم من حكم الإسلاميين، حرصاً على الحفاظ على مصالح طبقة مخصوصة تريد توفير فضاء من الحرية الاجتماعية والشخصيّة لها، دون أن تُعنى حقاً بالدفاع عن الحريات السياسية الأساسية.
وعلى امتداد السنوات التالية لحقبة الثورة المضادة، اشتعل الفضاء الافتراضي بعشرات الصراعات الثقافية، حول قضايا متعدّدة مثل الحريات الجنسية، وجواز الترحم على غير المسلم، ونطاق حرية الرأي والتعبير في القضايا الدينية، وغير ذلك؛ وهي قضايا وإن بدت ذات صبغة اجتماعية وثقافيّة، إلا أنّها كانت في كثير من جوانبها إعادة إنتاج للاصطفاف السياسي “الإسلامي- العلماني”، وكانت تضمر وراءها سؤال “المرجعية” الكبير الذي يحكم العديد من النقاشات العربية اليوم: ما هو دور الشريعة؟ وما هو موقعها في الحيز العام؟
غير أن موجة الشعبوية التي عصفت بالعالم بأَسْره، عصفت أيضًا بمفهوم العلمانية وموقعِه من المنظومة الديمقراطية الليبرالية الغربية. فقد شهدت الشعبويات بروزًا للنزعات اليمينية المتطرفة، وإعادة انبعاث للتراثات الثقافية والرمزيات الدينية، كما أن التحوُّلات التي صاحبتها قد شجَّعت القوى الصاعدة على التأكيد على حقِّها في اتباع تقاليد سياسية مغايرة للتقليد الديمقراطي الليبرالي، الذي جرت عولمتُه في حقبة ما بعد الحرب الباردة. لم تتكشَّف الإمكانات الكاملة للموجة الشعبوية بعدُ، ولم تظهر حتى الآن تداعيات هذا التحوُّل العالمي، الذي سيؤثِّر حتمًا في المنطقة العربية وفي نقاشاتها الفكرية والسياسية. ولكنَّ واجب الفكر والوقت يستدعي إعمال النظر في خياراتنا النظرية وصداها العملي، واستشراف مآلات هذا التحوُّل وما يفتحه من إمكاناتٍ أو يرسِّخه من حقائق.
استمرّ الصراع على المستويين الفكري والسياسي قائماً، بين فريق يرى في العلمانية إطاراً تنظيمياً ضرورياً للإصلاح السياسي، ويرى بأنّ حشر “العلمانية” في خانة “التغريب” ينطوي على موقف هوياتي متصلب، إذ إنّ التمييز بين الشؤون “الدينية” و”الدنيوية” كان حاضراً في النظر الفقهي والممارسة السياسية التاريخية للمسلمين. ويرى أصحاب هذا الفريق أنّ الواقع السياسي الذي أفرزته الدولة الحديثة يحتم الفصل المؤسساتي والخطابي بين الأجسام الدينية والسياسية، حماية لمبدأ المواطنة ولمبادئ الحريات الدينية والتعدّد الثقافي. وقد تضاعف إيمان هذا الفريق بموقفه نتيجة ما رآه خطراً تمثّله أحزاب الإسلام السياسي وخطابها التقليدي على منظومة الحريات والمواطنة. في المقابل، وخاصّة بعد موجة الثورات المضادة، نظرت شرائح واسعة من الإسلاميين إلى “العلمانية” بمزيد من الريبة والقلق، فقد أثبتت مسارات ما بعد الثورات -وفق وجهة نظرهم- أنّ العلمانية موقف إيديولوجي معادٍ للشريعة وحضور الهوية الإسلامية في الدولة، وأنّ كثيراً من العلمانيون مستعدّون للتحالف مع الاستبداد إن كان في ذلك ضمانة تحميهم من حكم الإسلاميين، حرصاً على الحفاظ على مصالح طبقة مخصوصة تريد توفير فضاء من الحرية الاجتماعية والشخصيّة لها، دون أن تُعنى حقاً بالدفاع عن الحريات السياسية الأساسية.
وعلى امتداد السنوات التالية لحقبة الثورة المضادة، اشتعل الفضاء الافتراضي بعشرات الصراعات الثقافية، حول قضايا متعدّدة مثل الحريات الجنسية، وجواز الترحم على غير المسلم، ونطاق حرية الرأي والتعبير في القضايا الدينية، وغير ذلك؛ وهي قضايا وإن بدت ذات صبغة اجتماعية وثقافيّة، إلا أنّها كانت في كثير من جوانبها إعادة إنتاج للاصطفاف السياسي “الإسلامي- العلماني”، وكانت تضمر وراءها سؤال “المرجعية” الكبير الذي يحكم العديد من النقاشات العربية اليوم: ما هو دور الشريعة؟ وما هو موقعها في الحيز العام؟
لا يقتصر مفهوم العلمانية على المجال السياسي العمومي، بل يقترح بعض المفكِّرين (مثل تشارلز تايلور، ومارسيل غوشيه، وداريوش شايغان، وآخرين) أنَّ العلمانية قد باتت أُفقَ الفكر والوجود الإنساني، بعد أن كفَّت التصورات الدينية عن كونها الإطارَ الناظم للوجود الإنساني (البراديغم paradigm)، وبعد أن نُزِعَ السِّحر عن الظواهر الطبيعية وقُدِّمت منظوماتٌ تفسيرية “طبيعانية” (علمانية) منافسة تستبعد الغيب من تصوُّراتها الأساسية عن الفرد والمجتمع والجسد والفطرة. بهذا المعنى، تبدو العلمانية فلسفةً شاملةً (يراها أصحاب هذا التصوُّر مسارًا حتميًّا للإنسان الحديث) لا مجرَّد إجراءٍ تنظيميٍّ يكفل حياد الدولة تجاه الأديان. وفي هذا السياق، برزت أطروحات متعدِّدة تشكِّك في حتميَّة هذا المسار وتراه خصوصيةً غربيةً جرى تعميمُها، وتحذِّر من مآلات هذا التحوُّل وما يُلحقه من دمارٍ بالمفاهيم الأساسية عن “الطبيعة الإنسانية”، وتقدِّم -في المقابل- تصوُّرات “دينية” أخلاقية مغايرة (أمثلة ذلك في السياق العربي الإسلامي: عبد الوهاب المسيري، وطه عبد الرحمن).
المحاور البحثية والأسئلة الإرشادية
1. ما قبل العلمانية وما بعدها
يهدف هذا المحور إلى تتبُّع تشكُّلات مفاهيم العلمانية والعَلْمنة وما بعد العلمانية واللائكية، وسياقاتها التاريخية والنظرية، ومتابعة النقاشات النظرية الدائرة حول تنويعة هذه المفاهيم في الفضاء الغربي والإسلامي والعالمي. وفي ضوء ذلك، نقترح الأسئلة البحثية التالية:
بأيِّ معنى تتصل “العلمانية” بتراث المسيحية الأوروبية وبأيِّ معنى تنفصل عنه؟ هل تمثِّل العلمانية -بوصفها أُفقَ فكر وتقليدًا سياسيًّا- قطيعةً إبستمولوجية وتاريخية عن ماضيها الأوروبي، أم إعادة صياغة له؟
هل يُمكن فصل الشقِّ الفلسفي عن الشقِّ الإجرائي للعلمانية؟ وما مصاديق ذلك في الحالات الغربية وغير الغربية؟
كيف يُمكن تعريف العلمانية، وما أبرز الاقتراحات في هذا الصدد: العلمانية بوصفها فصلًا بين المؤسسات الدينية والدولة؛ العلمانية بوصفها أفولًا للدين؛ العلمانية بوصفها خصخصةً للدين…إلخ؟ وهل يُمكن التمييز بين المعرفي والأيديولوجي في هذه التعريفات؟
ما أبرز الانتقادات التي وجَّهتها أدبيات ما بعد العلمانية لهذا المفهوم؟ وهل يعني هذا النقد تجاوزًا للمفهوم بالكليَّة أم إعادة موضعة له؟
2. علمانية أم علمانيات
يهدف هذا المحور إلى تتبُّع الحالات التاريخية والمعاصرة، ورصد التنوُّع الحاصل في تطبيقات العلمانية، والكشف عن مدى وحدة المفهوم أو تنوُّعه في ظلِّ هذا التباينات في التطبيق. وفي ضوء ذلك، نقترح الأسئلة البحثية التالية:
كيف جرى تعميم مفهوم العلمانية على العالم غير الغربي؟ وكيف تفاعلت النُّخب المحليَّة والتقاليد الثقافية غير الغربية مع هذا المفهوم قبولًا وردًّا؟
ما أبرز نماذج العلمانية وكيف تختلف العلاقة بين الديني والعلماني في الدول المختلفة (الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، وتركيا، و”إسرائيل”، والهند…)؟
هل يُمكن وصف الدول العربية اليومَ بأنها دولٌ علمانية؟ وهل يعني هذا وجود نمطٍ خاصٍّ من العلمانية العربية التي تختلف عن الواقع العلماني الغربي؟ أم ما يزال الدين والشريعة يشكِّلان أساسًا من أُسس الشرعية السياسية لأنظمة الحكم العربية؟
3. العلمانية والتحديث
يهدف هذا المحور إلى فحص فرضيَّة اقتران التحديث بالعلمنة، والتمييز بين الفروض الأيديولوجية والوقائع العملية والتاريخية المؤيدة أو النافية لهذا الفرض. وفي ضوء ذلك، نقترح الأسئلة البحثية التالية:
هل اقترن التحديث غربيًّا بتراجع الدين وانحصاره في الحيِّز الخاص؟ أم للدين أدوار إيجابيَّة في عملية التحديث والبناء الاجتماعي؟
كيف جرى تلقي العلمانية عربيًّا، وأين كان موقع هذا المفهوم في عملية بناء الدولة الوطنية الحديثة ما بعد الاستعمار؟
العلمانية شرطًا للتحديث؟
هل ثمة تلازم أصليٌّ بين العلمانية وبين منظومة الدولة الحديثة؟ وهل يعني حضور الدين في المجال العام الغربي نفيًا لهذه الفرضيَّة أم إن حضور الفاعلين الدينيين مشروطٌ بقبولهم للشرط العلماني للدولة؟
4. اجتهادات واشتباكات إسلامية
يهدف هذا المحور إلى تتبُّع الجدالات الإسلامية الفكرية والسياسية حول العلمانية وعلاقتها بالشريعة، بين القائلين بضرورة المواءمة بين الشريعة ومنظومة الدولة الحديثة والقائلين باستحالة هذه المواءمة؛ كما يهدف أيضًا إلى حفز الباحثين على طرقِ زوايا نظرٍ جديدة لتجاوز هذه الثنائيَّة أو لتبيُّن أبعادها في الحالات التطبيقية القانونية أو الاجتماعية. وفي ضوء ذلك، نقترح الأسئلة البحثية التالية:
هل يصحُّ القول بأنَّ الإسلام يستبطن بطبيعته نوعًا من التمايز بين المجال العام والخاص؟ وهل يُمكن -بناءً على ذلك- القول بأنَّ “الإسلام دين علماني بطبيعته”؟ وهل تتعارض شموليَّة الدافع الديني وشموليَّة الشريعة مع التمييز بين المجالات الشخصية والعمومية؟
هل تحرَّرت اجتهادات المفكِّرين الإسلاميين في العصر الحديث من سَطوة الهيمنة الثقافية لمفهوم العلمانية؟ بعبارة أخرى: هل كانت مواقفهم القائلة بضرورة القبول بالعلمانية الإجرائية أو برفضها رفضًا جذريًّا نتيجةً لنزعاتٍ اجتماعية وسياسية تسعى إلى التحديث وَفْقَ الإطار الغربي أو تسعى إلى الاستقلال والتمايز عنه تباعًا؟
ما أبرز الاقتراحات النظرية للمواءمة بين الشريعة وبين منظومة الدولة الحديثة؟ وما أبرز الأطروحات التي ترى استحالة هذا المسعى؟ وهل ثمَّة بدائل نظرية تتجاوز هذا الانقسام؟
هل غلب على المفكِّرين الإسلاميين النظرُ إلى العلمانية بوصفها فلسفةً شاملةً؟ وكيف اشتبك هؤلاء المفكِّرون مع الرؤية الإسلامية؟ وهل عملوا على قراءة الإسلام بوصفه نقيضًا مفهوميًّا للعلمانية؟
5. العلمانية والديمقراطية
يهدف هذا المحور إلى تتبُّع الجدل حول اقتران العلمانية بالديمقراطية في الفضاءات الغربية والعربية والعالمية، ويهدف إلى رصد مسارات هذا الجدل وتحليلها في أعقاب ما عُرف بـ “الربيع العربي” وتفكيك نقاط الاستعصاء وتبيُّن أبعادها. وفي ضوء ذلك، نقترح الأسئلة البحثية التالية:
إذا كانت “الديمقراطية” مطلبًا توافقيًّا يُجمع عليه الفرقاء المختلفون، فهل يُمكن إقصاء “العلمانية” من النقاش السياسي بوصفها حقلًا خلافيًّا مشحونًا بذاكرةٍ سياسيةٍ مريرة؟
كيف جرى استدعاء مفهوم “الدولة المدنية” بوصفه خيارًا ثالثًا يُمكن الإجماع عليه؟ وكيف يُمكن تعريف هذا المفهوم وما يحيط به من تجاذباتٍ أيديولوجية؟ وما آفاق قدرته على توليد نوعٍ من الإجماع المتداخل؟
هل اقترنت الديمقراطية في الفضاء الغربي بالعلمانية حقًّا؟ أم إن عملية القراءة التاريخية بأثرٍ رجعيٍّ هي التي أحدثت هذا الاقتران؟ وكيف يُمكن في هذا السياق التمييزُ بين العَلْمنة بوصفها سيرورةً وبين العلمانية بوصفها فلسفةً سياسيةً؟
قبِلت العديد من حركات ما بعد الإسلام السياسي بالعلمانية الناعمة المتصالحة مع الدين، فما مآلات خطاب هذه الحركات وواقعها؟ وكيف يُمكن قراءة تجاربها من زاوية العلاقة بين الدين والعلمانية؟
6. العلمانية في عصر الشعبوية
يهدف هذا المحور إلى استشراف التحولات الوليدة في ظلِّ صعود حركات اليمين الشعبوي عالميًّا، وبروز أقطابٍ سياسية جديدة تدافع عن حقِّها في الاعتماد على تقاليد سياسية ثقافية غير غربية. وفي ضوء ذلك، نقترح الأسئلة البحثية التالية:
هل كان صعود الشعبوية وحركات اليمين الجديد نزوعًا طبيعيًّا كامنًا في الديمقراطية الليبرالية أم قطيعةً معها؟ وهل يُمكن قراءة مستقبل هذه الحركات بوصفها انحرافًا مؤقتًا عن المسار أم إنها تدشِّن تحوُّلًا عميقًا في التقاليد السياسية الغربية والعالمية؟
ما أبرز ملامح حضور الخطاب الديني في الحركات الشعبوية؟ وهل عادت الخلفية الدينية-الحضارية إلى التأثير في السياسات الدولية والداخلية بعد ما وُصف بتراجع العولمة في ظلِّ تراجع نظام القطب الواحد؟ وما حجم تأثيرها في نشاط هذه الحركات؟
تواريخ مهمَّة
- استقبال استمارة ملخص المشاركة إلى غاية 15/ 06/ 2021م
- الرد على أصحاب الملخصات المقبولة 01 / 07/ 2021م
- إرسال البحوث كاملة 15 / 9/ 2021م
- الرد على أصحاب البحوث المقبولة 15 / 10/ 2021م
أشكال المشاركة
- البحوث والدراسات من 4000 كلمة إلى 10000 كلمة.
- المقالات 3000 كلمة.
- ترجمة أوراق علمية أو مقالات رصينة تتناول الإشكالات المؤطرة في هذه الأرضية أو أحد محاورها، على أن يقدِّم الباحث نسخةً من المقال للمركز لإبداء الرأي فيها قبل الشروع في ترجمتها بعد إقرارها من المركز.
- ملاحظة: يشترط في جميع الأعمال المقدَّمة للمشاركة في الملف البحثي، أن تلتزم بالضوابط العلمية والأكاديمية المتعارَف عليها.
ترسل البحوث إلى البريد الإلكتروني: [email protected]
(المصدر: مركز نهوض للدراسات والبحوث)