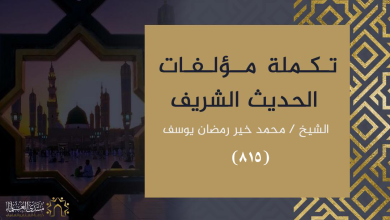دراسة الاجتهاد الفقهي بين الانقطاع والاستمرار: بحث في حكم تقليد المجتهد الميْت عند الأصوليين
إعداد أحمد غاوش
تُعالِج هذه الدراسة حكم تقليد المجتهد بعد موته ممّن جاء بعده، وهي مسألة أصولية تناولها بعض أهل الفقه في مصنّفاتهم الأصولية، فالتعرّض لهذه المسألة بالبحث؛ قديمًا وحديثًا، إمّا قليل نادر، وإمّا مختصر موجز. وللمسألة أبعاد وآثار في الفكر الفقهي المعاصر يلزم بيانها، لتسليط الضوء على الأفكار التي تكبِّل العقل الفقهي المسلِم، وتقعد به عن النهوض بواجب التجديد والاجتهاد؛ واستحداث القول فيما يُستجد على ساحة الأمة من قضايا ومسائل.
وتضمّن البحث عرضاً لمذاهب أهل الأصول والفقه في هذه المسألة؛ وفاقاً وخلافاً، من مختلف المدارس الإسلامية، بما في ذلك: ذكر أدلّة كلّ فريق على ما اختاره ونادى به من المعقول والمنقول، ومناقشة الأدلّة وتقويمها، والموازنة بينها.
مقدمة
كان الإعلان عن سدّ باب الاجتهاد، والإقرار بخلوّ الزمان من المجتهدينَ، وانقراض هذه الفئة من الأمّة؛ مآلاً مؤسِفًا انتهى إليه العقل الفقهي المسلِم بعد مسار طويل من التحوّلات المتتابعة، التي غلب على طابعها العامّ الانحدار بدلاً من الصعود، والانحطاط عوضًا عن الازدهار. ذلك أنّ التوجّهات الفكرية العامّة لأيّة أمّة، لا يُكتَب لها الذيوع والانتشار ثمّ الاستقرار، إلّا بتوافر جملة من الأفكار الصغرى الرافدة لها، التي تمدُّها بأسباب الحياة، وتُكسبُها ألوانًا من التبرير المنطقي، الذي يضمن لها القَبول من الجمهور على مرِّ العصور، واختلافِ البيئات والمجتمعات. وأحسب أنّ مسألة التقليد الفقهي لا تخرج عن هذا القانون الكلّي، فهي ليست توجّهًا فقهيًّا قام في الأمّة على حين غِرَّة من دون مقدّمات؛ إذ ليس من المعقول أن تُتلقّى بالقَبول دعوةٌ إلى التقليد في سياق فكري يطبعه الميل إلى التجديد، ويصبو أهله إلى الاجتهاد.
والحقّ أنّ البحث المدقِّق في ثنايا الفكر الأصولي يوصِل إلى القطع بأنَّ هناك منظومة متكاملة من الأفكار الخادمة للتقليد، القاطعةِ أسبابَ الاجتهاد، الداعمةِ خياراتِ الاتّباع السلبي بلا استدلال.
ولعلّ من بين أهم تلك الأفكار التي يصدق عليها هذا الوصف، ما تبنّاه بعض أهل الأصول والفقه، من قول يقضي بعدم اشتراط الحياة في المجتهد ليصحّ تقليده، وهي فكرة يبدو أنّها لم تظهر في الفكر الأصولي إلّا بعد ترسيم المذاهب الفقهية المتبعة، ووفاة الأئمة المشهورين؛ ذلك أنّ القول بصحة تقليدهم متفرّع على جواز تقليد الميت وصحته شرعًا، فقد نَصّ النووي على أنّ تقليد العوام للأئمة المجتهدينَ، وانتسابهم إليهم متفرّع على جواز تقليد الميْت، قال: “المنسوب إلى مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، ثلاثة أصناف؛ أحدها: العوام، وتقليدهم الشافعي مثلا، مفرع على تقليد الميت….”
فكان من لواحق ذلك أنْ ظهرت في الفكر الأصولي مذاهبُ وآراء تخدم الاتجاه العامّ الهادف إلى تكريس الاتّباع من غير دليل، والتضييق على استحداث الأقوال والمذاهب بعد حصرها في عدد مُحدَّد. وبذا، تتجلّى أهمية هذه الفكرة وخطورتها في تمثيلها العماد الرئيس لمسألة التقليد، فبقبولها يستمر التقليد إلى ما لا نهاية، وبرفضها يُفتح من جديد بابُ الاجتهاد الفقهي واسعًا، وعلى نحوٍ متواصل مستمر؛ لأنّه سيصير -آنئذٍ- ضرورة شرعية لا مندوحة عنها، وتغدو ذمّة الأمّة جمعاء عامرة، لا تبرأ إلّا بإقامة الفريضة بوجود مجتهدينَ كاملينَ في كلّ وقت، يضطلعون بمهام النظر الفقهي المتجدّد في قضايا الناس ونوازلهم.
أولاً: مواقف الأصوليين من تقليد الميْت
ظلّ الاجتهاد منذ زمن النبي إلى نهاية عصر الأئمة الفقهاء، منصبًّا قائمًا في الأمّة، وصفة ملازمة لكثير من علمائها، ولم تكن قد ظهرت بعدُ تلك الشروط المتشدِّدة المطلوبة في المجتهد، ممّا يفسِّر الظهور المتقارب والمتزامن للمجتهدينَ في ذلك العصر. فلم يكن الناس بحاجة إلى إثارة تساؤل تقليد الأموات؛ نظرًا لتوفر الأحياء وقربهم من المجتمع وقضاياه، يُستفتون فيَفتون، ويُسألون فيجيبون؛ ذلك أنّ الحكم الذي كان متعارفًا عليه، هو وجوب الاجتهاد على أهله، وتحريم التقليد عليهم.
ثمّ لم يلبث الوضع أنْ تغيَّر كلّيةً بتأثير عوامل سياسية واجتماعية وثقافية سهَّلت على الجمهور القَبول بفكرة انتهاء عصر الاجتهاد، فلم يبقَ من مسلّم له بالصفة، ومعترَف بأهليته، إلّا مَن مضى مِن الفقهاء وأهل العلم، عندئذٍ، يٌثار السؤال الآتي: ما حكم تقليد هؤلاء وقد انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء؟
اختلف الأصوليون والفقهاء في مسألة جواز تقليد المجتهد الميت على عدد من الأقوال والمذاهب، ترجع كلّها بعد التأمّل إلى مذهبيْنِ رئيسيْنِ، هما:
المذهب الأول: جواز تقليد المجتهد الميْت
وهو مذهب طائفة من أهل الفقه والأصول رأوا جوازَ الأخذ بقول الميْت، وتقليده في اجتهاده حتى بعد موته ممّن جاء بعده، وقد عَدّ ابنُ الصلاح هذا المذهب هو الأرجح؛ لأنّه –بنظره- الصحيح من مذهبيْنِ اثنيْنِ حكاهما، قال: “في جواز تقليد الميت وجهان: أحدهما لا يجوز؛ لأن أهليته زالت لموته فهو كما لو فسق، والصحيح الذي عليه العمل الجواز.”
والوجهان المذكوران يُقصَد بهما القولان المنقولان عن فقهاء الشافعية، ومثلهما عن أصحاب الإمام أحمد، فأولهما: التجويز مطلقًا؛ لأنّ المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا ذهبوا إلى الاعتداد بآراء المجتهدينَ الأموات في مسائل الإجماع والخلاف الواقعة بعدهم.
وثانيهما: المنع منه، لكنّ في الأمر تفصيلاً خلاصته: تقييد الجواز بكون هذا التقليد واقعًا في الأعصار المتأخرة، وهي الموصوفة بفقدان المجتهدينَ.
ونقل النووي هذا الخلاف في “الروضة”، ثمّ سكت عنه، بل حكاه في “آداب الفتوى”، فصرَّح بأنّه الصحيح من مذهبيْنِ، واستضعف مذهب المنع مُستدِلّاً بحُجَّة انعدام المجتهدينَ في مثل عصره، قال: “وفي جواز تقليد الميت وجهان: الصحيح جوازه؛ (…) والثاني: لا يجوز؛ لفوات أهليته كالفاسق، وهذا ضعيف، لا سيما في هذه الأعصار.”
ونسب بعضهم مذهب تجويز تقليد الموتى من المجتهدينَ إلى جمهور العلماء، بل بالغ بعضهم فحكى الإجماع عليه، وزعم أنّ ثبوته أمر لا خفاء فيه؛ “إذ لم ينقل عن أحد من أهل العلم بعد استقرار المذاهب المفتى بها إنكاره.” وفي ذلك يقول الزركشي: “واحتج الأصوليون عليه بانعقاد الإجماع في زماننا، على جواز العمل بفتاوى الموتى، والإجماع حجة.”
وهي دعوى يدل على بطلانها الواضح ما نقلناه آنفًا من إقرار أهل التجويز بوجود مذهبيْنِ لأهل العلم، وبما سيأتي من عرضٍ لأوجه الخلاف في هذه المسألة، التي أوردها العلماء المعتبرون.
وبالمذهب المذكور جزم الحطاب الرعيني، فقال: “يجوز تقليد الميت على الصحيح، وعليه عمل الناس، ولو وجد مجتهد حي.”
وواضح هنا أنّه يربط أرجحية هذا القول بكونه ما جرى عليه العمل في المذهب، وإلّا فإنّ بعض أعلام المالكية قد قالوا إنّ المشهور من الأقوال، هو عدم جواز تقليد الميْت كما نَصّ عليه البرزلي وابن ناجي في شرح الرسالة، بل حكى هذا الأخير الإجماع على ذلك ولم يعترض عليه.
إلّا أنّ المتتبع أقوالَ علماء المذهب المالكي، ولا سيّما في الأعصار المتأخرة، يلحظ أنّ الاتجاه إلى منع تقليد الميْت، أخذ يتقلّص ويتوارى إلى أنْ شارف على الزوال والاضمحلال، في مقابل ظهور القول المقابل، واشتهاره، ودفاع العلماء عنه، فلا غرو أنْ يدّعي ابن عرفة إجماعًا مقابلاً نسبه إلى أهل زمانه، وعلَّله بفقد المجتهد وانعدامه، قال: “انعقد الإجماع في زماننا على تقليد المجتهد الميت؛ إذ لا مجتهد فيه.”
المذهب الثاني: منع تقليد المجتهدينَ الموتى
أفاد أصحاب هذا المذهب بعدم جواز تقليد الميْت، أو الأخذ بمذاهب الموتى من الفقهاء، وإليه ذهبت طائفة من أكابر أهل الأصول، كما جعله بعضهم مذهب الأكثرينَ…، أشهرهم: الجويني، والباقلاني كما يُفهَم من عبارته: “من قلّد فلا يقلّد إلا الحي، ولا يجوز تقليد الميت،” وأبو حامد الغزالي، والعز بن عبد السلام اللذان قالا: “يجب تقليد مجتهد العصر، ولا يجوز تقليد الميت.” بل يستغنى عنه بالمجتهد الحيّ من أهل عصره.
يُذكَر أنّ الرازي نصر هذا المنحى واحتج له في “المحصول”، وصرَّح بأنّ الميْت لا قول له في ما يستجد بعدَه.
وقد نقل عدد من الأصوليينَ المتقدّمينَ والمتأخرينَ الإجماعَ على هذا الرأي، وفي طليعتهم: الغزالي، ثمّ الصنعاني. ونقل الشوكاني عن ابن الوزير إجماع سائر علماء المسلمين عليه.
فإذا اعتُرِض عليهم في دعوى الإجماع بالقول الأول، وهو مذهب التجويز، قالوا إنّه محمول على عدم مجتهد العصر، فيكون تقليد الميْت على هذا نوعًا من الضرورات التي تقدَّر بقدرها، ويحكَم بارتكابها إذا ترجَّح الظنّ بأنّ مصلحة تقليد الإمام الميْت، والأخذ بما حَكم به، خيرٌ من “ترك الناس هملاً،” وأنّ الوقوع في التقليد، ولا سيّما إذا كان لأهل العلم والفضل، خيرٌ من تضييع الشريعة جملة واحدة.
فيتقيّد الرأي الأول بما إذا لم يكن مِن بين أهل العصر مَن يستحق رتبة الاجتهاد والنظر في النوازل والقضايا، لا في حال وجوده، وتمكّنه من الاستنباط والإعلان عن مقتضى اجتهاده… .
وإلى هذا التوجيه يرجع ما يمكن اعتباره قولاً ثالثًا في المسألة؛ وهو ما اختاره جماعة من العلماء من قول يوهِم ظاهره أنّهم من أصحاب التجويز. ولكن، عند التأمّل والتدقيق يظهر أنّهم إنّما يختارونه في حال عدم وجود المجتهد: “والصحيح أنه يرجع إليه عند الحاجة والعجز عما فوقه؛ فإذا صح نقلٌ كتابيٌّ عمّن سلف من أهل العلم، ورواه عنه ثقة ثم نـزلت به نازلة في بادية وعسر عليه الوصول إلى مواطن الفقهاء وخاف فوات النازلة (…) فإنه يعمل بما يجده في كتاب المصحح، وإن قلّد ميتا فهو أولى من اتباع هواه بغير علم; لأن ما يجده في صحيفته أصل، وما قيل بعلم فهو أولى من اتباع الهوى.”
لذا، فقد قيّدوه بالأعصار المتأخرة على اعتبار أنّها مظنّة عدم توفر المجتهدينَ خلافًا للأعصار المتقدمة.
ونقِل في المسألة قول رابع فيه نوع من التفصيل، حاصله أنّ هذا النوع من التقليد إنّما يجوز لطائفة من الفقهاء الذين يلقَّبون بفقهاء المذاهب؛ وهم النظّار القادرون على إدراك أدلّة أقوال الإمام على نحوٍ يمكنهم به الدفاع عنها في مجالس المناظرة مع المخالفينَ، والجدل مع الخصوم، فإذا كانوا عاجزينَ عن هذا القدر منِعوا من حكاية مذاهب الأموات.
وبتأمّل هذا القول يظهر أنّه آيل بالضرورة إلى مذهب المنع، ألا ترى أنّ هذا الفقيه بالوصف المذكور لم يُعِد حكاية مذهب الإمام، إلّا بعد تجديده النظر في الأدلّة المعتمدة أول الأمر لبناء الفتوى، والفحص المستأنف لأدلّة الخصوم، والإجابة عن الاعتراضات، وإبطال ما يمكن أن يوجَّه إلى القول المفتى به من الإلزامات والإيرادات. فمَن كان هذا شأنه لا يقال فيه إنّه مقلِّد، بل هو مجتهد؛ لخروجه عن دائرة التقليد وتعريفه، وغاية ما هنالك أنّه وافق الإمام في فتواه ورأيه، لا عن تقليد وتسليم، بل عن نظر واستدلال.
وبذا، فقد خلصت الدراسة إلى أنّ القول الأصولي في حكم تقليد الميْت مختلفٌ فيه على مذهبيْنِ، مع بعض التفصيل عند قوم من هؤلاء وأولئك.
حكم تقليد الميْت عند الإمامية
يتسامح بعضهم فيزعم أنّ تحريم تقليد المجتهد الميْت أمر مجمَع عليه عند الشيعة الإمامية، ويضيفون أنّ اعتبار الحياة في حُجّية قول المجتهد هو كالضروري من أصول مذهبهم التي يمتاز بها من غيره، ولا يغفلون أيضًا -في هذا السياق- عن بيان أثر جملة من الآثار الطيبة لهذا الاختيار في الفقه الإمامي، ومن جملة ذلك: “أثره الفاعل في بث الحيوية والروح في الفقه الشيعي ومن ثم نموه وازدهاره، ليبقى في مأمن من التأثر بمجمل التغيرات العالمية، وبالتالي حيازته المكانة اللائقة به في العصر الحديث، بما ينطوي عليه من قوانين تلبي متطلبات الإنسان في الحياة المعاصرة.”
ونحن لا نجادل في الأثر، لكونه صحيحًا، لو ثبت المؤثّر، وكان قول هذه المدرسة فيه متفقًا موحّدًا، إلّا أنّ التحقيق يقضي بأنّ الأمر على خلاف ذلك. فعلى أقلّ الأقوال الحاكية لمواقف أصولييهم في هذه المسألة، هناك خلاف شهير محفوظ بين مدرستين كبيرتين، هما: مدرسة الأصوليين التي ترى المنع منه، ومدرسة الإخباريين التي تذهب إلى تجويز تقليد الأموات، قال محسن الحكيم: “اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي، والمعروف بين الأصحاب الاشتراط، وبين العامة عدمه، وهو خيرة الإخباريين وبعض المجتهدين من أصحابنا.”
وقد رجّح بعض أصوليي الشيعة مذهب الجواز، وبالغ في الاستدلال له عقلاً ونقلاً، وكان ممّا استُدِلّ به أنّ موضوع الحُجّية هو ما كان قولاً لمَن هو من أهل الخبرة ولم يرجع عنه، من غير اشتراط بقاء حياته أو بقاء سلامته، فهذا القول المنقول عنه قد كان مذهبًا له عندما كان حيًّا أو سليمًا، فإذا مات أو مرض وقع الشكّ في بقاء الحُجّية في قوله: هل هي كما كانت أو لا؟ فكان المقتضى تطبيق قاعدة استصحاب بقاء ما كان على ما كان؛ أي استمرار حُجّية قول المجتهد، فيُستنتَج من هذا البناء العقلي أنّ الأصول العملية والأدلّة الاجتهادية دالّة على جواز تقليد الميْت كالحيّ.
وأمّا دعوى الإجماع فينقضها شيئان؛ أولهما: ما ورد من الاختلاف المنبَّه عليه قبلاً. وثانيهما: عدم ذيوع مذهب المنع إلّا عند المتأخرينَ من علماء الإمامية، وذاك ما يُفسِّر سكوت المتقدمينَ عن ذكرها في كتبهم. ويضاف إلى هذا أنّ فقهاءهم ألَّفوا كتبًا ورسائل في الاتجاهيْنِ معًا؛ منها ما انتصر لهذا القول، ومنها ما انتصر للقول المقابل؛ ممّا يُستدَلّ به على أنّ المسألة لم تكن إجماعية قطّ.
وتأسيسًا على ما سبق، يمكن التصريح بأنّ أئمة الشيعة الإمامية يختلفون في تقليد الميْت اختلافًا قريبًا من اختلاف أهل السنّة، وأنّ منهم المجيز والمانع كمثل الجمهور، ولا ينفصلون عنهم إلّا من جهتين، هما:
1. أغلب متأخريهم من العلماء مالوا إلى المنع من تقليد المجتهد بعد موته، وصار هذا القول مستفيضًا بينهم استفاضة منعت ظهور خلاف ظاهر فيه فادُّعِي الإجماع عليه، قال القمي: “إن تقليد الميت ابتداء قد اشتهر المنع عنه في كلام الأصحاب، بل نقل الإجماع على عدم جوازه في كلام جمع كثير من المتأخرين.”
2. أصوليو الإمامية كانوا أكثر اعتناء بهذه المسألة؛ بحثًا وتفريعًا، فدرسوا ضمنها قضايا من قبيل:
– هل يجوز تقليد الميْت ابتداء؟
– هل يتوقّف مقلِّد المجتهد عن تقليد مرجعه بعد وفاته أو يستمر عليه؟
– هل تُعَدّ الحياة أحدَ الشروط المعتبرة في المجتهد؟
إلى غير ذلك من الأسئلة التي أملتها طبيعة الممارسة الفقهية عندهم وخصائصها، وفي مقدمة ذلك إلزامهم عموم المكلّفينَ باتخاذ مرجع في الفقه يُستفتى ويُستشار في النوازل، ويُؤخذ بقوله المعين في مختلف النوازل.
ثانيًا: أدلّة المذهبيْنِ في مسألة تقليد الأموات
حاول كلٌّ من الفريقيْنِ تقوية ما اختاره من رأي في هذه القضية الأصولية بجملة من الأدلّة، تتنوّع بين ما هو من قبيل المعقول، وما هو من جهة المنقول. وسنستعرض فيما يأتي أدلّة كلا الفريقيْنِ، ثمّ نناقشها على ضوء ما التزمه كلّ طرف من طرائق الحِجاج، ووسائل الدفاع عن المذهب.
1. أدلّة مذهب الجواز:
– الأدلّة العقلية:
استدل هذا الفريق بحجج عقلية حاصلها ما يأتي:
أ. وقوعه على مرّ الأعصار بلا إنكار. فالأمّة قد استقرَّ أمرُها من أزمان غابرة على تقليد الأموات من المجتهدينَ، واعتبار آرائهم بعد مماتهم كما كانت معتبرة في حياتهم. وما تقليد أئمة المذاهب إلّا نوع من هذا، وضرب واضح منه، فكيف يُمْنَع والواقع يشهد بأنّ ذلك جائز، فإنّ الوقوع أبلغ في الجواز وأكثر، قال الصنعاني: “واستُدل للجواز بالوقوع، بلا نكير؛ فكان إجماعاً. بيان ذلك أنَّ الأمة في كل قطر عاملة بمذاهب الأئمة كالهادي، والناصر، والفقهاء الأربعة.”
وظاهر عبارته أنّ هذا الوقوع الحاصل من الأمّة يُعَدّ بمثابة الإجماع على الأمر، وادّعاء الإجماع في هذا الموطن مدخول من الناحية المنهجية فلا يسلم، بسبب افتقاده للشروط المطلوبة في الإجماع؛ إذ يقرِّر الأصوليون أنّ الاجتماع على الرأي لا يُعَدّ إجماعًا شرعيًّا، ومنتجًا للحُجّية إلّا إذا كان المجمعون أولاً من أهل الاجتهاد؛ إذ “من شرط الإجماع اتفاق المجتهدين، فمن لم يكن من المجتهدين فهو من المقلدين؛ لأنه لا واسطة بينهما، فعلى هذا لا يعتدُّ بقوله، ولا بخلافه.”
وعملاً بهذا الشرط ألغى أهل الأصول خلاف مَن لم يحصل الرتبة؛ سواء أكان عامّيًّا لا فقه عنده، أم طالب فقه غير محصلٍ لقواعد الاجتهاد، ولا مستقلٍّ بالنظر والاستدلال؛ فكلاهما يشترك في معنى واحد على رأي الجمهور، قال الطوفي: “… وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، فهو إما غير مكلف، كالصبي والمجنون، فلا تعتبر موافقته قطعا، أو يكون مكلفا كالعامة، ويلحق بهم طلبة الفقهاء الذين لم يبلغوا رتبة النظر والاستدلال الاجتهادي، فهؤلاء لا يعتبر قولهم عند الأكثرين من الأصوليين.”
وقد عرَّف ابن الحاجب الإجماع بقوله: “اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.” ولا ريب أنّ الظاهر من العبارة أنّه -كغيره من المعرّفين- يشترط توفر صفة الاجتهاد في الذين وقع منهم الإجماع؛ لكي يكون إجماعهم معتبراً.
وقد تنبّه السبكي للتناقض الواقع في دعوى الإجماع على الجواز، فقال بعد أن عرض ما استدل به المدافعون عن ذلك: “… ولقائل أن يقول: لا يجامع قولك: ليس في هذا الزمان مجتهد قولك إجماع أهل الزمان حجة؛ لأن الإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين.”
ب. قياس اجتهاد الميْت على خبره وشهادته في عدم اعتبار الحياة، وبقاء حُجّية ما أخبر به، وصدق ما شهد به حتى بعد وفاته. فكما أنّ الشهادة والخبر لا يَبطلان بمجرّد وفاة مؤدّيهما، بل يقع الحكم بالأولى، والاحتجاج بالثانية من غير التفات إلى حياة أو موت، فكذلك الحال في اجتهاد الميْت ورأيه.
ت. الأصل عدم الخطأ، وعدم الرجوع عمّا توصّل إليه المجتهد، وأفتى به؛ ذلك أنّ المجتهد (الأهل للفتوى والنظر) قد بذل من الجهد، واستفرغ من الطاقة وسْعه قبل إصدار الحكم، ما كان سببًا كافيًا لقَبول قوله، ووجوب العمل بما وصل إليه اجتهاده في حقّ نفسه، وفي حقّ مَن رضي بتقليده. ومتى صحّ الأخذ عنه أول مرّة يبقي الحال على ذلك إلى أن يثبت العكس، ولا يسوّغ ترك فتواه لشيء متوقّع غير متحقّق؛ لأنّ المقرّر في القواعد الأصولية هو أنّ “انعقاد الأسباب الشرعية لا يمنع من إعمالها، توقعُ موانعها.”
ث. المذاهب لا تموت بموت أصحابها؛ نُقِل هذا القول في أكثر من مصدر منسوبًا إلى الإمام الشافعي، وعُدَّ من عباراته الرشيقة، وحاصله أنّ مَن قال قولاً، ثمّ مات، فحكمُ قوله باقٍ في الزمن الذي بعده، ورأيه ملحوظ ومُعتبَر عند مَن جاء بعده؛ لأنّ المذاهب لا تموت بموت أصحابها، بل يُعتَدُّ بأقوالهم واجتهاداتهم بعدهم؛ في الإجماع والخلاف. فكأنّ الفقهاء المنقرضينَ أحياء بعلومهم، ذابّون عن مذاهبهم بما خلَّفوه وراءهم من الفقه المنتشِر بين الناس، والمدوَّن في الكتب والمصنّفات.
ج. اختيار مذهب الأخذ بتقليد الأموات من الفقهاء، هو من باب الترخّص للاضطرار؛ لأنّ الناس لا يكفّون عن الاختلاف فيما بينهم، وعن طلب الحكم الشرعي في ما يَحلّ بهم من النوازل والأقضية، من غير التفات إلى كون مجتهد الوقت موجودًا أو معدومًا، ولا انتظار لتوافر الشروط المقرِّرة لاعتباره وأهليته، ولو لم نجوِّز لهم التقليد لما هو ميسور من اجتهادات الفقهاء الماضينَ، لوقعوا في دائرة الفراغ التشريعي، ولأدّى ذلك إلى فساد أحوال الناس، واضطراب أمورهم.
ح. القول بالمنع؛ أي إنّ منع الأمّة من تقليد الأموات، هو افتراض نظري لا أثر له في الواقع. فالقائلون بذلك يقرِّرون هذا المبدأ في الكتب، ويدافعون عنه في المناظرات، ثمّ يعملون بخلافه في الفروع العملية، ولذلك عَدَّ ابن القيّم مذهبَ مَن قال بالمنع شيئًا من باب النظر الذي يناقضه العمل، ولا يرى له أثر في التطبيق الفقهي، حتى ممّن تزعَّم القول به ونصره، قال: “ومن منع منهم تقليد الميت، فإنما هو شيء يقوله بلسانه، وعملُه في فتاويه وأحكامه بخلافه.”
– الأدلّة النقلية:
وأمّا من جهة المنقول والمأثور فقد احتجوا بمرويات أدلّها على الدعوى، وأخصّها بموضوع النـزاع، ما روي عن ابن مسعود أنّه قال: “ألا لا يقلِّدن رجل رجلا دينه، إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإن كان مقلداً لا محالة، فليقلد الميت ويترك الحي، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة.”
وموضع الاستدلال منه -إن سلّم بصحته وحُجّيته- شطره الأخير الذي يدعو فيه إلى تقليد الميْت، ويحثّ عليه، ويفضِّله على تقليد الحيّ؛ لكون هذا أَأْمن من الفتنة، وأبعد عنها؛ لانقطاعه عن الدنيا، وهي دار التقلّب والتحوّل والتغيّر من حال إلى حال.
واستدلوا أيضًا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: “اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر.” وبما يروى عنه من حديث، وفيه: “إنما أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم.”
ووجه الاستدلال فيهما أنّ هذا خطاب إلى الأمّة من الزمن النبوي إلى حين قيام الساعة، مفاده التوجيه إلى الاقتداء بالصحابة جميعًا، أو بالخليفتيْنِ الراشديْنِ الأوليْنِ، وذلك يستلزم ضرورة حدوث هذا التقليد بعد موت الصحابة، انطلاقًا من عصر ما بعد التابعينَ، فكان الأمر النبوي مقترنًا بهذا اللازم، دالّاً على جواز تقليد المجتهد الميْت.
2. أدلّة مذهب المنع:
أمّا الفريق الثاني فقد ردّ أدلّة هذا الفريق، وزيف براهينه وحججه، ببيان عدم كفايتها المنطقية في الاستدلال، كما لم يسلِّم بصحة ما أورده من الخبر والأثر؛ روايةً ودرايةً، واستدل -في المقابل- على تدعيم وجهة نظره بعدد من الحجج والدلائل من منقول الشرع ومعقوله، وفي ما يأتي بيانٌ لذلك.
أ. الحجج المعقولة للمانعينَ:
من الحجج المعقولة التي كانت عمدة المانعينَ في إثبات دعواهم ما يأتي:
• لا قول للمجتهد بعد موته: وهذه أول الحجج التي رفعها الرازي في “المحصول”، واستدل بها على كون الإجماع “لا ينعقد مع خلافه حيّاً وينعقد مع موته، وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد موته.” فكيف يجوز تقليده بعد موته، وهو لم يعد لقوله اعتبار في مسائل الإجماع كما كان له في الحياة؟
• الفتوى والاجتهاد يختلفان عن الخبر والشهادة، ومن ثَمّ لا يجوز القياس بينهما لما عُلِم في أوليات مبحث القياس عند أهل الأصول؛ من منع إجراء القياس مع المخالفة وعدم المساواة، فإنّهم يقولون لا قياس مع الفارق، والفارق هنا كبير جدًّا، يتمثَّل في أنّ المخبر والشاهد يخبران عن أشياء ملموسة مدركة بالحواس، لا دور لتغيّر الزمان في اختلافها، بخلاف المجتهد، فإنّه يبني أحكامه على “مقدمات نظرية، وهي تختلف باختلاف خبرة المفتين بأصول الاستنباط، ومقدار ما يملكون من ذكاء وصبر على البحث، بل تختلف باختلاف المراحل العلمية التي يجتازها المفتي الواحد.”
• موت المجتهد مُسقِطٌ لأهليته؛ وحاصل هذه الحُجّة أنّ المجتهد -إبّان حياته- كان مؤهّلاً للنطق عن الشارع بحكم ما يعرض عليه من النوازل والقضايا، عبر استقصاء الأدلّة، وإعمال العقل، وتجديد النظر، وهذه كلّها أمور لم تعد في إمكانه بعد موته قطعًا، فلم يسغ تقليده لفوات أهليته من هذا الوجه، قياسًا على سقوط شهادة الشاهد بعد ثبوت فسقه، وانخرام عدالته، علمًا بأنّها كانت مقبولة من قبل.
• بقاء الوصف بعد زوال الأصل محال؛ أي إنّ قول المجتهد هو وصف مقترن بأصل كان موجودًا، ثمّ انتفى؛ وهو حياة المجتهد. فلولا وجود هذا الأصل لما كان هناك وصف من الأساس. ولأنّ المسبّبات منوطة بأسبابها؛ وجودًا وعدمًا؛ فإنّ الوصف (القول) يَبطل بزوال الأصل (الحياة)؛ تبعًا ولزومًا. قال الزركشي: “… لأن قوله وصفه، وبقاء الوصف مع زوال الأصل محال.”
• تقليد المجتهد بعد موته إمّا أن يكون وهمًا، وإمّا أن يكون تردُّدًا؛ فإنّه لو كان حيًّا للزمه تجديد النظر لتجدُّد النازلة، وبدهي أنّ تجديده النظرَ والاستدلال قد ينتج منه تغيير لقوله، فإن حصل منه ذلك كان التمسُّك بقوله الأول تمسُّكًا بالوهم والخطأ في أبعد الاحتماليْنِ، أو بالتردُّد والشكّ في أقربهما، وكلّ ذلك غير جائز في دين الله.
ومَن يطالع تاريخ الفقه الإسلامي ومراحل تطوّر المذاهب الفقهية يقف على الكمّ الهائل من الأقوال التي انتقل عنها الأئمة، والآراء التي غيّروها بسبب تغيُّر العوامل المؤثِّرة في الاجتهادات؛ سواء أكانت معرفية أم واقعية. ويكفيك دليلاً على هذا أنّ الإمام الشافعي كان له مذهب قديم في مسائل الأصول والفروع، وله فيه كتب مدوَّنة، وإملاءات مروية، وأصحاب معروفون معيّنون، ثمّ انتقل عن ذلك كلّه إلى مذهب جديد، تخلّى فيه عن مسائله القديمة إلّا نـزرًا يسيرًا جدًّا منها، ينصّ الشافعيون على أنّه لا يتجاوز العشرين مسألة من مجموع الأبواب الفقهية على رأي مَن استكثر منهم، ولا يعدو ثلاثًا فقط على رأي الجويني.
ب. الاستدلال النقلي للمانعينَ:
ينتهض الاستدلال النقلي لهذا الفريق على دعامتين؛ أولاهما تتألّف من أدلّة نقلية مثبتة للقضية، ومشيرة إلى منع دعوى الفريق المجيز؛ تصريحًا أو إشارةً. وثانيتهما تقوم على عنصر النقض لأدلّة الخصوم من الأحاديث والآثار.
فمن الضرب الأول ما أخرجه الشيخان عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: “إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.”
ووجه الدليل فيه أنّه يقتضي ضرورة أن يكون أهل الزمان الخالي من العلماء ضالّين، بحيث يستوي في هذا الوصف الشرعي المفتي منهم والمستفتي، وتصدُّر بعضهم للفتوى لا يسقِط عنه الصفة كما هو بيِّن من اللفظ الصريح الصحيح؛ لأنّه تصدُّر من غير أهلية، ولا قدرة على النظر والتصرّف في الأدلة، “ولا شك أن المفتي المقلِّد لا يسمى عالماً؛ فدل هذا على أن التقليد لو كان يقوم مقام العلم ما استحق المفتي أن يسمى مُضِلاً والمستفتي مُضَلاً، وقد سمّاهما بذلك في الحديث الصحيح.”
ولو اتفقت الأمة جمعاء على ترك الاجتهاد وسلَّمت بالتقليد، وركنت إلى فكرة خلوّ الزمان من المجتهد، لكانت بذلك متواطئة على الضَّلال. وفي ذلك يقول الأصفهاني في بيان المختصر: “الاجتهاد فرض كفاية، فيستلزم انتفاؤه في عصر من الأعصار اتفاق المسلمين على الباطل; لأنه إذا انتفى الاجتهاد في عصر تكون الأمة في هذا العصر متفقين على ترك الواجب، وهو باطل.”
ومعلوم أنّ القائل من الفقهاء والأصوليين بتقليد الموتى في فتاويهم، إنّما استدعاه لذلك، وسوّغه في نظره، الزعمُ بعدم إمكان وجود المجتهد في متأخر الأعصار، والمجتهد هو العالِم بحقّ، فكان هذا الحديث دالًّاً -من طريق الإشارة- على أنّ من واجب الأمة السعي -حسب ما تستطيع- إلى تجنّب العيش في ظلّ هذا الواقع الذي ينقرض فيه العلم بذهاب العلماء. وبناءً على ذلك رأى بعضهم تأويل الحديث بآخر الزمان، فقال: “الحديث محمول على وقت مخصوص لم يأت بعد، وهو بعد نـزول عيسى -عليه السلام- وموته وموت المهدي المبشر به، وذلك مبين في أحاديث صحيحة، وقد ورد في الصحيح: “لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال،” وهذا يفسر ذاك، لأنه خاص وذلك عام، ولا يمكن أن يكون ذلك الضلال العام مع وجود هذه الطائفة الموصوفة بالظهور على الحق، فدلَّ على أنه بعد انقراض هذه الطائفة.”
ولعل من المناسب تعزيز هذا الوجه من الحِجاج بإشارات وردت في النصوص الشرعية، يفهَم منها بطريق الإشارة والتنبيه الدليل على هذا المذهب، فمن هذا القبيل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (التوبة: 122).
فقد أوجبت الآية على الأمّة التفقّه في دينها، وإقامة الأسباب الموصلة إلى معرفة أحكام شريعتها عن طريق طائفة معيّنة، تنتصب بينها على مرّ الأزمنة واختلاف الأمكنة، وتقوم فيها مقام الأنبياء مع أقوامهم “منذرين ومحذرين، دعاة إلى الله تعالى، قائمين بدينه باثّين سبيله، موضحين للخلق نهجه، فصار الفقهاء خلفاء الرسل إنذاراً وتحذيراً، وارثي علومهم قياماً به وحملا، سالكي طريقتهم بثاً ونشرا.”
وظاهر الأمر أنّ هذه الوظيفة النبوية لا قيام لها على النحو الكامل إلّا مع توفر عنصر الحياة في الفقيه، ليتمكّن به من النذارة الفعلية المباشرة، والقيام بين الناس تعليمًا وتفقيهًا، وخلافة النبي في أمّته تحذيرًا وإنذارًا، ولا يتحقّق هذا مع الفقيه الميْت إلّا بارتكاب تأويل بعيد لا يساعد عليه ظاهر النصّ، ولا ترشد إليه ألفاظه.
3. نقض الاستدلال النقلي للخصوم:
يمكن الردّ على ما استدل به الفريق الأول من الأخبار والآثار، من الوجوه الآتية:
أ. خبر ابن مسعود مردود لعلّتين اثنتين؛ أولاهما تتعلّق بالسند، وثانيتهما تتعلّق بالمتن.
وعلّة سند هذا الأثر داخلة عليه من جهة الجهالة في إحدى حلقات سنده، ثمّ من جهة الانقطاع الواقع بين ابن أبي لبابة وابن مسعود. قال أبو محمد ابن حزم: “ابن وهب لم يسمِّ من أخبره، ولا لقي عبدة ابن أبي لبابة ابن مسعود.” فكان بذلك أثرًا ضعيفًا لا ينهض به احتجاج في موازين نقد الأخبار.
وعلّة المتن هي أنّ فيه معنًى سقيمًا لا ترتضيه ظواهر الشرع، وقواعد الدين؛ هو اعتبار كلّ مَن مات على شيء مستحقًّا للتقليد، ومحكومًا له بالأمن من الفتنة من دون اعتبار للأدلّة، وهذا “كلام فاسد؛ لأن الميت أيضا لا تؤمن عليه الفتنة إذا أفتى بما أفتى، ولا فرق بينه وبين الحي في هذا.”
يضاف إلى هذا أنّ الثبات على القول ليس ميزة تحسَب في ميزان حسنات مَن اتصف بها؛ لأنّ المرجع في قبول الأقوال أو ردّها لا يكمن في مدى رجوع أصحابها عنها، أو ثباتهم عليها، بل في مدى الصحة والقوة والموافقة للشَّرع. والأكيد الذي لا امتراء فيه، هو أنّ الرجوع عن القول الباطل المعارض للدليل خير من الثبات على الخطأ، وعلى هذا كان عمل السلف من الصحابة والعلماء الأعلام من هذه الأمّة.
ب. أمّا الخبران الآخران فلا متمسّك لهم فيهما. فأمّا الأول فإنّه خارج عن موضع النـزاع؛ لأنّه يتحدث عن معيّنيْنِ بالاسم، هما أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-، وهذا أخصّ بكثير من محل البحث؛ فإنّ النـزاع دائر حول جواز الاقتداء بعموم المجتهدينَ حال الوفاة، وذاك أعمّ من خصوص أمره -عليه الصلاة والسلام- باقتفاء سنّة الخليفتيْنِ الراشديْنِ، والاقتداء بهما.
ولهذا الملحظ وجدنا الأصوليين يستدلون بهذا الخبر على مسائل من بحثهم، فيها هذا الجانب من التخصيص بالشيخين من قبيل:
– هل ينعقد إجماع الشيخين أبي بكر وعمر مع مخالفة غيرهما لهما؟
– هل يكون الترجيح في الاختلاف بقولهما على قول غيرهما؟
– هل مذهب الصحابي حُجَّة مطلقًا، أو أنّ الحُجَّة محصورة في قول أبي بكر وعمر خاصة؟
ثمّ إنّه خبر لا يقتضي بأيّ حال الاقتداء بهما حال وفاتهما، بل ظاهره الدلالة على أنّ ذلك مقصور على أمرهما في حياتهما، فمن أين يا ترى فَهِمَ المستدلُّ بالخبر الأمرَ بالاقتداء بعد الموت؟ أفي اللفظ ما يساعد على ذلك، أم هو التأويل البعيد والدعاوى المطلقة؟
وممّا يزيد الاستدلال بهذين الحديثين ضعفًا أنّ الشيخين -رضي الله عنهما- قد اختلفا فيما بينهما في مسائل مشهورة بين أهل العلم، ووقعت منهما أقضية وفتاوى اختلف فيها الحكم باختلاف اجتهادهما، فكيف يمكن الاقتداء بهما، والواقع يؤكِّد أنّهما مختلفان في أعيان القضايا لا متفقان؟ قال ابن حزم: “إن عمر وأبا بكر اختلفا، وإنّ اتباعهما فيما اختلفا فيه متعذر ممتنع لا يقدر عليه أحد.”
وبذا، يصير الحديث مع هذا الامتناع دالّاً بالتنبيه على خلاف ما أراده المحتجون به، وهو وجوب الاجتهاد في طلب الحقّ بعد تعذّر الاقتداء لعلّة الاختلاف في الأقضية، الثابت عن الخليفتيْنِ الراشديْنِ أبي بكر وعمر.
ثمّ إنّ بعض الأصوليين قد رأوا أنّ هذا الاقتداء يدخله احتمال، وإن كان فيه بُعْد، فحواه: أن يكون المراد به نوعًا مخصوصًا، وهو اتّباع ما رووه ونقلوه عن الشارع. قال أبو الحسين البصري: “وَقَوله: “اقتدوا باللذين..” لَيْسَ بِعُمُوم فِي وُجُوه الِاقْتِدَاء، فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِهِ الِاقْتِدَاء بهم فِي روايتهم؛ لِأَنَّه يُقَال لمن اتبع رِوَايَة غَيره إِنَّه قد اقْتدى بِهِ أي اقتدى بروايته، وَصدق حَدِيثه.”
وقد عَدَّ الجويني الحديث خاصًّا بباب الخلافة وأمر المسلمينَ السياسي دون غيره من قضايا الفقه والاختلاف والترجيح.
وأمّا الخبر الثاني فالجواب عنه يسير لا يفتقر إلى بحث طويل؛ فإنّه حديث باطل باتفاق النقّاد من أهل العلم بالحديث، قال ابن حزم فيه: “باطل مكذوب من توليد أهل الفسق،” بل جزم بأنّه من الموضوعات بلا شكّ ولا توقّف. وقال البزار: “هذا الكلام لم يصح عن النبي ،” ومردّ هذا الضعف عائد بالأساس إلى راوٍ مضعف في سنده؛ هو عبد الرحيم بن زيد العمي، وقد قيل فيه: “إنهم تركوه”، و”ليس بثقة”، و”ليس بشيء.”
وقد أجاد الشوكاني في بيان سقوط هذا الحديث وضعفه من مختلف الطرائق التي روي بها، فأوضح أنّه مطوّق بالضعفاء والمجاهيل والمتروكينَ من كلّ جهاته، قائلاً: “… وله طريق أخرى فيها حمزة النصيبي وهو ضعيف جدًّا. قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: لا يساوي فلسًا. وقال ابن عدي: عامة مروياته موضوعة، وروي أيضًا من طريق جميل بن زيد، وهو مجهول.”
ويُذكَر أنّ ضعف الرواة هو أحد سببـي الوهن والتهافت في الحديث. أمّا السبب الآخر فهو ما فيه من نكارة في المتن، وشذوذ في المعنى. قال ابن عبد البر: “… وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قِبل عبد الرحيم بن زيد؛ لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام أيضا منكر عن النبي .”
فما كان من هذا النوع لا يجوز التحديث به من دون بيان. فضلاً عن وضعه في محل المحاججة والاستدلال.
ثالثًا: الترجيح بين المذهبيْنِ
إنّ المتأمّل المحايد لأدلّة الفريقيْنِ، والناظر إلى المسألة من زاوية شمولية تراعي أبعادها الخطيرة، وتلحظ مآلاتها البعيدة؛ ليخلص إلى أنّ مذهب عدم جواز تقليد الميْت أولى القوليْنِ بالصواب، وأقربهما إلى سلوك جادة التوفيق والسداد، وذلك لمسوّغات كثيرة منها ما يأتي:
1. إنّ ترجيح مذهب المنع من تقليد الميْت، وتقديمه على مذهب الجواز، ليس اختيارًا أملاه التشهّي المحض، ولا دعا إليه الترجيح بالهوى، بل لأنّه مذهب يستند إلى فكرة موضوعية لا يُفترض فيها أن تستدعي خلافًا كبيرًا؛ وهي أنّ من طبيعة الاجتهاد البشري غير المعصوم أن يكون محتملاً للخطأ؛ إمّا بسبب الجهل الطارئ بالدليل أو بمفهومه، وإمّا بعارض الغفلة والنسيان اللذيْنِ لا معقب عليهما من جهة الوحي. فالمجتهد الحيّ يمكنه استئناف النظر في اجتهاده، وتفقُّد فتاويه مرّة بعد أخرى، وتفحُّص مكمن الخطأ والصواب فيها. فإذا تبيَّن له الخلل والخطل تراجع عنه، ونسخ ما كان منه من القول، منتقلاً عنه إلى الصواب الذي تَبيَّن له بعد خفاء، واتضح له من بعد غموض، ولا شيء من هذا ممكن في حقّ الميْت؛ فليس في استطاعته تكرير النظر، ولا تصويب الخطأ المحتمل. لذا، كان ترك تقليده ركوناً إلى موجب اليقين، وميلاً إلى أقرب الطريقيْنِ احتياطاً في الدين.
2. أكثر الذين جمدوا على رأي تقليد الميْت، فرّعوا المسألة على فكرة اقتنعوا بها، وإن كانت في نفسها غير مسلّمة؛ وهي إمكان خلوّ العصر من المجتهدينَ بإطلاق، وذلك بعد انقراض عصر الأئمة؛ إذ رأوا أنّه “لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل.” بل ذهب بعضهم إلى استحالة وجود مَن تَصْدُق عليه صفته في متأخري الأمة. قال في مواهب الجليل: “قول المؤلف: مجتهد إن وجد، قال البساطي: يقتضي أنه ممكن؛ فإن عنى به أنه مجتهد في مذهب مالك، فقد يدعى أنه ممكن، وإن أراد المجتهد في الأدلة فهذا غير ممكن، وقول بعض الناس: إن المازري وصل إلى رتبة الاجتهاد، كلام غير محقق.”
وقد صرّح بعضهم بذلك، فقال إنّ الداعي إلى تبني القول بتقليد الأموات هو فساد الزمان، أو ضعف عقول أهله وفسادها، وانتشار الانحراف والمنكرات بينهم.
وتمسّك بعض آخر بمقولة الإجماع غير المحقّقة، منطلقاً من أنّه كلّما تأخر الزمان كان عدم المجتهد أوضح وآكد، “… وإذا انعقد الإجماع على أنه لا مجتهد في القرن السابع، فكيف لا ينعقد بالأولى في القرن الرابع عشر؟ وقد قال العطار: وفي عصرنا، وهو القرن الثالث عشر، ضعف الطالب والمطلوب بتراكم عظائم الخطوب.”
وأضاف الذاهبون إلى الجواز تخوّفًا آخر لتسويغ ميلهم إلى تقليد الأقدمينَ، هو أنّه “لو سُدّ هذا الباب، لقُلِّدَ من لا يَستحِق أن يُقَلَّدَ، لا سيما وقد فسدت العقول وتبدلت، وكثرت البدع وانتشرت، فكان الرجوع إلى سلف المسلمين، وأئمة الدين هو الواجب على المقلدين.”
ولا شكّ في أنّ هذه مقولات بعضها أضعف من بعض، وفيها إطلاقات وتعميمات ليس عليها أثارة من علم أو برهان. فإثبات دعوى الإجماع دونه خرط القتاد، وما كان من عدل الله ورحمته الواسعة أن يضيِّق على آخر هذه الأمّة ما وسَّعه على أولها، فيرفع عن أبنائها شرف الاجتهاد، وينتزع منهم فضيلته، أو يحرِّم عليهم ما أذن فيه لسلفهم. كما أنّ الفساد ليس قاصرًا على زمن دون غيره، وقد استقر في أذهان الناس (عالمِهم وجاهلهم) أنّ الأفضلية مقرونة بالزمان، وأنّها أفضلية من جميع الوجوه، مع أنّه قد ثبت عن النبي أنّه قال: “مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ المَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ.”
وعقول الناس لم تحُل بها الغِيَر والتحوّلات، وإنّما هو الكسل الفكري يسوّغ لصاحبه الجمود، وعبادة الأسلاف تزيِّن لمَن ملأ عقله وقلبه بها الأخذ بأسهل الخياريْنِ وأقلّهما تكليفًا ومشقةً؛ فإنّ مكابدة الاجتهاد بكلّ ما ينطوي عليه من نظر وتفحّص وتمحيص، وما يشتمل عليه من المخاطرة والتعرّض لسهام النقد، لا يُقدِم عليه إلّا مَن ألقى عنه لباس الدعة والسكون، واستمد التوفيق من ربّ الأولينَ والآخرينَ.
3. إنّ القول بالتجويز مبني على فرض خطأ؛ وهو ما أوقع أصحابه في تناقض أصولي بيِّن، وذلك حين زعموا الإجماع من أهل عصرهم على هذا القول. ووجه التناقض يكمن في أنّ الإجماع،كما هو مقرّر في مظانّه، يشير إلى اتفاق المجتهدينَ في الأحكام الشرعية على أمر من الأمور، وهم أهل الحلّ والعقد. فكيف يكون الإجماع مع الزعم سلفًا بعدم وجود أهل الحل والعقد الفقهي؟ فإمّا أن يكون هناك مجتهدون فتسقط الدعوى من تلقائها، وإمّا أنّهم معدومون فلا إجماع؛ لأنّه باطل من اختلال شرطه. وقد أثار السُّبكي هذا التناقض على نفسه، لكنّه تركه بلا إجابة.
4. دعوى أنّ تقليد الميْت ضرورة تدعو إليها سياسة الشرع القاضية بعدم ترك الناس هملاً للأهواء تتخطّفهم من كلّ جانب، فيمكن مناقشتها بأن يقال:
إنّ هذا اعتراف صريح بأنّ تقليد الميْت هو من قبيل الضرورات، فوجب أن نلحِقه بأحكامها، ونخضِعه لقواعدها وضوابطها، وأول ذلك أن يُعَدّ العمل به من باب الرخص المقابلة للعزائم، والأصل في التكليفات الشرعية أن تكون من قبيل العزمات المتحتمات إلّا في أبواب الاضطرارات والمشقات ونحوها. ولا يجوز للأفراد المكلّفينَ -فضلاً عن جماعتهم وجمهورهم- السعي إلى الرُّخَص، أو القصد إلى استدامة موجباتها وأسبابها، بل يتعيّن عليهم الجدّ والاجتهاد في رفعها، انتقالاً منها إلى العزائم كما يُطلب من المتيمّم السعي إلى ابتغاء الماء قبل التطهّر بالصعيد، وإلّا عُدَّ مترخّصاً مفرطاً، وبالواجبات متلاعبًا، وللشرائع مضيّعًا.
وإذا تحرّر هذا علمنا أنّ من غير المقبول في موازين الشرع، أن تظل الأمّة قرونًا بل دهورًا مترخّصة بالتقليد، غير منتقلة عنه إلى عزيمة الاجتهاد، ولا مشتغلة أصلاً بتهيئة أسباب الانتقال في الحاضر أو المستقبل.
وعليه، فإنّ أقلّ ما يمكن أن يوصَف به هذا الوضع، هو أنّه تفريط معيب بالواجب، ووضع للأمور في غير أنصبتها الشرعية. فضلاً عن كونه مظهرًا جليًّا للجهل بمراتب الأعمال ومقاديرها.
5. إنّ تحرير محل النـزاع يُفضي إلى إبطال كثير من الحجج التي استند إليها أصحاب الجواز؛ ومن ذلك أنّ هؤلاء يخلطون على نحوٍ بين رواية الميْت واجتهاده، ولا يميزون بصورة واضحة بين نقله ورأيه، والحال أنّ الفارق بين الوضعيْنِ كبير، والتباعد بينهما جلي وصريح.
وتأسيسًا على ما سبق، فإنّ كلّ ما استدلوا به من أنّ القول بمنع تقليد المجتهد يشبه القول بردّ روايته بعد انتقاله إلى دار البقاء، فيه تسوية بين مختلفيْنِ؛ لأنّ الأخذ بالرواية من دون الاجتهاد ساغَ بسبب ورود أدلّة سمعية وعقلية خاصة تقوّي جانب الرواية، وتُبعِدها عن المحاذير والاحتمالات خلافًا للرأي والاجتهاد.
رابعًا: هل يعني المنع من تقليد الأموات التخلي عن تراثهم؟
أجد أنّ من أوجب ما ينبغي التنصيص عليه بعد ترجيح مذهب المنع، تبديد الإشكال الذي يُعبِّر عنه السؤال أعلاه، وأول ما يساعد على ذلك أن نعلم بأنّ هناك فارقًا كبيرًا بين مذهب المجتهد الفقهي، وتراثه العلمي. وبناءً عليه، يمكننا اتخاذ موقف مركَّب من المجتهد الميْت باستحضار هذا التفريق، وإذا صحّ لنا ذلك، جاز أن نقول: إنّ المنع من تقليد الميْت لا يعني الاستغناء عن تراث السابقينَ، ولا إسقاط كلّ فتاواهم وأقوالهم كما استنتج ذلك ابن القيّم حين قال: “ولو بطلت (مذاهبهم) بموتهم لبطل ما بأيدي الناس من الفقه عن أئمتهم، ولم يسغ لهم تقليدهم، والعمل بأقوالهم.”
وهذا تخوّف لا مبرِّر له؛ لأنّ مجتهد الوقت لا يمكنه النظر فيما بين يديه من النوازل إلّا بالرجوع إلى تراث الأئمة السابقينَ. فإذا لم يكن مضطرًا إلى الأخذ بالنتائج التي توصلوا إليها، فإنّه مضطر إلى الأخذ بمناهجهم في النظر، والاستفادة من طرائقهم في الاستدلال، واستعمال الوسائل التي اعتمدوها في استثمار الأحكام. كما أنّ له أن ينتقي من أقوالهم ما يقوّي دليله، ويطابِق صورة النازلة التي يبحثها، فيكون الحاصل اجتهاد مجتهد حيّ، مؤسَّسًا على اجتهاد مَن سبقه مِن المجتهدينَ الأموات.
وقد التفت أهل الأصول إلى هذه التخوّفات المعقولة المظنون وقوعها بسبب النهي عن تقليد المجتهد الميْت، وأثاروها في السؤال الآتي: ما الفائدة المتبقية من مؤلَّفات المجتهدينَ، المنقول تراثهم مع هذا المنع؟
ثمّ أجابوا عن هذه التخوّفات ببيان أنّ للتراث الفقهي فوائد أخرى غير التقليد والاتباع المجرّد، من مثل: استبانة طرائق الاجتهاد بالاطّلاع على تصرفاتهم في الحوادث والنوازل، وكيفية بناء بعضها على بعض. ومنها أيضًا معرفة المتفق عليه من المختلف، فلا يفتى بغير المتفق عليه.
والقول المحرّر في هذا الموضع هو أنّ آثار المجتهدينَ الأموات، وآراءهم الشرعية، وتراثهم الفقهي عمومًا، يمكن النظر إليه من جهتين؛ أولاهما: ما لا يجوز فيه التقليد، أو الاتباع، وهو ما يتعلّق بطرائق فهم النصّ وقواعد تنـزيله على خصوص المسائل؛ لأنّ النصّ الشرعي مفتوح للقراءة من سلف الأمة وخلفها، وربّ مبلَّغ أوعى من سامع، ويدخل في هذه الجهة أيضًا مختلف الآراء التي يتغيّر فيها القول لتغيّر الزمان والمكان والحال، وما كان من القضايا قابلاً للمراجعة والتعديل وتجديد النظر. وثانيتهما: ما لا يصح من عاقل تجاهله، فضلاً عن التنكّر له، بل يتعيّن الارتباط به اهتداءً واقتداءً، ويشمل ذلك الآثار العلمية للمجتهدينَ الأموات من الأقوال والمدوّنات، وما بلغنا عنهم من النقول والروايات، وكذا مناهجهم في الاستنباط والنظر والاجتهاد، وكذا معالم ملكاتهم الأصولية والاستنباطية والإفتائية… فهذا كلّه لا شكّ في أنّه معتمَد عليه من قبل اللاحقينَ، ومعتبَر من لدن المتأخرينَ، ولا تأثير لفارق الموت أو الحياة في هذا النوع من العلم الموروث.
إنّ العلوم كلّها دينية كانت أو دنيوية، لا يتم لها النضج والاستواء إلّا مع حصول التراكم المعرفي الذي هو بناء اللاحقينَ على أعمال السابقينَ، وإلّا كان العلم في كلّ حلقة من حلقات تاريخه بداية مستأنفة من نقطة الصفر، فلا يعقَل -تصوّرًا وتصديقًا- أن يكون الميل إلى جهة إيجاب استفتاء المجتهد الحيّ، تنكّرًا لمجمل التراث الفقهي، أو تجاوزًا لمنجزاته، بل هو استئناف لمسيرة البحث والنظر من حيث انتهى السابقونَ، انطلاقًا من المعطيات العلمية والمنهجية التي هي عماد ممارستهم الفقهية.
خامسًا: أثر الانتصار لمنع تقليد الميْت في إحياء وظيفة الاجتهاد
إنّ المنع مِن تقليد مَن سلف في النوازل المستجدة، فيه تشجيع على استمرار الاجتهاد في الأمّة إلى يوم القيامة بلا انقطاع، وهو أيضًا سبب لاتصال وجود أهله في كلّ طبقات المسلمينَ وأجيالهم؛ فإنّ اتكال الخلف على ما أنجزه السلف، واكتفاء اللاحق بتكرار ما قرَّره السابق، يولِّد عجزًا فكريًّا عامًّا يحفز إليه ما عُهد في الجبِلَّة البشرية من ميل إلى التقليد، وإيثار للجاهز والمعهود.
فلو سلّمنا بمقولة تقليد مَن مات لما كان هناك مِن داعٍ لإيجاد أئمة مجتهدينَ قائمينَ بوظيفة النظر المستأنف في القضايا، ما دام المطلوب هو استخراج أجوبة جاهزة من كلام الأقدمينَ؛ فإنّ هذا أمر يسير يستطيعه آحاد المتعلّمينَ. من أجل ذلك، كان بعض الأصوليين يدعو إلى تضمين برامج التعليم الشرعي كلّ ما يساعد على إعداد المجتهدينَ، وتحضير مواهب المتفقّهينَ العقلية للاضطلاع بمهمة النظر الاجتهادي. وقد بيَّن علاء الدين البخاري (730ﻫ) فوائد المحافظة على مجالس المناظرة في الدرس الأصولي، ونبَّه على ضرورة عدم الاستغناء عنها لما يتوهَّم من قلّة فائدتها؛ إذ إنّ فيها: “التمرين في الاجتهاد، واكتساب الملكة على استثمار الأحكام من الأدلة، وتشحيذ الخاطر، وتنبيه المستمعين على مدارك الأحكام لتحريك دواعيهم إلى طلب مرتبة الاجتهاد ونيل الثواب.”
ومن المسلَّم به لدى الجميع أنّ الناس -في كلّ زمان ومكان- تنـزل بهم نوازل، وتستجد فيهم أمور لم يكن لهم سابق عهد بها؛ لا من جهة شكلها، ولا من حيث طبيعتها، حتى إذا كان لها وجود وذِكر فيما مضى من الزمان، فإنّ تجدُّد حدوثها يقتضي المغايرة في ناحية من النواحي، ممّا يصيِّر إسقاط حكم اجتهادي منقول على واقعة أخرى ضربًا من التعسُّف؛ لأنّ الواجب في هذه الحال أن يتصدّى للحكم في النازلة مجتهد العصر العالِم بظروفها، والبصير بأوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين نظيرتها السالفة.
وقد تقرَّر عند الأصوليين أنّ المجتهد مدعوٌّ إلى تجديد النظر في النازلة التي أفتى فيها، مع تجدُّد السؤال عنها في غير زمن الإفتاء الأول؛ لأنّه “يحتمل أن يتغير اجتهاده باطّلاعه على ما لم يطّلع عليه أولاً، فيجب تكرير النظر،” ولا سيّما مع تغيّر أحد العناصر التي تركّبت منها. وفي حال وُجِدَ خلاف بينهم في الوجوب إذا تعادلت الصورتان من كلّ وجه، فإنّه لا خلاف بينهم في لزوم تجديد النظر مع حصول الاختلاف، قال النووي بعد إشارته إلى الوجهيْنِ في هذه المسألة: “قلت: أصحهما لزوم التجديد، وهذا إذا لم يكن ذاكراً لدليل الأُولى، ولم يتجدد ما قد يوجب رجوعه، فإن كان ذاكراً، لم يلزمه قطعاً، وإن تجدد ما يوجب الرجوع، لزمه قطعاً.”
وقال التاج السبكي معلِّقًا على ما ذكره ابن الحاجب من خلاف في المسألة: “واعلم أن الأصح في مذهبنا لزوم التجديد، والمسألة مفروضة فيما إذا لم يكن ذكر الدليل الأول، ولم يتجدد ما يوجب رجوعه، فإن كان ذاكراً لم يلزمه قطعا، وإن تجدد ما قد يوجب الرجوع لزمه قطعا.”
وإذا كان الأمر على هذا النحو، فلا امتراء أنّ تجدُّد ما يوجِب الرجوع راجح الحصول في النوازل بعد موت المجتهدينَ وانصرام أعصارهم أكثر منه في حياتهم، فيلزم منه تجديد النظر، ومراجعة الأدلّة، وكلّ ذلك غير ممكن مع الأخذ بفكرة جواز تقليد الميْت.
خاتمة
إنّ عدم اشتراط الحياة في المفتي والمجتهد، والقَبول بفكرة تقليد الميْت بإطلاقٍ، وفي مختلف القضايا، إنّما تسرَّب إلى الفكر الأصولي بعد الاعتراف بإغلاق باب الاجتهاد، وقصر التقليد والاتّباع على عدد محصور من المذاهب، وأسماء معيّنة من الفقهاء… ولئن كان هذا الوضع مفهومًا في فترات معيّنة من تاريخ الأمّة، من وجهة نظر السياسة الشرعية؛ حفاظًا على وحدة الكلمة، وحملاً للجمهور على ما فيه صلاحهم، وحجزًا لهم عمّا فيه فسادهم؛ إذ لو منعناهم من تقليد الماضينَ لتركناهم حيارى في أمور دينهم … فإنّه لم يعد مقبولاً اليوم مع ظهور، بل وتجدُّر مجموعة من المستجدات الواقعية التي تغايِر في النوع والصفة والخصائص ما عرفه الفقهاء المتقدّمون، فلم يعد بالإمكان تجاهلها، ولا تقديم إجابات عنها تنتمي إلى غير عصرها وظروفها.
وإلزام الأمّة بإيجاد المجتهد الحيّ المرجوع إليه في كلّ زمان إلى قيام الساعة، فيه ضمان لبقاء منصب الاجتهاد قائمًا بين فقهاء المسلمينَ، بما يستتبع ذلك من تنشيطٍ للعقل المسلِم، وحفزه إلى الإبداع والتجديد في التفقّه الشرعي أولاً، ثمّ في مختلف المجالات والعلوم تاليًا؛ فإنّ ارتباط المسلمينَ بالفقه؛ استفتاءً وإفتاءً، يجعلنا نعتقد أنّ من المتوقّع -على نحوٍ راجح- أن يكون إحياء الاجتهاد الشرعي، رائدًا لقيادة الأمّة نحو الخروج من حالة الجمود والركود الحضاري، إلى الحركة الإيجابية في جميع مناحي الحياة.
إنّ الدعوة إلى عدم تقليد المجتهد الميْت، ووقف الاعتماد على آرائه الفقهية الاجتهادية بعد موته؛ لا يُقصَد بها التنكّر للموروث الفقهي، ولا الاستغناء عن آراء الجهابذة من الفقهاء المتقدّمين ونبذها بالكلّية؛ لأنّ كثيرًا من أبواب المجتهَدات لا يظهر فيها الفرق بين المجتهد الميت والحيّ؛ نظرًا لعدم ارتباطها بتغيّر الزمان والمكان والبيئات، من مثل اجتهادات الفقهاء المتعلّقة بأمور العبادات، فهذه لا معنى لطلب استئناف الاجتهاد فيها.
ويبقى ما وراء ذلك من النوازل والمستجدات محتاجًا إلى مجتهد حيّ ينظر إليها، ويبدي فيها القول المستأنف المستجد بحسب الأحوال، مستنِدًا إلى نصوص الكتاب والسنّة، وملتفِتًا إلى المقاصد والغايات الشرعية، ومستأنِسًا بالرجوع إلى التراث الفقهي القديم، ومستضيئًا بآراء المجتهدينَ السابقينَ ومناهجهم. آنئذٍ، نستطيع بلوغ النهضة الفقهية المنشودة التي تُجدَّد فيها الأصول بالقدر الذي يمكِّن المجتهد من الأدوات والآليات المنهجية اللازمة لإنتاج القول الفقهي المستحدث، وتتوفر بها في الفروع الأجوبة الشرعية التي تُخرِج الأمّة من دوائر الضيق والحرج والانعزال عن مجرى التاريخ والحضارة، وتُبعِدها -أفرادًا وجماعات- عن الاستظلال بغير ظل الشريعة وأحكامها بدعوى فقدان البدائل والحلول.