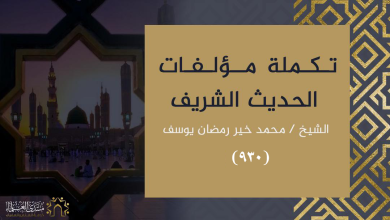حول كتاب القراءة الماركسية للتراث الإسلامي
قراءة باسم بشينية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أنهيت قراءة كتاب يوسف سمرين الذي طبع مؤخرا تحت عنوان ”القراءة الماركسية للتراث الإسلامي“.
الكتاب كان نقديًا، تعرض فيه المؤلف لنقد جملة من الماركسيين العرب، هم طيب تزيني، والعفيف الأخضر، وحسين مروة، وصادق جلال العظم، إضافة لماركسي تأسلَم لاحقا وهو روجيه جارودي الذي كان ماديًا. أيضا فقد تعرض الكاتب لنقد رمضان البوطي الذي كان يحاول احتواء تزيني وجارودي تحت مظلة الإسلام.
وسأحاول في هذه الأسطر تلخيص شيء مما جاء في النقد.
يوسف سمرين لم يبدأ مباشرة بالتعرض لأسطر تزيني ببيان الخطأ عند قراءته للإسلام، أعني المسلك الأسهل في ممارسة بيان الخطأ، وإنما حوى نقده في بداية التعرض له وللعفيف الأخضر ولجارودي بمقدمة هي عبارة عن عرض مدى امتلاك هؤلاء الماركسيين لأدوات فهم التراث أولا، ثم مدى اتساقهم مع الفلسفة التي كانوا يتبنونها، وهي المادية.
فبالنسبة لتزيني مثلًا، حينما كان يؤكد على انطلاقه من الرؤية المادية الجدلية، كان يقول بأن الموقف الطبيعي إنما هو أحد أسلحة الفكر المادي ضد الغيبية بكل أشكالها، ويغفل عند إعلانه العداء للغيبية بكل أشكالها عما يقوله خصوم المادية كما ينقل لينين عنهم أنهم يرون إثباتَ المادية للشيء في ذاته يعني قبول المادية ”بشيء ما غيبي قائم وراء حدود التجربة“. مع أن الغابة سميت غابة لأنها تغيّب ما فيها، فالغيب غير مشهود مع إمكان شهوده، لا أنه يعني امتناع شهوده بصورة مطلقة. حتى أن فريد وجدي كان يقول ”المادي والديني يستويان في الإيمان بالغيب“.
أما بالنسبة لمفاتيح قراءة التراث الإسلامي فإن تزيني كان شديد الضعف، حيث يعمم الأطروحات الكانطية في الإلهيات، على الطرح الإسلام، ففي حين كان كانط يرى أن الإله لا يمكن إقامة دليل عقلي على وجوده، يقول تزيني ”الإيمانية هي الاعتقاد الديني العاري عن دليل“. في حين أن الإيمانية في ديننا كما يقول ابن تيمية هي على النقيض من ذلك، ”فالإيمان بالشيء مشروط بقيام دليل يدل عليه“ (مجموع الفتاوى، ج٢٩، ص٤٩٣)
ومن هنا يظهر أن الإسلام في نظر الماركسية العربية كان مرادفًا بصورة مطلقة لمقالات كانط في اللاهوت، وبهذا المستوى في قراءة التراث الإسلامي، كان يتبجح تزيني بعناوين مثل (مشروع رؤية جديدة في الفكر العربي في العصر الوسيط) وبهذا المستوى يكتب عنه نبيل علي صالح مؤلفًا موسومًا بـ (طيب تزيني من التراث إلى النهضة)!.
ولا يتوقف الأمر هنا حول مدى امتلاك تزيني أدوات قراءة التراث، بل على سبيل المثال عند تعرضه للعقل في الإسلام، يقول ”برز داود بن المحبر من خلال كتاباته حول العقل وقد ارتكز على حديث قدسي حول العقل رواه ابن تيمية في بغيته“ يقصد تزيني بغية المرتاد، فالرجل لا يفرق بين ذكر حديث لغاية النقد، وبين روايته، فابن تيمية في بغية المرتاد ذكر الحديث لبيان بطلانه وأنه مكذوب، ولم يعتمد الرواية التي تتعلق بإقامة الإسناد. مع أن تزيني في تعلقه بالعقلانية لم يكن منطلقا من المادية التي يدعيها، فكل ما جاء في العقل لدى الإسلاميين كان في إطار تجريد العقل وإثبات أنه قائم بنفسه خارج الجسم. وفي تناقض صارخ مع أصول المادية كان تزيني ينتصر لمثالية من الإسلاميين، حتى أنه كان يرى أن ابن سينا كان ماديًا، في حين أن الماديين بحق في دراستهم لابن سينا كانوا يقولون: ”ابن سينا انحرف عن بعض المشاكل الأرسطية نحو الأفلاطونية الجديدة“ (الموسوعة الفلسفية، روزنتال ويودين، دار الطليعة، ص٤١)، والمعتزلة التي تثبت خلق الإنسان لفعله، فرقة [عقلانية] يرحب بمقالاتها تزيني الذي كان يدعي المادية! في حين أن المعتزلة كانت ترى أن أفعال العباد ناشئة من الإنسان نفسه بمعزل عن الأسباب الموضوعية المادية.
ولا يفترق العفيف الأخضر في الجهل المركب حول التراث الإسلامي عن تزيني، بل كان الأخضر يرى أيضا أن المعتزلة من ”منوعات الفكر المادي“ وأيضا الإسماعلية، بل جعل القرامطة الذين أصابهم هوس الأفلاك الروحانية من جملة المكافحين ضد الخرافة! وبهذا ترى أن كل فرقة باطنية أو فرقة جرى تبديعها هي حتما فرقة عقلانية “مادية“.
إن هذا الولع بابن سينا، والقرامطة، والإسماعلية، وحتى المعتزلة ”يظهر لك طريقة التعامل، لا إشكال في الفزع إلى أخس الصور المثالية في التراث للاعتراض على الإسلام، إنها تظهر الولع بالدين والتراث الديني في أقوام يصورونه على أنه خرافة لا أكثر، لكن تلك الخرافة بزعمهم، تؤرقهم إلى حد الفزع إلى خرافات باعترافهم في التراث وإحيائها، ثم تصويرها كأنها أدب نقدي معاصر اتجاه النصوص الشرعية، في وقت كانوا الأحوج فيه إلى سد النقص في اطلاعهم الشرعي“ –يوسف سمرين، ص٧٩.
فهذا مدى امتلاك الماركسيين العرب لأول درجة تؤهل لقراءة التراث، فكيف بنقدهم للإسلام؟
كان تزيني في رحلة طعنه بالإسلام الأصيل، يحذر دوما من النزعة الاقتصادية الاختزالية، أي اختزال الواقع كله في الاقتصاد، وهي عين مقولة أنجلز، لكن تزيني يظهر سريعا أن حافظ بلا فهم، فتراه يقول أن الإسلام عبارة عن خطة اقتصادية، كسب الجماهير الفقيرة بكفاح الذين يكنزون الذهب والفضة، مع أن الإسلام في الحقيقة جاء للكفر بالآلهة المتعددة، فهل كان يجري في الإسلام تجاهل الجحود العقدي مقابل المدخول النقدي؟ ففي حين كان تزيني يدعي عدم اختزال الواقع في العامل الاقتصادي، عند حديثه عن الإسلام الذي يعاديه: يختزل كل ما فيه في ذلك العامل، ومع ذلك يخالف أقوال أنجلز الرجل الثاني في الماركسية، حيث يقول: ”إن العوامل الاقتصادية، تؤلف قوة تاريخية حاسمة بالنسبة للعالم الحديث على الأقل، وأن هذه العوامل الاقتصادية تشكل الأساس الذي تقوم عليه التناحرات الطبقية الراهنة“ (أنجلز، ستبانوفا، دار التقدم، موسكو، ص٤٦) فأين الانطلاقة الماركسية في اتهامات تزيني؟
أما بالنسبة لصادق جلال العظم، الذي كان يعرض عدم سجود إبليس لآدم على أنه يجب أن يقرأ قراءة معاصرة، وبالتالي فلماذا لا نقول أن إبليس كان موحدًا بعدم سجوده لغير الله؟ يظهر جهله المطبق بقصة إبليس، حيث أن إبليس نفسه في النصوص لم يجعل التوحيد علة في عدم سجوده، وإنما جعل ”أفضليته المزعومة“ هي العلة. جاء في التنزيل ﴿قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين﴾.
أما العفيف الأخضر الذي كان يحكي أن خالد ابن الوليد قتل ابن نويرة لأجل الزواج بامرأته الفاتنة، ومع إثبات يوسف لكذب الأخضر، إلا أن نقده كان مفحمًا، فالعفيف الذي كان يتبنى البيئة السوفييتية، وقد كان مترجِمًا للبيان الشيوعي، يغفل كل الغفلة عن حصيلة الجيش الأحمر السوفييتي في الحرب العالمية الثانية فمن الزاوية الشمالية فحسب: ١١١ قضية اغتصاب، و١٢٠٤ قضية سلب، حتى أم مارتا هيرلس كانت تستنجد أفراد الجيش لا في عدم اغتصابها! وإنما تقول ”واحد فقط، أرجوك واحد فقط!“.
يقول يوسف: ”لقد كانوا يقرأون التراث الإسلامي بصورة مثالية ويطالبون الإسلام بهذا ويتركون التدقيق لصالح زج ما في رؤوسهم في التاريخ، ليظهر كأن الإسلام مدانٌ وفق أخلاق مثالية، وهذا ما كان حاضرًا في تصور تزيني للإسلام، وبالتالي تعامل معه في كل مرحلة من مراحل تقلباته الفكرية بموقف محدد أن الإسلام في حيز المثالية، ويمكن التعامل معه فقط على هذا الأساس“
أما البوطي الذي كان يحاول احتواء جارودي تحت مسمى الإسلام الصحيح، كان يعرض بابن باز الذي قال في جارودي ”لم يعتنق الإسلام الذي عليه المسلمون“، وفي حين يقول البوطي عن جارودي ”رأيته وهو في أبرز مظاهر تبتله وعبوديته“ يقول جارودي ”لا يوجد في القرآن تحديد للصلوات، الصلاة تعني التفكير لأشياء عامة وليس التفكير بأشياء خاصة، ثمة صلاة واحدة في العالم حتى ولو اختلفت من شعب لآخر“ (هذه وصيتي للقرن ٢١، جارودي، ص٤١) مع أن جارودي كان من أجهل الناس بمفاتيح قراءة التراث فهو لا يصل لمستوى عوام المسلمين في العلم الشرعي، فضلا عن مستوى طالب علم، تراه يقول في سؤال استنكاري ”استخدم أحمد بن حنبل أحاديث كثيرة، من أين جاء بها؟!“ (هذه وصيتي للقرن ٢١، ص٤١) فأين احوائيات البوطي من هذا؟
————————
كان هذا أشبه ما يكون بالمراجعة، أو التلخيص لبعض ما استوقفني، على أن الكتاب حوى موضوعات أخرى مهمة سواء في النقد للخطأ، أو التحرير لبعض الأطروحات الصحيحة، بالنسبة لمراجع الأقوال فكلها في الكتاب لمن شاء العودة لها.
الكتاب نافع جدًا في الدفاع عن الإسلام، وعن عقيدة أهل الحديث، وفي تطوير الملكة النقدية، وأعجبني في الكاتب أنه مجانب لما درج عليه كثير من الأكاديميين تحت مسمى الموضوعية البحثية، فمع إفحام نقده العلمي لخصومه، إلا أنه لم يعرض نفسه كمجرد ناقد معرفي، بل أبدى في كثير من سطوره عاطفته العقدية ضد محاربي الشريعة، فترى وسم الأخضر باليساري الصبياني، ووسم تزيني بالعَبثي والخطابي، وهكذا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
(المصدر: موقع مداد)