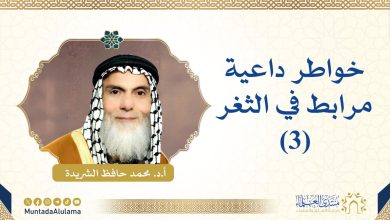بقلم أ. محمد إلهامي
نشر المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية مقالاً لي بعنوان “مسألة الشرعية لدى حركة المقاومة“، ثم نشر المعهد تعقيباً على المقال للأستاذ ياسر فتحي، وتطلب هذا التعقيب التعليق على عدد من الملاحظات التي وردت فيه.
مختصر فكرة المقال أن حركة المقاومة لا بد لها من شرعية، فمعنى “الشرعية” هو ما يجعلها حركة مقاومة لا حركة خروج على النظام والقانون، ولذلك سعى كل نظام لبناء شرعيته التي تجعل مقاوميه خارجين عليها ومنحرفين ومنبوذين، كما سعت كل حركة مقاومة لبناء شرعيتها التي تجعلها حركة نضال وكفاح ضد نظام يفتقد إلى الشرعية ولا يتمتع بها. فإذا أنزلنا هذا الحال على أمتنا الإسلامية فسنرى بوضوح أن الإسلام، الذي هو روح الأمة وهويتها وانتماؤها، يجعل مسألة شرعية النظام متوقفة على إقامته للدين وإنفاذه للشريعة.
وهو الأمر الذي سار في التاريخ الإسلامي وفي تراث الفقه كله، فالشرعية الوحيدة للحاكم المتغلب الذي قبلت به الأمة اضطرارا هو أنه يقيم الدين والشريعة ويحفظ بيضة الأمة. وبناء على هذا كله فإن كل نظام لا يأخذ شرعيته من الدين ولا يسعى لإقامة الشريعة فهو نظام فاقد للشرعية. وهذه الفكرة هي أهم ما ينبغي على أي ثورة وأي حركة مقاومة في بلادنا أن تغرسه وتنشره في الناس، فتلك هي أقوى ضربة تسدد لشرعية النظم القائمة وهي أقوى معين يأتي للثورة وحركة المقاومة بالأمداد والأفواج لأنه يخاطب الناس بلسان الدين الذي هو المؤثر فيهم والملهب لشعورهم والمفجر لطاقاتهم.
وافقني صاحب التعقيب على ضرورة الشرعية لحركة المقاومة، لكنه توقف ليقول: إن التغيرات الهائلة التي حدثت بين عصرنا وعصور تطبيق الشريعة تمنع الآن من وجود تصور واضح للشريعة، حيث لا يوجد الآن “بشكل واضح ومحدد نظام معاصر للشريعة”، وتختلف الاجتهادات والرؤى المعاصرة اختلافا واسعا في محاولاتها استنباط الاجتهاد الأمثل لزماننا وأوضاعنا.
وحيث كان الحال هكذا فإن رفع شعار الشريعة لن نجني منه سوى العاطفة، وهي العاطفة التي ستأتينا معها بالصراعات والسجالات التي ستندلع حول تفسيره والتي قد تؤدي إلى اقتتال الصف الواحد. ولتجنب هذا علينا أن نضع شعار الشريعة جانبا ريثما يتوصل المجتهدون إلى صياغة عليها اتفاق، وهذا لن يعطل حركتنا الثورية فإن كل نظام مستبد هو فاقد للشرعية، وكل اغتصاب لإرادة الأمة هو مبرر كاف للثورة على النظام وخلعه.
سأجمل تعقيبي على تعقيب الأستاذ ياسر فتحي في النقاط التالية:
1. إن انتظار وصول المفكرين والمجتهدين إلى اتفاق حول النظام المعاصر للشريعة هو انتظار ما لا يأتي أبدا. ذلك أن عالَم التفكير والتنظير لم ينته في أي يوم لرأي حاسم واضح متفق عليه في أي قضية. المفكرون يقضون الوقت في التحليل والتفسير والاقتراحات والسجالات، ثم يأتي الحركيون العمليون فيغيرون الواقع طبقا لما حملوه هم من أفكار واضحة آمنوا بها واعتنقوها بحماسة، فينتقل عالم التنظير والتفكير إلى تحليل وتفسير الواقع الجديد وتقديم الاقتراحات حوله.
إنه بقدر ما نشأت كل حركة مقاومة وتغيير عن فكرة، بقدر ما ابتعدت نفس هذه الحركة عن السجال المكثف حول الفكرة وتفاصيلها وآفاقها وأعماقها وآثارها.. العمليون يتحركون بناء على فكرة واضحة وبسيطة دون أن ينتظروا من تيار الفلاسفة والعلماء حسم تفاصيلها، أولئك هم من يغيرون الواقع على الأرض، وبقدر ما ينجحون في تغييره وتأسيس دولتهم بقدر ما تكتسب فكرتهم مزيدا من القوة والعمق بما ينشأ حولها من تراث فكري تخدمه جيوش من المفكرين والفلاسفة، أولئك المفكرون والفلاسفة هم أصلا نتيجة انتصار هذه الفكرة على أرض الواقع.
نعم، إن خالد بن الوليد نفسه لا يستطيع التعبير عن الإسلام بتقعيد وتنظير وتقسيم الشافعي أو الغزالي أو الشاطبي.. لكن وضوح الفكرة البسيطة في نفسه وإيمانه بها أشد وأعمق وأقوى من كل هؤلاء، ولولا هو لما وصل الإسلام إلى هؤلاء، وأغلب الظن أن عقولهم الذكية هذه كانت ستنتج فلسفات ميتة إن لم تنتج فلسفات تؤصل لكسرى وقيصر ضمن الحضارات التي ستكون سائدة عليهم! ففضل خالد بن الوليد علينا وعليهم هو الفضل الأعظم.
المقصود ببساطة: أن حركة المقاومة بما تغيره على الأرض هي من تنشيء الأوضاع التي تقدح أذهان المفكرين في تأصيلها وإنضاجها لا العكس.. والعمليون لا يحتاجون إلا إيمانا عميقا قويا بفكرة بسيطة واضحة طالما هم في سياق المقاومة وفي لحظة التأسيس. وهكذا فإن رفع الشريعة يؤدي المطلوب في لحظة المقاومة والتأسيس.
2. إن الذي يصنع الخلاف والتنازع والاقتتال هو محاولات التفصيل والتفسير للشعار، محاولة الوصول إلى الفصل فيما لم يأت زمنه ولا وقته بعد.. الذي يصنع الخلاف هو محاولات المفكرين والفلاسفة والباحثين ترك واجب اللحظة الذي يخدمه الشعار والإصرار على استطلاع ما بعد المرحلة وما وراء الكلام.
إن الاتفاق يعم الإسلاميين ما داموا يجيبون على سؤال: كيف نسقط الطاغية، ثم يأتي الاختلاف كله حين يُطرح سؤال: ماذا سنفعل في الخمور والسياحة العارية وحجاب النساء ونحوه، ثم يقع التنازع حين تطرح هذه الأسئلة والطاغية لم يسقط بعد.
وبتوسيع الصورة: يعم الاتفاق سائر أطياف الشعب ما داموا يفكرون في نجاح الثورة، ثم يزرع المتنفذون الكراهية والبغضاء بينهم حين يطرحون عليهم وبإلحاح: ماذا يكون الوضع حين ينجح الإسلاميون فيفعلون كذا وكذا، أو: ماذا يكون الوضع أيها الإسلامي إذا لم يختر الناس الشريعة أو إذا تظاهر ضدك العلمانيون؟ طرح هذه الأسئلة في وقت الثورة والنظام لا يزال قائما هو ما يفجرها ويزرع بينها بذور الاقتتال.
فالواقع هو عكس ما تتصور، إن دخول الفلاسفة والمفكرين على خط أسئلة ما بعد المرحلة هو ما يشتت حركة المقاومة ويفجر الثورة، لأنه يضرب فكرتها البسيطة الواضحة المستقرة في الأذهان والتي تتحمس لها المشاعر وتبذل في سبيلها التضحيات ويحولها إلى مجموعة من الأسئلة المعقدة.. وهكذا كانت تجربة ثورتنا في 25 يناير.
الخلاصة: أنه بقدر ما ترك المفكرون والكُتَّاب والباحثون إزعاج حركة المقاومة بأسئلة لم تطرح بعد ولم يأت وقتها، بقدر ما استطاعت حركة المقاومة والثورة أن تحتفظ بتماسكها وتتجنب تمزقها وتشتتها.
3. نعم، لا يوجد نظام معاصر للشريعة.. والاجتهاد في سبيله هو واجب المسلمين كما ذكرت، لكن الاجتهاد لا يكون أبدا عملا فكريا فحسب يتخصص له المفكرون والمجتهدون، بل هو عمل واقعي، وإجابات على أسئلة ينتجها الواقع والتحديات العملية. الواقع أنه لا قيمة للمفكرين بل ولا ضرورة لهم ما داموا لا يستطيعون تقديم إجابات عملية يسكبون فيها رحيق وخلاصة علومهم النظرية.
وبالتالي فعدم وجود نظام معاصر للشريعة هو تحدٍّ يستدعي العمل على إيجاده، العمل الواقعي الحركي، ولا يكون عدم وجوده مبررا لترك البحث عنه بحثا عمليا واقعيا. وأول واجب واقعي في هذا هو مقاومة هذه النظم القائمة التي تعمل على حرب الشريعة نفسها وقتل وطرد كوادرها.
4. الشريعة كشعار يوفر لحركة المقاومة العديد من المزايا، إن قدرتها العاطفية التعبوية الهائلة التي لا يستطيع شعار آخر أن يكافئها فيه ليست الميزة الوحيدة. بل الشريعة نظام يجعل التصور البديل في مرحلة ما بعد انتصار الثورة يتمتع بالحد الأدنى من الوضوح.
صحيحٌ قد وقعت متغيرات هائلة بين أزمنة تطبيق الشريعة وزماننا لكن كثيرا من الثوابت باقية كما هي في عالم النفس والاجتماع والعلاقات الدولية.. وبالتالي فأكثر ما بني من فقه وتراث وأفكار في هذه المجالات سيظل قائما وفاعلا ومفيدا ومطلوبا! كما أننا نستطيع أن نجد ثوابت في الفكر الغربي ومسيرته الحضارية تمتد إلى سقراط وأفلاطون وأرسطو، وهذا في كل حضارة.. فالإنسان لم ينفصل عن ماضيه انفصالا تاما، وتجربتنا الحضارية امتدت إلى ما قبل مائة سنة، ولديها تراث ضخم ضخم من الاجتهادات القريبة فضلا عن اجتهادات عصر ما بعد سقوط الخلافة حتى الآن. المهم أن أمورا كثيرة تظل واضحة في تصورنا لما نريد أن يكون عليه المستقبل. ولو افتقدنا مرجعية الشريعة لكان الخلاف بين الثائرين أوسع بكثير وأضخم بكثير وأعقد بكثير، تماما كما هو الفارق بين اختلاف مذاهب الفلسفة وبين اختلاف مذاهب الفقه الإسلامي، الفارق بين اختلاف في الأصول والمنطلقات والاختلاف داخل الأصول والمنطلقات المتفق عليها.
يكفي لحركة المقاومة أن تعمل تحت ظل المتفق عليه، الأصول والثوابت، وعلى جمهرة المفكرين والمثقفين أن يعملوا على ترسيخ تلك الثوابت والأصول دائما، ثم عليهم أن يحتفظوا بالخلافات الفروعية والاجتهادية لتظل في إطار بيئتهم العلمية وفي ظل العمل المشترك المستند إلى الثوابت.
5. توفر مرجعية الشريعة كذلك وضوحا قويا لمعنى الشرعية نفسه.. فبغير مرجعية الشريعة سنختلف اختلافا واسعا حول شرعية النظام نفسه وشرعية حركة المقاومة، مرجعية الشريعة تحدد لنا معنى الشرعية، واستبعادها يدخلنا في متاهات فكرية وفلسفية حول معنى الشرعية وتفسيرها وشروط من يحوزها. إن استبعاد الشريعة كمرجعية وشعار يجعلنا ندخل مباشرة تحت مرجعية ينتجها الواقع (فالسلطة تنتج المعرفة) أو ينتجها مذهب فكري وضعي آخر وهو في حالتنا: المرجعية الغربية باعتبارها الثقافة الغالبة.
إن استبعاد مرجعية الشريعة سيدخلنا في خلاف واسع حول المرجعية البديلة، فلا شيء في الحياة بلا مرجعية، ولا يكفي في هذه الحال أن يقال طالما وجد ظلم فشرعية الثورة قائمة، لأن الظلم نفسه معنى يختلف فيه الناس، ويختلفون فيما يُتحمَّل منه أو لا يُتَحمَّل، وفي القدر الذي تكون الثورة معه مبررة أو لا تكون.. كل المعاني التي تبدو متفقا عليها كالعدل والمساواة والأخلاق ونحوه هي ليست كذلك عند النزول إلى التجربة العملية، لأن المرجعية التي تفسرها تعمل على بيان حدودها وضوابطها ومراتبها.
(وهنا أرجو بشدة قراءة هذا المقال لنكتشف أن الفكر الغربي الذي يعرف بأنه ليبرالي حرياتي ديمقراطي حقوقي، هو أشد في مذهبه العملي من مقولة “تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك”، فهذه المقولة التي هي موضع خلاف ضخم في الفكر الإسلامي هي في حكم الثابت في الفكر الغربي الحديث.. ذلك لنعلم أن الشعارات المرفوعة حين تنزل على أرض الواقع تفقد سموها المفارق للمرجعية وتكتسب من المرجعية خصائصها الواقعية).
كذلك فإن استبعاد مرجعية الشريعة سيدخلنا في اشتباك فكري وقيمي وأخلاقي مع أمتنا المسلمة وشبابنا المسلم. تلك الأمة وهؤلاء الشباب الذين هم مدد حركة المقامة ومادتها وعدتها، والواقع يثبت يوميا أن رفع شعار الشريعة هو ما يجذبهم ويلهبهم حتى لو أن الذين رفعوها كانوا عبثيين وعدميين وبلا عقل (كما هي حالة داعش).
ثم إن الذين نحاول إرضاءهم –أو جذبهم- باستبعاد مرجعية الشريعة هم القلة في بلادنا، حتى لو تضخموا بالحضور التليفزيوني والإعلامي، لكنهم على أرض الواقع بلا تأثير حقيقي. والواقع أيضا أن هؤلاء عند اللحظات الفاصلة ينحازون إلى عداء الأمة وثورتها ويفضلون جحيم العسكر والاستبداد على جنة الإسلاميين.. والأمثلة طويلة ومتعددة بحجم قرنين من الحقبة العلمانية في بلادنا.
خلاصة ما أود قوله إن الشريعة هي الشعار المنسجم مع أمتنا، الملهب لطاقات شبابنا، الذي يوفر لنا مرجعية فكرية متينة ذات ثوابت وأصول متفق عليها تعصمنا من التيه بين الأفكار والمذاهب، وتعصمنا من سطوة الثقافة الغالبة والسلطة القاهرة التي تنتج الأفكار لتصنع شرعيتها، ولا داعي للخوف من أن بعض الأمور تحتاج اجتهادا معاصرا فهذه الأمور ما دامت تناقش في بيئتها العلمية، تلك البيئة التي عليها واجب الاجتهاد المعاصر بإجابة الأسئلة التي تتطلبها المرحلة أولا قبل الجدال حول إجابات الأسئلة المستقبلية، وعليها واجب هداية وإنضاج الثورة وحركات المقاومة بالمتفق عليه والثوابت لا تفتيتها وتمزيقها بطرح الخلافات والسجالات حول المختلف فيه.